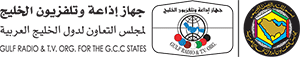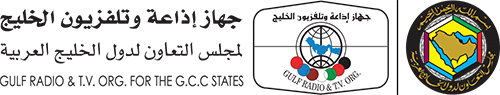اعتقدت البشرية خطأً – ولقرون طويلة- أن القوة العسكرية هي الأداة الوحيدة لبسط النفوذ، وأنها اللغة الأبلغ في السيطرة على العالم وموارده، وأن الإكراه هو السبيل الأسرع في التحكم في أموره، وظن من سعى للحصول على هذا النوع من القوة أنه بات الأقدر في الهيمنة على الدول والشعوب، وأدى ذلك إلى اشتعال نيران الحرق والدمار، ودخل العالم عبر العديد من الحروب الاستعمارية والتوسعية في دوامة من الصراعات المتتالية التي كلفت دوله أثماناً باهضةً في الأرواح والممتلكات، وكانت محصلة معظم تلك الحروب تراجع مروع في قيم السلام والتسامح والنهوض، وتصاعد مهول في حالات الاضطراب الذي وصل أوجه باندلاع حربين عالميتين، قُتل فيها الملايين، ودمرت بسببها، في فترة قصيرة، بُنىً تحتية ضخمة كانت ثمرة سنوات طويلة، وجهود مضنية سعت لتهيئة الحياة الكريمة، والعيش الرغد لبني الإنسان.
ما أن انتهت الحرب العظمى الثانية، حتى أدرك العالم، عبر بوابة الدول الخاسرة وتحديداً ألمانيا واليابان وإيطاليا -وهذه من المفارقات- أن طريق المعارك الحربية ليس سوى مسار زائف لبلوغ المجد، وتبيّن بما لا يدع للشك أن التنمية بأذرعتها المتنوعة هي الأقدر على إيصال الدول إلى القمم، وظهر في مقدمتها الاهتمام بالقوة الاقتصادية، وتنميتها، وهو ما أكدته النجاحات متلاحقة للدول المهزومة عسكرياً في الحرب العالمية رغم انكسار شوكتها في منتصف القرن الماضي، حيث فطنت إلى أن هذا النوع الجديد من القوة هو السبيل الأسرع للوصول إلى تطلعات وآمال فاقت بكثير طموحتها التي قادتها للانخراط في حروب مدمرة كلفتها الكثير وأساءت لسمعتها.
غير أن من المفارقات كذلك أن العالم، الذي اكتشف أن الدبابات والصواريخ ليست الأداة الأقوى لبسط النفوذ، تبين له كذلك أن القوة الاقتصادية لوحدها ليست كافية لتحقيق ذلك الهدف؛ إذ تبين له أن هذه القوة رغم أهميتها، لابد لها من مجموعة من أدوات ناعمة (ثقافية، إعلامية، وتسويقية)، تُوَظَّف في تعريف الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي بمنتجات الدول وثقافاتها ومقوماتها، وذلك وفق مواصفات دقيقة تضمن لها الجاذبية التي تقنع الشعوب بالإقبال عليها دون إكراه أو خداع أو تضليل، لتشكل بشكل غير مباشر قوة خفية تضمن الاقبال عليها، وتبنيها أو اقتنائها؛ وفقاً لأساليب سيكولوجية تتواءم مع رغبات النفس واحتياجاتها، ليتم بذلك تحقيق الأثر المطلوب، خاصة حين يتم مزجها برسائل إيحائية تتضمن الاهتمام بمصالح الأمم جمعاء، وتضمن لها الاحترام الذي تنشده، وهي النهج الذي وجد فيه العالم بعد تجارب عديدة أنه اللغة الحضارية التي يفهمها الناس ويجمعون عليها، وقد أكد ذلك أثارها الإيجابية في مواقف عديدة من خلال أدواتٍ فعالة تتسلل بهدوء إلى عقول البشر، فيما عرف بعد ذلك بمصطلح: القوة الناعمة.
جاء اكتشاف حقيقة القوة ناعمة تأكيداً لعدالة سماوية عميقة منحت الدول على اختلاف مقوماتها، دون استثناء، نعمة عظيمة لا تميز أي منها وفقاً لخصائص منفردة، سواء من حيث مساحاتها أو مواقعها الجغرافية، أو من حيث أعراقها أو دياناتها، ليكون التخطيط والإدارة وحسن استثمار الموارد واختيار الأدوات الأكثر فعالية في هذا النوع من القوة هو المحك لمعالجة الصور النمطية الخاطئة وبناء وتعزيز الصور الذهنية الإيجابية.
كأس العالم نموذجاً:
من هذا المنطلق وجدت دولة قطر في القوة الناعمة ضالتها في مشروع قادم يكون حديث العالم، وهو ما تطلب دراسة الفكرة من كافة جوانبها لمواجهة التحديات، ولتكون أكثر إقناعاً لمتخذي القرار للموافقة على الطلب في ظل منافسة شرسة من قبل دول تظن أنها الأحق به، وبعد اكتمال الملف بصورة لا تقبل الرفض هذه القوة تقدمت بطلب تنظيم أعظم فعالية جماهيرية على وجه الأرض، المتمثلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمشروع كان قد درس بعناية كبيرة، متضمنًا عروضاً مذهلة للقائمين على تقييم الطلبات فاق بمراحل عديدة جميع العروض، الأمر الذي جعل الاتحاد نفسه لا يتردد في قبول العرض، والاقتناع بأحقية قطر بالفوز بالترشح.
سيل من التحديات:
بالرغم من قوة الطلب القطري وتفوقه، إلا أنه قوبل، خاصة من بعض الدول الأوربية، بالرفض، ووضع المعوقات التي ركزت في بداياتها على العقبات اللوجستية، وتحديداً ظروف المناخ والبنى التحتية، وعراقة أنديتها ومنتخباتها في عالم المستديرة.
لم يكن الهدف القطري من طلب التنظيم البطولة العالمية في نسختها الثانية والعشرين مشابهاً لجميع أهداف الدول التي سبقتها؛ التي اعتادت على أن يكون هدفها شبه محصور في الحصول على مكاسب اقتصادية وأخرى معنوية، في مقدمتها تهيئة منتخباتها لنيل الكأس الذهبية، إذ تبين كما اتضح لاحقاً أن كلا الهدفين لم يكونا في أولوياتها، وإنما هناك أهدافاً خليجية وعربية وإسلامية أغلى من الذهب تريد الدولة المنظمة الجديدة إيصاله للمجتمع الدولي، وهو ما اتضح جلياً للمراقب ولمن حضر فعاليات البطولة، لقد أرادت أن تصحح مفاهيم مغلوطة عن المنطقة، بأسلوب فريد يختصر المسافات.
وبالفعل أسهمت قوة البطولة النافذة، التي تتمتع بخصائص فريدة أبرزها كونها تحظى بمتابعة أرقام مليارية من البشر، وتستقطب قرابة مليون ونصف زائر من شتى أصقاع المعمورة، في إيصال تلك الرسائل بعد أن هيأت لكل ذلك الأدوات والأساليب المناسبة فاجأت بها العالم، وأصبحت من خلالها على كل لسان، أما أبرز القوى التي ضمنتها البطولة، وشكلت أبرز عناصر الاستثمار للدولة المضيفة، فتتلخص في الأبعاد التالية:
المونديال قوة ثقافية:
كانت معظم حفلات افتتاح بطولات كأس العالم السابقة؛ بل وحتى الألعاب الأولمبية، تركز على إبراز المظاهر المادية المبهرة، غالبها استعراضات فنية تعكس تراث البلد المضيف ومقوماته، في حين حرص منظمو حفل البطولة الأخيرة على التركيز في إبراز البعد الثقافي المحلي والخليجي والعربي والإسلامي، مع مزجه بطريقة إبداعية مهنية بالقواسم الإنسانية المشتركة.
ظهر ذلك جلياً في افتتاح المونديال لأول مرة في تاريخه بآيات منتقاة من القرآن الكريم، ذات معاني بليغة تؤكد على تنوع الأعراق والشعوب، وتحث على التعارف بينهم على نحوٍ يتضمن قبول الاختلاف ويدعو للتسامح في إطار المحبة والسلام، وتفادياً لأيَّة تفسيرات مغلوطة للمتربصين، عمدت قطر في اختيار من يقوم قراءتها على مسامعهم شخص تناقض ملامحه وصوته وشخصيته تماماً أصحاب تلك الشخصيات المخيفة التي تصورها مضامين الكثير من وسائل الإعلام الغربية، وأفلامها السينمائية عن العرب والمسلمين؛ ممن يحملون لقب سفير النوايا الحسنة، وهو المواطن القطري غانم المفتاح، الذي كان له من اسمه نصيب، ساعده في ملامسة شغاف الحضور والمتابعين تقاسيم وجهه البشوش، وتكوينه الجسماني بسبب الإعاقة التي لازمته منذ مولده، كما تمكن من إيصال رسالة أخرى من قصص التحدي والنجاح لأقرانه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتجسيداً لمضمون الآية الكريمة التي تحث على التعارف بين الشعوب وتواصلهم، دعا المنظمون من أقصى الطرف الغربي من كوكبنا الممثل العالمي “مورغان فريمان” ليتشارك مع المفتاح في تقديم الحفل، فكان المشهد بحق علامة فارقة لبرهنة عالمية الحدث، وعدم الاستئثار بفقراته لمن ظفر بالتنظيم.
لم تكن هذه الفقرة سوى المفتاح للتعريف بثقافة ظُلمت صورتها كثيراً من قبل الكائدين، ولم يكن حفل الافتتاح هو الساحة الوحيدة، للتعريف بالثقافة الخليجية والعربية والإسلامية؛ بل شملت قنواتها ميادين العاصمة الدوحة وشوارعها، وسائر مرافقها، وهيأت السبل لحث كل من حضر فعاليات الحدث، في التفاعل مع تلك الأدوات بما يجعلهم جزءً منها، حيث حفز على ذلك التنوع الكبير في الأنشطة وأماكن الترفيه والتراث التي لا تخلو في كثير منها من مظاهر الهوية الخليجية الأصيلة، وبات بعضها مقصداً تلقائياً بعد انتهاء المباريات؛ خاصة وأن العديد منها قد جهز لاستقبال الحشود التي قد تفضل مشاهدة بعضها عبر شاشات التلفزيون الضخمة التي هيأها المنظمون في مواقع مختلفة من العاصمة القطرية.
ولئن شكل حفل الافتتاح أحد الأوراق القيمة التي كسبت بها قطر قلوب العالم، فقد نجحت على نحو تشكر عليه في التصدي لواحدة من أخطر الظواهر الشاذة التي تتنافى مع الفطرة السوية، واستطاعت أن توجه ضربة موجعة لمن حاول استغلال البطولة للترويج لسلوكيات ترفضها المبادئ والقيم لدى السواد الأعظم من البشر، كما أنها لم تتردد في رفض أي تجاوزات لقوانين البلد المضيف.

المونديال قوة إعلامية:
ولأن كأس العالم حدث فريد ينتظره العالم أجمع، ويحظى باهتمام كبير حتى من قادته، فقد منحه هذا الاهتمام لوناً إضافياً زاد من نسيج هذه القوة الناعمة لهذه الفعالية، وقد تجلى هذا الاهتمام في قائمة أبرز ضيوف حفل افتتاح البطولة من قادة الدول ومسؤوليها، في مقدمتهم ولي العهد السعودي ورؤساء كل من مصر والجزائر وتركيا والأردن وفلسطين، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان طبيعياً أن تتواجد لتغطية أحداث الدورة الرياضية الأبرز، أكبر وأعرق وسائل الإعلام في جميع القارات.
لم يكن للإعلامي الحقيقي الذي تولى تغطية فعاليات المونديال، أن يتجاهل الإنجازات المثيرة للإعجاب، والتي صيرة الحدث الرياضي – حسب وصف النقاد – أفضل نسخة في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها قبل قرابة قرن من الزمان، من تلك الإنجازات المبهرة على سبيل المثال، تحكم المنظمين في درجة حرارة الملاعب العملاقة المفتوحة في مناخ صحراوي، لتلبي المواصفات التي تعهدت بها قطر وراهنت على تحقيقها، رغم محاولات البعض في بدايات ترشيحها التشكيك في ذلك، والتذكير به بين حين وآخر كأحد الشواهد على استحالة تنفيذ وعودها.
المونديال قوة سياحية:
تحولت قطر منذ عام 2012م، وهو العام الذي ترشحت فيه لتنظيم المونديال، إلى ورشة عمل ضخمة ليس فقط لإنشاء الاستادات الرياضية الثمانية العملاقة التي أجريت عليها مباريات البطولة، ولكن لأنها تزامن مع رؤية قطر 2030، التي تطلبت تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة في كافة القطاعات شملت المواصلات والأسواق وخدمات الإيواء، وكذلك إنشاء مجموعة فريدة من المدن العصرية الجديدة المجاورة للعاصمة، يربطها خط مترو سريع سهل بشكل كبير مهمة توزيع الزوار وإيصالهم لوِجهاتهم، وفق خطط تفويج سلسة نفذها وشارك بها المئات من العاملين والمتطوعين، وعزز من ذلك توفير أكثر من (300) حافلة كهربائية صديقة للبيئة، تنقل المشجعين من وإلى الملاعب الرياضية والمرافق المختلفة.
كان يكفي لمن عاش الحدث في أيام البطولة أن يتعرف على ردود الأفعال الإيجابية لدى الجماهير الغفيرة، ويلمح علامات الرضا والسعادة الغامرة لديهم في وجوههم، ولعل مما عزز من هذا المواقف طبيعة تعامل المجتمع المحلي المضياف، وتنوع المقومات السياحية التي حرصت قطر على توفيرها وإبرازها في أكثر من شكل، وبخاصة التراث الوطني والخليجي الفريد، الذي استثمر خير استثمار بدءً من اعتماده كعلامة بارزة في تصاميم عدد من الملاعب الرياضية، في مقدمتها استاد البيت الذي شهد فعاليات حفل الافتتاح، الذي فاجأ زاره بوجوده في وسط الصحراء؛ ليعبر عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال، في هيئة أخّاذة تحاكي بيوت الشَّعر القديمة للبدو الرُّحل، الذين شكلوا لسنين طويلة السواد الأعظم من سكان الجزيرة العربية ودول الخليج، قبل اكتشاف النفط.
كان من مكتسبات البطولة توهج التراث الخليجي بصورة لافتة، وقدرته على جذب جميع زوار البطولة من شتى أصقاع المعمورة، ويكفي شاهدًا على ذلك أن تذهب في المساء في أيام البطولة إلى سوق واقف التراثي بوسط الدوحة؛ لتكتشف أن الحصول على مقعد في أحد مقاهيه أو مطاعمه لا يقل صعوبة عن معاناة الحصول على مقعد لحضور إحدى المباريات المهمة بكأس العالم نفسه؛ بل إن ساحات السوق تحولت إلى فضاء يموج كل ليلة بجماهير الفرق الفائزة، التي كثيراً ما يشاركها معظم المتواجدين في أجواء فرائحية نادرة بين العديد من الجنسيات.
كان من مظاهر نجاح المنظمين في التعريف بالتراث الخليجي وغرس محبته في قلوب الجماهير، كذلك، إقبالهم الكبير على شراء الزي الخليجي، وسعادتهم بارتدائه، بعد أن كان قبل مونديال قطر رمزاً لشيطنة العرب ووصمهم بهتاناً بمصدر الشر والكراهية، بسبب تجني الإعلام الغربي عليهم لسنوات طوال، أما سبب ذلك الإقبال فهو إنتاج كميات هائلة منه بألوان عديدة تحاكي أعلام الدول المشاركة، ليجد المشجعون في ارتدائه وسيلة مثيرة لإظهار هويتهم، ولمساندة منتخباتهم؛ بل وجدوا فيه خياراً من خيارات الهدايا التي تستحق الاقتناء للعودة به إلى ديارهم، في بادرة تحول لرمزية الزي الخليجي نحو معنى الخير والإيجابية.

أخيراً:
لقد أثبت مونديال قطر 2022 أن هناك قيماً مضافة توجب استضافة الدول للفعاليات الدولية، كأحد أذرعة القوة الناعمة التي يمكن استثمارها في تعزيز الصورة الذهنية، فقد اتضح أن بطولة في حجم كأس العالم منحت سكان دول الخليج والعالمين العربي والإسلامي زخماً وقوة محفزة هم بحاجة لها ليس للتعريف بمقوماتها الثقافية والاجتماعية فقط، بل حتى لتحقيق انجازات أفضل لمنتخباتها، ولا أدل على ذلك من النتائج التي حققتها الدول العربية التي شاركت منتخباتها في البطولة، التي وصفتها الكثير من وسائل الإعلام بأنها أبرز المفاجآت على الإطلاق، على نحو فوز المنتخب السعودي المذهل على الارجنتين، التي توّجت لاحقاً باللقب، وكذلك تمكن المنتخب المغربي المستحق من الوصول إلى دوري الأربعة، في إنجاز لم يسبقه فيه أي منتخب على مستوى القارة الإفريقية أو على مستوى العالم العربي.
إن النجاحات التي حققتها النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم حقيقة يشهد بها الحضور الجماهيري العريض، الذي تؤكده الأرقام القياسية التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فبحسب الفيفا بلغت نسبة إشغال ملاعب كأس العالم الثمانية 96% التي استضافت دور المجموعات، وفاق أعداد الذين حضروا المباريات ثلاثة ملايين وربع المليون تقريباً مع انتهاء المباراة النهائية.
لقد كشفت البطولة الأخيرة أن قوتها الناعمة ذات مكونات ثرية مؤثرة لا تنتهي، وهو ما ظهرت بعض دلائله حتى في اللحظات التي أعقبت إطلاق حكم المباراة النهائية لصافرة النهائية، حينما فاجأت قطر العالم أجمع بخطوة أثارت ضغينة بعض النفوس الغربية، بتقليد أميرها المشلح العربي “البشت” كابتن منتخب الارجنتين ليونيل ميسي قبل استلامه لكأس العالم، في مشهد سيبقى خالداً في الأذهان إلى الأبد.
هنيئاً لدولة قطر وللعالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع هذا الإنجاز التاريخي، والنجاح المذهل في تقديم صورة مثلى وناصعة للمحفل العالمي الرياضي الأبرز على ظهر البسيطة.