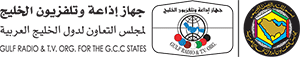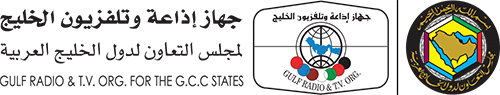-المنصات الجديدة تصبح الأكثر تأثيرًا في متابعة المشاهدين.
-العودة إلى المسلسلات ذات الحلقات العشر تُسهم في تكثيف الأحداث وسرعة انتقالها.
-الدراما الخليجية لم تتمكن من الفكاك من أسر الموضوعات المكررة.
-الكوميديا تستدعي أيقوناتها الماضية.
مرت الأغنية العربية بمراحل عديدة من حيث زمن الأغنية، فبعد أن كانت مدة الأغنية تتخطى الساعة، ظلت مدتها تتقلص وتحسب بالدقائق، إلى أن أصبحت تحسب بالثواني أيضًا.
وانتقل المسرح من المسرحيات ذات الفصول الثلاثة، إلى مسرحية الفصل الواحد، وبعد أن كان زمن العرض المسرحي يتخطى الثلاث ساعات، أصبح لا يزيد عن الساعة الواحدة.
وها هي الدراما التلفزيونية تلحق بالركب، وتنتقل من المسلسلات ذات الثلاثين حلقة إلى الحلقات العشر أو السبع.
ولكن السؤال الذي يطرأ على الذهن.. هل تؤثر المدة الزمنية على معايير الجودة والإتقان؟ والإجابة البديهية هي النفي بالطبع.
لكن الأجدر بالتساؤل ما مدى مواءمة المدة الزمنية مع قصة العمل الفني، وتكثيفه غير المخل، بل والمتوازي مع تتابع الأحداث، وعدم ترهلها؟.
كما مرت نوافذ عرض الأعمال التلفزيونية – أيضًا– بمراحل عدة، فقد كانت قاصرة على قنوات التلفزيون الرسمي في الدول المختلفة، والتي لم تكن تزيد عن القناتين أو الثلاث على الأكثر في كل دولة.
انطلقت الفضائيات لتتسع نوافذ العرض، وتزيد معها نسبة الأعمال المنتجة، وتتسع الدائرة أمام المشاهد نتيجة تعدد الوجبات الفنية التي تتيح له فرصة الاختيار والتقييم للأعمال التي يفضل مشاهدتها.
وها نحن نصل إلى الحل الأمثل المتناسب مع العصر الحالي، وهي المنصات، فلقد أصبح بمقدور المشاهد أن يتابع أي عمل يرغب في مشاهدته، في الوقت الذي يناسبه، دون أن يرتبط بمواعيد العرض عبر الفضائيات.
الجديد – أيضًا – هو دخول هذه المنصات في مجال الإنتاج، إذ أصبحت تنتج أعمالاً فنية تُعرض حصريا من خلالها، وحرصًا منها على تحقيق أقصى ربح ممكن، وتخفيض تكلفة هذه المسلسلات، أصبحت تنتج أعمالاً لا تزيد عن الحلقات العشر، وهو ما أضفى تنوعًا وزخمًا كبيرًا فيما يتم تقديمه عبر الشاشات المختلفة.
في شهر رمضان الماضي، اشتدت المنافسة بين الأعمال الدرامية المعروضة، وأصبحت تتجاذب عين المشاهد لتحظى بمتابعته، وتحقق هدف شركات الإنتاج إلى حد كبير التي حصدت كمًا لا بأس به من الإعلانات، التي تدر أرباحًا طائلة.
المحتوى العامل الأهم في العملية الإنتاجية
يظل المحتوى هو العامل الأهم في العملية الإنتاجية، فما الذي يتم تقديمه من خلال هذه الأعمال؟ وهل هناك جديد يذكر يضيف إلى المشاهد، أم أن التكرار في الأفكار، وعدم القدرة على الخروج من دائرة النمطية، هو الفخ الذي وقعت فيه هذه المسلسلات؟.
وقعت الدراما الخليجية في أسر النمطية، واللهاث خلف استدرار عواطف المشاهد، من خلال موضوعات اجتماعية لا تخلو من مواقف تدعو إلى التعاطف مع بطل العمل الفني، من دون أن تناقش قضايا اجتماعية تشغل بال المواطنين، أو تقدم حلولاً لمشكلات بعينها، أو على الأقل تسعى إلى التوعية التي تدخل من باب الإبداع إلى وجدان المتلقي.
وعلى سبيل المثال، فإن مسلسل “في دروب السعي مظالم” الذي تمحورت أحداث قصته حول “راشد” الذي كان يحضر لرسالة الدكتوراه في القاهرة، وهناك يتعرف على طالبة في السنة النهائية لدراسة الماجستير في الإعلام، ويقع في حبها، غير أن الفوارق الطبقية بينهما تحول دون زواجهما، ثم يتم اتهامه في جريمة قتل، وبعد مرور (22) عاما على سجنه، تثبت براءته.
وفي ذات السياق نجد مسلسل “قرة عينك”، الذي يدور حول سجن البطلة ظلمًا، حيث تحاول التواصل مع بناتها لكنهن رفضن التواصل معها.
وعلى صعيد آخر فإن مسلسل “عزيز الروح”، يدور حول سعود الذي يعود من الخارج، ويشك في أمانة شقيقه، فينهي شراكته معه، وتحدث قطيعة بين الشقيقين.
بينما تدور قصة الجزء الثاني من مسلسل “منهو ولدنا” حول بندر الذي يحاول مساعدة ريان في إدارة الشركة، لكنهما يختلفان، ويشتد الخلاف بينهما.
محاولات لمحاكاة قضايا العصر
في محاولة لمحاكاة قضايا العصر، وتأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على تغير سلوكيات المجتمع، يؤدي أبطال مسلسل “غسيل” أدوار مشاهير على السوشيال ميديا لمحاكاة تأثير العالم الافتراضي على تغيير العادات والتقاليد، والذي يصل إلى “غسيل المخ”، إلى جانب التطرق لقضية غسيل الأموال.
أما محاولات الغموض والتشويق، فلا تزال قائمة في المسلسلات كعادتها، والتي تظهر في مسلسل “منزل 12″، حيث تمتلك البطلة أشياء تحيلها إلى عوالم خفية.
الكوميديا حبيسة الأفكار سابقة التجهيز
سجن الكوميديا التي لم تزل حبيسة أفكار سابقة هو العامل المشترك الأكبر، فالعودة إلى المسلسل الكوميدي الخليجي الأشهر “طاش ما طاش 19″، هو أكبر دليل على أن الأيقونات التي صارت تاريخًا، يتم استدعاؤها، لتكون الأبرز على ساحة الكوميديا.
ولم تكن الكوميديا المصرية بعيدة عن ذات السياق، فمسلسل “الكبير” قد تم تقديم نسخته السادسة، ليقع في فخ النمطية والتكرار وعدم قدرته على الإبهار الذي كان يتميز به في السابق.
بينما غرد المسلسل الكوميدي المصري “الصفارة” منفردًا، ليأتي بالجديد من حيث الفكرة والمحتوى، بل وقدرته على ألا يكتفي بالإضحاك فقط، لكنه يتضمن رسالة نبيلة ومهمة، وهي الرضا بما قسمه الله، وهي فضيلة كبرى، لا يتمتع بها إلا القليلون.
ومن أوجه التميز في المسلسل أن هذه الرسالة لم تظهر بشكل مباشر، أو عن سبيل “الوعظ”، ولكنها أتت في سياق منمق ومغزول بعناية فائقة، تنم عن وعي صناع العمل سواء المؤلفة، أو بطل العمل الفنان أحمد أمين الذي تتسم غالبية أعماله بمحاولات الخروج عن السياق وتقديم أعمال تتسم بالابتكار ومحاولات التجديد.
“تحت الوصاية” الأبرز في الدراما المصرية
ربما يُعد مسلسل “تحت الوصاية” هو الأبرز في الدراما المصرية هذا العام، وهو العمل الذي ناقش قضية مهمة، تعرضت لمعاناة المرأة المصرية في أن تكون الوصية على أبنائها بعد رحيل الزوج، وتمكن المسلسل من عرض القضية في سياق درامي فني بليغ التأثير، وحقق هدفين في آن واحد، تمثلا في الإجادة الفنية من حيث التمثيل والتصوير والإضاءة، وعلى جانب آخر إبراز القضية في إطار فني شديد التأثير في وجدان المشاهدين.
وها هو المسلسل يحقق أسمى ما يهدف إليه الفن، وهو التأثير في المجتمع، حيث انتقلت القضية إلى البرلمان المصري الذي فتح هذا الملف، لمناقشته والبحث عن حلول قانونية عادلة في هذا الموضوع.
تغلبت الجماهيرية على رأي النخبة من النقاد في مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، الذي أصبح له مريدوه ومتابعوه خاصة في الأوساط الشعبية، إذ يمثل لهم البطل الأسطوري الذي سيظل على مر الزمان هو الأكثر إشباعًا لرغبات البسطاء وأحلامهم.
المذهل في الأمر أن “جعفر العمدة” لم يكن البطل المثالي، بل كانت تصرفاته تنم عن أخلاقيات مرفوضة، لكن السياق جعل المشاهد يتعاطف معه، ويثني عليه، وهو ما لا يجب أن يتم تقديمه عبر الوسيلة الفنية الأكثر تأثيرًا، ألا وهي المسلسلات التلفزيونية.
عودة المسلسلات الدينية رغم قلتها
الجديد هذا العام، وهو العودة إلى تقديم مسلسلات تتسم بالوازع الديني، بعد أن اختفت خلف ركام الرغبات التجارية التي أصبحت تحكم العملية الإنتاجية، فتقديم مسلسل “رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، يعد عودة قوية للأعمال الدينية، التي يجب أن يزداد عددها حتى يتاح نشر مفاهيم الدين القويم.
وفي محاولة لم تكتمل لتقديم صياغة جديدة للمشكلات الأسرية جاء مسلسل “الهرشة السابعة” الذي حاول صناعه تقديم المشكلات العائلية العصرية في إطار فني جاذب، لكن المحاولة في رأيي لم تكن مكتملة، وابتعدت عن وجدان المشاهدين الذي يعد الضمير الأهم للعمل الفني.
دراما الأحداث الوطنية لا يمكن الاستغناء عنها
شهدت السنوات الأخيرة تألق الأعمال التي تستعرض أحداثًا وطنية، تسهم في تعميق مفاهيم الوطنية والانتماء، وتعمل على التعريف بهذه الأحداث، وإطلاع المواطن على تفاصيلها، لتصحيح المفاهيم، وتنمية الفكر والوعي.
وقد تم تقديم مسلسل “الاختيار” بأجزائه الثلاثة، وكان له عظيم الأثر في تأجيج المشاعر الوطنية، كما شهد هذا العام مسلسل “الكتيبة 101” التي تأتي ضمن سلسلة هذه الأعمال، فهناك أحداث وبطولات تخفى على المواطن العادي، وجهود دؤوبة تبذلها أجهزة وطنية، تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.
إن زيادة مثل هذه الأعمال، يعد أحد أهم الرسائل التي يمكن أن تمر عبر الفن، الذي يسعى إلى السمو والنبل وكافة القيم الرفيعة.
الديكور والتصوير والإضاءة عناصر مهمة في تقديم معادل بصري حي
يُعد الديكور والتصوير والإضاءة عناصر مهمة في تقديم معادل بصري حي، يخطف عين المتلقي، ويصبغ الأداء التمثيلي بلغة فنية تصنع إطارًا غير مباشر لتكتمل الرؤية البصرية، التي تعد الأهم في الأعمال التي تطل عبر الشاشات سواء السينمائية أو التلفزيونية.
ولا يمكن إنكار وجود قفزة في مستوى هذه العناصر التي أصبح صناعها يتميزون بالإجادة الفنية التي تساعد المخرج في تحقيق أغراضه الفنية، وتعد أذرعه التي يحلق بها في فضاء الإبداع الرحب.
وعلى سبيل المثال، فإن مسلسل “تحت الوصاية” الذي جرت أحداثه في مدينة ساحلية، لم يخل من عناصر ديكور رفيعة المستوى، وتمكن التصوير والإضاءة من إبراز عوامل مهمة في سير أحداث المسلسل، ومنها زوايا التصوير الضيقة التي جرت في “المركب” الذي شهد أهم أحداث المسلسل.
أين المؤلف؟!
المتأمل في الأعمال الرمضانية بشكل عام، يبحث – دائمًا – عن فكر وقلم المؤلف، الذي جاء في معظم الأحيان غير قادر على أن يضيف إلى ذاكرة الدراما شيئا يذكر.
وهو أمر يحيلنا إلى تاريخ الكتَّاب الذين لا تزال أعمالهم تعاد حتى الآن، ويتأثرون بقلب وعقل المشاهد، أمثال أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد وغيرهما.
الأمر الملفت – أيضًا – أن العديد من كتَّاب السيناريو والحوار قد لجأوا في سنوات مضت إلى الرواية لتكون متكأً لهم في اختيار موضوعات أكثر عمقًا مما يتم تقديمه، إلا أن هذه الظاهرة قد عادت إلى الاختفاء تدريجيًّا.
وهنا يثور التساؤل.. أين المؤلف؟!.. أين القلم القادر على ابتكار موضوعات جديدة، يتم غزلها بتأن وعناية، حتى تصيب الهدف وتتمكن من أن تحاكي أيقونات الدراما العربية السابقة.
إن الأمر يستدعي التوقف أمامه طويلاً، لقد شهدت الفترة الماضية ظهور ورش الكتابة، واستدعاء مشرفين عليها، وهي أمور غير مستهجنة، لكنها لم تحقق المرجو منها، وعلينا أن نلفت النظر في قلة المنافذ الأكاديمية التي تقدم وجبات كافية لدراسة الكتابة الدرامية.
صحيح أن الموهبة هي العامل الأهم في هذا المضمار، لكن تعلم أسس الكتابة على يد متخصصين أمر في غاية الأهمية – أيضًا –، ويمكن أن تكون هذه المعاهد والكليات تعد على أصابع اليد الواحدة في عالمنا العربي، وعلينا أن ندعو إلى زيادة ورش تعلم الكتابة والسيناريو.
كيانات الإنتاج الكبرى تلتهم الكعكة المادية
يجب ألا نغفل أن وجود كيانات إنتاجية كبرى، هو سلاح ذو حدين، فهذه الكيانات بإمكانها التصدي لأعمال ضخمة، كما أنها تستطيع تقديم وجبات متنوعة كثيفة العدد، ولكنها على الجانب الآخر تمعن في إصابة شركات الإنتاج الصغرى بالشلل، وعدم القدرة على مجابهة هذا التيار المادي الجارف.
والحل يكمن في الشراكة، والتعاون بين هذه الشركات، وهو ما يحقق غزارة وتنوعًا في آن واحد، ويحقق المنافسة التي تعود إيجابًا على المشاهد المستفيد الأهم من هذه الدائرة الإنتاجية.
لقد أصبحت هذه الصناعة ذات مردود كبير يستحق أن يقدم محتوى جادًا ومتميزًا، وعلى كافة المشاركين في هذه الصناعة أن يعوا أن المشاهد هو الناقد الأول، الذي بإمكانه أن يسهم في أن يعيش العمل لأطول فترة ممكنة، أو أن يتوارى سريعًا.
أين نحن من العالمية؟
أليس من حق الدراما العربية التي تضرب بجذورها في سنوات بعيدة، أن تطل عبر النوافذ العالمية؟!
أليس من حقنا أن نشارك عبر المنصات الدولية في تحقيق نسب مشاهدة أعلى والاستئثار بمتلقين جدد؟!
إن “نيتفليكس” على سبيل المثال، أصبحت تحفل بإنتاج فني من دول عدة، وهناك محاولات عربية على استحياء، لكنها – أيضًا – لم ترق إلى أن تكون شريكًا مهمًا في هذا السباق الدولي.
لقد سلطنا الضوء على نشأة كيانات إنتاجية عربية كبرى، فلماذا لا تحدث شراكة في إنتاج أعمال ضخمة تستعرض فصولاً من تاريخنا العربي العريق، يتم تقديمه عبر هذه المنصات، وهو ما يتيح الرد بالفن على الادعاءات التي يسوقها البعض بغرض تشويه الصورة عن العرب والمسلمين.
إن الوقت قد حان إلى أن تصير هذه الأفكار واقعًا، وأن تتحول إلى إبداعات حية، تنطق وتروي تاريخنا المرصع بالمحطات المهمة.
تراجع الفصحى التي تاهت بين اللهجات
لا مانع من أن تسود لهجة كل بلد منتج لعمل درامي، ما يتم تقديمه من خلالها، ولكن علينا أن نلتفت إلى أن التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت شريكًا في جريمة انتهاء اللغة العربية، واختفائها من على ألسنة أبنائنا.. ولم يتبق لنا من منقذ سوى الفن، من خلال المسرح والسينما والتلفزيون.
ولا جدال في أن الوسيلة الأكثر انتشارًا وشيوعًا هي التلفزيون، فيجب علينا أن نولي اهتمامًا بمسألة اللغة، وضرورة تقديم أعمال فنية باللغة العربية الفصحى، التي تكتنز بمكونات لا مثيل لها في اللغات الأخرى.