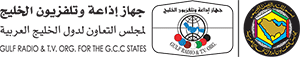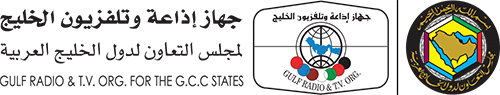ابتكار الهاتف الذكي وقبله شبكة الانترنت، قلبت عالم الاتصال، وبخاصة الاتصال الجماهيري أو ما يعرف اصطلاحاً بـ “الإعلام”، رأساً على عقب؛ فبعد أن كان هذا النشاط الحيوي مستأثراً لسنوات طوال بالسواد الأعظم من دائرة الاتصال ومساحته بشكل عام، جاء الفضاء الرقمي ليُحطّم بقوة حدود ذلك الاحتكار في ثورة دراماتيكية شجعت؛ بل وأجبرت، كل القطاعات والأنشطة دون استثناء على الدخول في محيطه من أوسع ابوابه، وبالتالي لم يعد الإعلام الوسيلة الوسيطة المهيمنة في العلاقة بين صاحب الرسالة ومستقبليها، وإن تفاوتت الأهداف.
ولعل مما يؤكد استئثار الإعلام بمعظم حقل الاتصال، أن كليات وأقسام الاتصال ركزت جل اهتماماتها، ومقررات التدريس فيها على الاتصال الجماهيري دون النوعين الأخريين، ونعني بهما الاتصال الشخصي، والجمعي، وهي حالة توجب إعادة النظر فيها، بعد أن تحطمت الحواجز بين هذه الأنواع الثلاثة في بيئة الفضاء الرقمي الذي غير خارطة ومكونات الحقل بأكمله.
كان حريٌّ بالابتكار الجديد بما يوفره من فرص تطويرية هائلة، أن يدفع أصحاب التخصص – مهنيين كانوا أم أكاديميين – إلى الاستبشار بمقدمه والمبادرة باستثماره، لا أن يتم الاكتفاء – وفقاً لقناعات البعض – بما هو متوفر، أو على الأقل، كان عليهم أن يفطنوا لآثاره على واقع تخصصهم أو صنعتهم، خاصة أن الحاجات له قد اتسعت وأن مجالاته قد تعددت وتنوعت.
هذا التصرف برهن على وجود غياب بيِّن لمرجعية محورية يمكن أن يعتمد عليها علمياً وعملياً في فهم حقيقة القادم الجديد، بما في ذلك تحديد أطره وأساليب التعامل معه، وكذا طبيعة العلاقات بين متغيراته، وهو ما ترك الحبل على الغارب للكثير من الاجتهادات التي تفرضها ضرورة توظيف مزاياه الجاذبة لخدمة الجميع على نحوٍ يختصر المسافات، ويوفر العديد من الخدمات التي شهدت نقلات نوعية، وعجلت بتجسيد أحلامٍ كانت إلى قصص الخيال العلمي أقرب.
هل انتهى تخصص الاعلام؟!
الجواب عن هذا السؤال المتكرر يعد مسألة نسبية، ويخضع لطبيعة الزوايا التي ينظر من خلالها المجاوبون؛ وبالتالي لم يكن مستغرباً أن تتشكل جملة من الآراء التي تتفاوت نظرة أصحابها وإن كثرت بين رأيين متضادين، أحدهما إقصائي حدِّي تعجل بإطلاق رصاصة الرحمة على الإعلام وحكم عليه بالموت، ويستشهد أصحابه بالضرر البين الذي طال أشكال الوسائل التقليدية، وعزز من موقفهم ولا شك مؤشرات ملموسة بينها انهيار وتوقف العديد من الصحف الورقية عن الصدور على مستوى العالم، وكذلك انحسار توزيع المتبقي منها، مع تراجع ملحوظ في أعداد مشاهدي القنوات التلفزيونية ومستمعي محطات الإذاعات، التي بقيت تمارس مهامها وفقاً لما اعتادت عليه منذ نشأتها.
في الجانب الآخر، هناك فئة ترفض هذا الحكم تماماً وتفنده، إذ ترى أن الإرباك الحالي سببه خلل إداري في طريقة التعامل مع متغيرات يجهلها القائمون على الوسائل الحالية، فتسببوا في جعلها تعيش حالة جمود كلفها الكثير، وخسر معها الإعلام العديد من المقومات الأساسية التي كان يمكن التأسيس عليها في تطوير يمكنها من مواصلة المسيرة، خاصة أنها تتكئ على إرث مهني عريق.
كان من أثمن خسائرها تساقط العديد من أفراد كوادرها البشرية من الموهوبين وأصحاب المهارة ومن ذوي الحس الإعلامي والخبرة الطويلة، دون العمل على تهيئتهم للتحول من خلال إعادة تأهيلهم وتمكينهم من التعامل مع أبسط أساليب الساحة الرقمية. ولعل مما يبعث على الحيرة أن تتمكن صحفاً الكترونية حديثة النشأة، بعضها غير مؤسساتي، من التقدم على صفوف صحف عريقة لديها من المراسلين في أماكن جغرافية متعددة ما يفوق المستحدث، وقد كان بإمكان الصحف القائمة قبل التحول أن تستثمر في منصة رقمية مستقلة قادرة على تحقيق تغطيات أوسع من الصحف الناشئة، بالنظر إلى تفوقها مالياً وبشرياً وفنياً.
وللبحث في تفسير الاختلاف بين الرأيين المتضادين وما بينهما، يتبين أنه يتمحور في مسألة تعريف الإعلام الجديد نفسه، فمن يحكم بنهاية الإعلام أو قرب تلاشيه يستند في حكمه على اعتقاد يقرر أنه نشاط فقد العديد من مقوماته وملامح شخصيته، وأن أدواره تفرقت بين مستخدمي الوسائل الرقمية، وبالتالي فإن بضاعته وتحديداً تغطية الأحداث أو ما يطلق عليه “الأخبار”، التي هي أساس المادة الإعلامية، باتت بضاعة كاسدة يوفرها الجميع؛ فأول من يقوم بتغطية الأحداث التي تمس المؤسسات الاعتبارية أو المجتمعات أو حتى الأفراد – على سبيل المثال – هم أصحاب الحدث نفسه، كونهم –خاصة بعد امتلاكهم للوسيلة- وبالتالي أصبحوا يستأثرون بخاصية السبق في النشر بغض النظر عن مهنهم أو اهتماماتهم، ويؤكد هذا حقيقة قيام بعض صناع القرار من الساسة والبارزين في مجالاتهم بنشر قراراتهم بشكل مباشر؛ فغدا مألوفاً أن يُقدِم القادة والمشاهير ومن في حكمهم على مخاطبة الجمهور من حساباتهم الشخصية، التي وجدوا بها من المزايا ما يفوق الاعتماد على آخرين (وسطاء) لبثها؛ وهي خطوة تضمن عدم اجتهاد غيرهم في التعبير عن مقصدهم، وهم بهذه الآلية يمنعون احتمالية تحريف مضامين موادهم، وربما باتوا أكثر إقناعاً بموثوقية الخبر في حال التزامه بقيم النشر الإعلامي المعروفة.
هذه التحولات تقرر أن الحدث لم يعد ينتظر وكالات الأنباء أو مراسلي الصحف أو محطات الإذاعة والتلفزيون، من أجل نقل الصورة كما تظهر لهم، أو كما يبديها لهم من كان متواجداً في لحظة حدوثه ليكون شاهد عيان ويصفه بتفاصيله، ومن ثم يقوم مراسل الوسيلة بإرسال مادته لجهته التي تتعامل معها وفق أسس وضوابط مهنية محددة، ربما تحرق عامل الآنية، وبالاعتماد على هذا التبرير يتضح سبب قناعة من يرى أن الإعلام تخصص من الماضي، غير أن مما يلفت الانتباه هنا أن أساس الحكم اعتمد في النظر إلى نماذج محدودة يمكن التعامل معها بقدَرها.
ذلك أن المناوئين لهذا الرأي يؤكدون أنه على الرغم من صحة الدلائل والمؤشرات التي يستشهد بها أصحاب الرأي الأول، إلا أنها ليست كافية للحكم بهذه العمومية على صناعةً بأكملها، لأنهم يعتمدون في وجهة نظرهم على عناصر جانبية لا تمس الأهداف أو الجوهر لأنها تنحصر في أشكال الوسائل، وكما هو معروف عند المخططين، بل وحتى عرفاً في أوساط المجتمعات، أن أحد أبرز فشل المشروعات أو بطلان الآراء بشكل عام، يعود إلى انشغال أصحابها بالوسائل، ونسيان الأهداف أو تجاهلها. ليس هذا فحسب؛ بل إن هؤلاء المعترضين على الرأي السابق يرون أن هناك فرصًا عديدة للتجديد، وأن المقومات الإعلامية في هذا العصر باتت أفضل عما كانت عليه سابقاً.
وبالتالي فهم يرون بأن المتسرعين في الحكم على الإعلام بنهايته، تعوزهم النظرة الشاملة للمجال، بل إنهم يرون بأن هذا الحكم الجائر في نظرهم يعود لأسباب غير مهنية، بعضها شخصي يغلّب الأهواء والرغبات على المصالح العامة؛ والأسوأ أنه ذو أخطار على التنمية المجتمعية، بل ويُضعف قوة الدول في الوصول إلى الرأي العام، إذ أنه يعطل مهام القيام بالوظائف الإعلامية المعروفة.
إن وجود هذين التيارين في الحكم على مستقبل الإعلام، يضعه على مفترق طرق تستحق المراجعة، ويوجب تأمل البنية التحتية لواقع الحال بصفتها محرك رئيس في تقرير مصير التخصص، وللوقوف على هذا الجانب لابد من تحليل الواقع وفقاً لتقسيمين رئيسين، أحدهما: الشق المهني الذي يعكس طبيعة الممارسة الإعلامية وتطوراتها، وثانيهما: الشق المعرفي الذي يُعوَّل عليه في القيام بأدوار مهمة في التخطيط والاسهام في كيفية التحول الحتمي إلى الفضاء الجديد.
واقع الحقل المهني:
لعل من المفارقات أن أصحاب الرأي المقتنع ببقاء النشاط الإعلامي وضرورة حمايته وتطويره، يرون أن في مقدمة المتسببين بتشتيت هوية الإعلام في المرحلة الراهنة هم أقرب العاملين فيه، ويقصدون بهم أولئك الذين يصرون على المحافظة على أشكال وسائل الأمس، وكأنهم لا يريدون تصديق الحقيقة، أو أنهم لم يبحثوا كما يجب في الخيارات التي كانت ستقود إلى التطوير بصورة تعزز العلامة (السمعة) التي اكتسبتها العديد من المؤسسات الإعلامية العريقة، وتسهم في الوصول لجمهور أعرض وعالم أرحب، والشواهد في هذا موجودة.
ومن هذا المنطلق، فإن تصرف أولئك التقليديين يظهر أنهم إلى حد كبير ذَوُو نظرة آحادية وضيقة في تعريف الإعلام، إذ تقوم على قناعة غير مبررة بشكليات أوشكت ان تختفي، ومن مخاطر هذه النظرة، مهما كانت أسبابها، أنها ترسخ اعتقاداً خاطئاً مفاده أن الإعلام هو ذلك الشكل الذي يجب أن يبقى، وتنسجم هذه النظرة مع ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول الذي قرر أن نهاية هذه الشكليات تعني نهاية مهنة عريقة.
إن التخلص من التفكير بعقلية الورق حري بأن يضع الأمور في نصابها الصحيح، فيقرر من حيث المبدأ أن هناك إعلاماً منتظراً لم يُكتب له النهوض كما يجب حتى الآن، ويستدعي العمل على تصحيح الوضع والتدخل لمعالجته بأساليب علمية وعملية عدة، وبالتالي فإن هذا التصحيح لابد أن يبدأ مع التقليديين الذين تشبثوا بجوانب يفندها واقع الفضاء الرقمي، فنشاط الاتصال بأكمله، لم يعد حكراً على وسائل الإعلام كما كان عليه الأمر قبل حلول الانترنت، وهذا الأمر ليس شرطاً في بقاء الصناعة، فالواقع يُحتم التعامل معه وفقاً لمبدأ المرونة وتحديد الصلاحيات والمهام، وبناءً على نظرة براغماتية وموضوعية في التمييز بين الأنشطة المتخصصة التي باتت تختلف كثيراً عن السابق، وهذا يعني ضرورة القبول بأن بعض ما كان خاصاً بهم سابقاً لم يعد ممكناً بقاؤه ضمن إطار مهامهم وأدوارهم في الزمن الحاضر. وهذا الرأي يجب ألا يُنظر له على أنه تهديد لصناعتهم؛ لأن البدائل والخيارات في الأدوات والأساليب غدت أكثر من ذي قبل.
وهنا نعود إلى القول بأنه ما تكن هناك مرجعية مركزية، ذات هدف واضح همها الأول والأخير مناقشة واقع الإعلام، وسبل إعادة هيكلته وفقاً لما فرضته التغيرات الدراماتيكية في حقل الاتصال، والتعرف بدقة على أثرها الجذري في عمق التخصص، فإن المطاف قد ينتهي بالتخصص إلى ذوبانه في تخصصات أخرى، وهو ما ظهرت آثاره في أكثر من مسار، على نحوٍ قاد بعضها رغم عدم صلته بصلب الاتصال إلى أن يرى أحقيته في عناصر وجوانب تعد أركاناً رئيسية في الإعلام.
يجب ألا يُفهَم من ذلك أن المطلوب إقصاء التخصصات الأخرى ذات الصلة؛ أو قصر الأمر على تخصص بعينه؛ بل إن الواقع يقرر العكس من ذلك في كثير من جوانبه، فالحاجة إلى بناء شراكات وصلات بينية مع تلك التخصصات؛ وبخاصة مع ما له علاقة وطيدة بالتطور التقني الاتصالي، باتت امراً مُلحاً وضرورياَ لتحقيق التكامل، ذلك أن أحد أسباب الضعف الذي اخذ يعتري التخصص؛ والعجز الملحوظ في محاولات واسهامات التخصصات الأخرى عن القيام بوظائف الاتصال كما يجب، يكمن في عدم وجود التكامل والتعاون بين التخصصات.
ولعل أقرب الأمثلة على ذلك، العلاقة الهشة بين أربع تخصصات معنية بطريقة وأخرى بالنشاط الاتصالي. ونعني بها الإعلام، المعلومات، الحاسب الآلي، والفنون، فهذه التخصصات قادرة – في حال بناء الشراكات بينها – على إيجاد مزيج فريد يجمع بين طبيعة مجالاتها، وصلتها بالنشاط الاتصالي لتقديمه في ثوب رقمي فعال، وستفضي النتيجة إلى الوصول إلى المزيد من الابتكارات الاتصالية المذهلة، القادرة على الوصول للجماهير المستهدفة على نحوٍ يفوق ما كان عليه الأمر قبل حلول الانترنت، لذا فقد آن الأوان لتوحيد الجهود للتعامل مع الحقل الاتصالي الجديد في شخصيته المختلفة وفق تخطيط محكم، قادر على جمع الأطراف المختلفة، ضمن رسم الخطوط الفاصلة، ويحدد الصلاحيات وفقاً للاختصاصات الدقيقة، على نحوٍ يعيد تمَوضع التخصص ويعزز من قوة كافة أنواع الاتصال.
ولابد من التنويه إلى أن هذا التكامل المنشود لن يُكتَب له النجاح، وقد يكون مصيره الإخفاق، إذا لم يراع الاحترام الذي تفرضه الصناعة، فلابد أن تضمن بيئة التعاون عدم تجاوز أي من التخصصات الخطوط الفاصلة بينها، ذلك أن أكبر مهدد لتحققه سهولة اعتقاد البعض منها انه يملك القدرة التامة على القيام بما لدى التخصص الآخر، وهو ما يحدث في معظم الممارسات الحالية، وينعكس سلباً على الأداء، وسرعان ما يتضح عواره في أخطاء مهنية لا يعرفها سوى أصحاب التخصص المعني.
من أوجه هذا الخلل استئثار قسم او إدارة ما في بعض المؤسسات بتشغيل مشروع يتطلب الشراكة مع الأقسام المتخصصة في القيام بكامل المشروع، كأن تقوم إدارة تقنية المعلومات IT على سبيل المثال ببرمجة موقع المؤسسة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وهو نشاط في صميم عملها، غير أن الإشكالية تقع حين تتجاوز تلك الجهة مهمتها بالعمل على تصميمه، بل والقيام بصناعة المحتوى ربما بحسن نية أو طمعاً في أن تسجل حضور أكبر، خاصة لدى الإدارة العليا، ولأنها تمتلك المعرفة اللازمة في البرمجة، تنظر خطأً للتحرير الإعلامي على أنه مهنة ميسورة، بل ومشاعة، وأن قدرة موظفيها على التحرير (دون إدراك للقواعد المتبعة في ذلك)، تجعلهم في غنى عن الاستعانة بإدارات أخرى.
هذه الحادثة وقعت بالفعل ذات مرة في إحدى المؤسسات، وكانت نتيجتها أن انتهى الأمر إلى تعالي أصوات بقية الإدارات بالتذمر من غياب القيم الإعلامية في النشر المؤسساتي، وتحديداً الموضوعية، وشيوع التحيز للإدارة المُشغِّلة، الذي يؤكده على سبيل المثال ظهور صور مسؤول تلك الإدارة المتكرر في الموقع.
واقع الحقل المعرفي:
في الجانب المعرفي، أصبحت كليات وأقسام الإعلام والمعاهد المتخصصة في موقفٍ لا تحسد عليه، نتيجة لبطئها الشديد في مواكبة التحول ومواكبة مرحلة حاسمة في تاريخ صناعة الإعلام، فبات ذلك مؤشراً على عجزها إلى حد كبير عن القيام بدورها كما يجب، بل إن من المهنيين من ألقى اللائمة عليها، واتهمها بخذلان المهنة، ليس فقط لعدم استشرافها لما وصل إليه الوضع؛ ولكن لأنها لم تقدم حلولاً مناسبة لأربابها في كيفية مواكبة التغيرات الجذرية ولم تحذر بما فيه الكفاية من مغبة تجاهله، خاصة أن الميدان كان يعج بتغيرات لافتة، وكان حري بالباحثين والدارسين أن يبذلوا فيها قصارى جهودهم للخروج بنتائج تضيء الطريق للتحول بسلاسة إلى ساحة الإعلام الجديد، وحريٌّ بهذا التقصير، أن يقرع ناقوس الخطر في أن المؤسسات التعليمية المتخصصة قد تعيش هي الأخرى مرحلة حرجة ربما تنتهي بها إلى نهاية لا تحمد عقباها، ما لم تتخذ خطوات جذرية في هذا الأمر.
هذه القول ليست استنتاجاً فردياً، بقدر ما يستند إلى نتيجة علمية لإحدى الدراسات المتخصصة التي وردت في كتاب صدر حديثاً، عنوانه: مستقبل تدريس الإعلام في العصر الرقمي. الدراسة استطلعت آراء 240 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في عدد من كليات وأقسام الإعلام في ست جامعات خليجية شملت: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت. وتبين بناءً على شهادات أساتذة الإعلام أنفسهم أن هناك جملة من التحديات التي ما لم يتم التدخل السريع لمعالجتها بصورة جذرية، فإن مخرجاتها ستبقى قاصرة بشدة عن مواكبة العصر الجديد.
كان من أهم تلك التحديات الجوهرية؛ بل في مقدمتها، معاناتهم من غياب البرامج التدريبية اللازمة لهم لفهم ومواكبة وسائل الاعلام الجديد، خاصة وأن معظمهم كان قد حصل على مؤهله العلمي قبل حلول أدوات الإعلام الرقمي أو انتشارها. يلي ذلك المعوق إشكالية تواجدهم في بيئة بيروقراطية تتعارض في بطئها في الحركة واتخاذ القرار، مع بيئة التغيرات التي يشهدها تخصصهم، إذ أشاروا صراحة إلى أن “ضوابط ولوائح إعداد وتطوير الخطط الدراسية تشكل قيوداً على التغييرات الضرورية لتطوير تدريس الإعلام”.
ليس هذا فحسب، وإنما جاء ثالثاً من بين التحديات: شح المصادر المعرفية الذي يقلل من قدرتهم على التماهي مع التطور ذاته، ونوّهوا إلى أن هناك ندرة كبيرة في الكتب الدراسية والمراجع المتخصصة القادرة على تمكين الأساتذة من تدريس الإعلام الجديد. وعزز من صعوبة الموقف، حسب الدراسة، وجود حاجز عدم الإلمام باللغة الإنجليزية بوصفها مفتاحاً مهماً للتعرف على ما هو جديد في تدريس الإعلام الرقمي كما يجب.
وكان من المفاجآت التي تضمنتها شكوى أعضاء هيئة التدريس في الدراسة المذكورة: عدم جاهزية البيئة التعليمية؛ إذ إن قاعات المحاضرات غير مهيأة لاستخدام وسائل الإعلام الجديد؛ بل أن الأكثر تحدياً من هذا اعتراف غالبية الأساتذة أن معرفة الجيل الجديد بأدوات الإعلام الجديد يفوق قدراتهم، وهو ما يوقعهم في حرج من أمرهم، ويستدعي المعالجة الفورية.
عدد غير قليل من المبحوثين نوه كذلك إلى عدم مبالاة الجهات المعنية في الجامعات أنفسها بالتطوير في هذا المجال؛ فلا يوجد تشجيع إداري كافي لاستخدام وسائل الإعلام الجديد في التدريس، كما أن هناك إشكالية لا تقل أهمية عن ذلك، وهي عدم وجود آليات مناسبة تضمن مواكبة النمو المتلاحق في حقل الإعلام الجديد.
هذه التحديات التي أقر بها السواد الأعظم من أساتذة الإعلام تكشف عن دلالة مهمة، هي أن التطوير في معظمه يقتصر في واقع الأمر على جهود فردية من قبل الأساتذة، ومؤشر على غياب شبه تام لسياسة تطويرية ملحة في حقل لا يقبل الانتظار.
خارطة طريق مقترحة:
يتبين مما تقدم أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في واقع الإعلام في ضوء الأدوار التي يقوم بها، والتي اختلفت في بعض أشكالها عن سابقتها من حيث الوسائل والقائمين بالاتصال، لقد آن الأوان لتأمل المشهد بموضوعية، بحيث يتم تركيز التخصص أكثر من ذي قبل وإن اقتضى الأمر التنازل عن الأدوار التي كانت حصرية في الوسائل التقليدية، والدخول مباشرة في محيط الفضاء الرقمي، لتلمس العناصر الجوهرية الجديدة التي تستوجب الفهم والمعرفة الدقيقة بها، وكيفية ممارستها بصورة مهنية عالية لا يتقنها الجميع، كما لا يمكن للاجتهاد العشوائي أن يلبي متطلباتها.
من تلك العناصر – على سبيل المثال لا الحصر -واقع استخدام العامة لشبكات التواصل، فالمتأمل له يلحظ التفاوت الكبير بين المستخدمين في العديد من متغيراته، بدءً من حجم المتابعة، ومروراً بأساليب صناعة محتوياتها التي تعد لوحدها مادة خصبة يمكن لتخصص الإعلام الجديد أن يفرد مساراً خاصاً بها سواء في الحقل المهني أو التعليمي، وانتهاءً بالأثر الذي تحدثه هذه الشبكات، وطرق توظيفها لإيصال الرسائل الاتصالية بمختلف أنواعها. فهذا المسار الذي سلكه السواد الأعظم من أفراد المجتمع، لا يزال يفتقد لوجود الجهات المرجعية مهنياً وتعليمياً القادرة على تقديم الطريقة المثلي لاستخدامها، أو على أن تضع الأسس التي الممارسون في ميدانه.
إن غياب تدريس الأسس والقواعد الاتصالية والآليات الصحيحة لصناعة المحتوى، وغيرها مما له صلة بالفضاء الجديد هو ما يفسر ضعف بعض الممارسين وعجزهم عن استقطاب الجمهور والمتابعين، ويمكن من خلال المرجعية الغائبة أن تطور هذا الجانب؛ بل وأهم من ذلك كيفية استثمار هذه الأدوات لصالح كافة القطاعات.
وعوضاً أن يستغرق المتخصصون في الاتصال في المجالات التقليدية، فقد آن الأوان إلى أن يقتحموا بقوة -حتى تبقى هوية تخصصهم – كل ما له صلة بالاتصال في الفضاء الرقمي، خاصة أنهم يملكون خبرة عريقة في الأسس وأساليب صناعة المحتوى، ومهارات النشر. وهم إن لم يقوموا بذلك، على نحو ما يحدث في هذه المرحلة، فإن غيرهم من التخصصات؛ بل وحتى الهواة سيعملون حتماً على ملء الفراغ بطرقهم المتعددة. وهنا تظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الاتصاليين بشكل عام، ليس من أجل الحفاظ على حقهم الأصيل، وإنما لخدمة العامة كما يجب في مسارات باتوا هم فيه أحوج إلى تمكينهم من التعامل مع نشاط اتسعت دائرته، وغدا مقوماً لا يُستغنى عنه في شتى مناحي الحياة العصرية.
لعل من أكبر التحديات التي يواجهها الإعلاميون مع مثل هذا المقترح، التزاحم غير الصحي الذي يحدثه من قبل من يدعي إلمامه ومعرفته بالإعلام، خاصة ممن بات يمارسه بأسلوب غير مستساغ البتة، ويصبح الكسر مضاعفاَ حين يزايد البعض رغم عدم معرفته على أهل الشأن.
إن مثل هذا الطرح ينبغي ألا يُفهم أنه يدعو إلى إقصاء أحد عن القيام بنشاط الإعلام ممن يمتلك القدرة على القيام ببعض وظائفه أو أحدها، بل على العكس تماماً، فهو مبني على الإيمان بأن الركيزة الأساسية لممارسة هذا النشاط والنجاح فيه يعتمد من حيث المبدأ على توفر المهارة لدى المنتمين إليه، ومن ثم تعزيزها وتوجيهها وفقاً للأسس المعرفية التي يفترض تهيئتها من قبل الكليات والأقسام والمعاهد المتخصصة المعتمدة من قبل المؤسسات المعنية التي تحوكم على الدوام مناهجها وكوادرها تبعاً لقواعد دقيقة.
إن الواقع الحالي للنشاط الاتصالي في كافة مجالات الحياة، يقرر بأن تخصص الاتصال والإعلام أصبح على المستويين المعرفي والمهني يمتلك منجماً مليء باللآلئ القيمة، التي ستمكنه إن أحسن استثمارها من الانطلاق نحو رحاب أوسع وفضاءات هائلة. وأن الاستمرار في التنقيب في المنجم القديم، والتردد في اقتحام المنجم الأكثر ثراءً هو ما يهدد هوية التخصص وكينونته.
ونختم بالقول، بأنه سيكون مؤلماً جداً أن تستفيد كافة التخصصات، والمجتمع مؤسسات وأفراداً من الفضاء الرقمي، ويتعرض أقرب التخصصات ونعني به الإعلام، لانتكاسة غير مبررة، في حال إخفاقه رغم أنه كان الأولى بتعزيز مكانته.