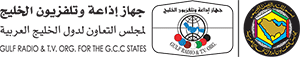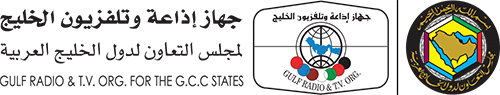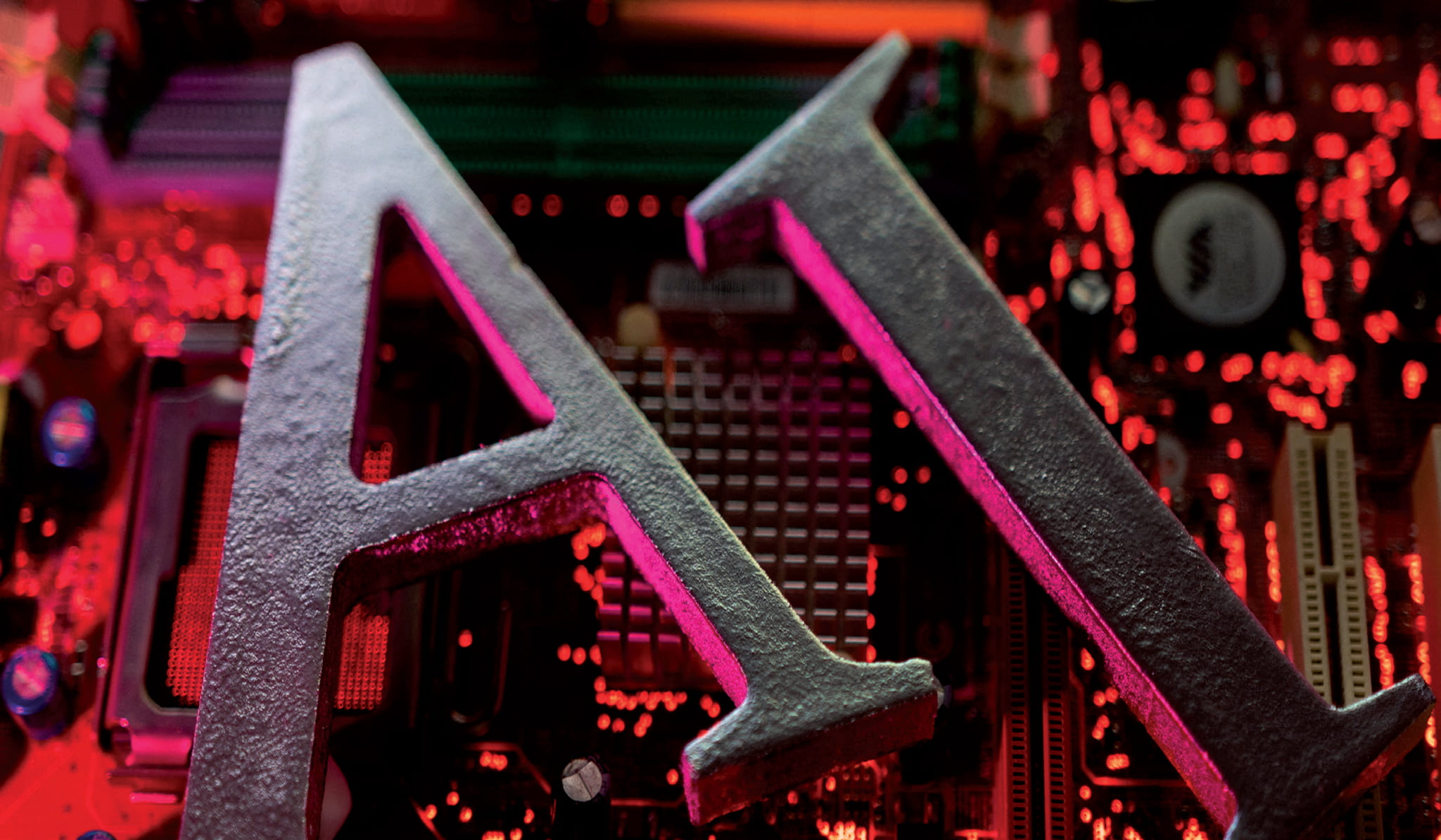يتساءل مسؤولو وسائل الإعلام التقليدية وملاكها: هل يشكل الذكاء الاصطناعي أداة لإنقاذها من أزمتها، التي تكمن أساسًا في تناقص عائداتها من الإعلانات بعد أن أصبحت كبريات شركات “الواب” تستحوذ على القسط الأوفر منه؛ وفي تراجع عدد المطلعين على محتوياتها بعد انصراف جمهورها إلى المنصات الرقمية؟
ويتساءل ممتهنو العمل الصحفي بقلق: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفكر؟ هل هو واعي بذاته؟ هل يمكن أن يقوم بالنشاطات الإنسانية التي يبدو أنه يحاكيها بشكل جيد، وبالتالي يتم الاستغناء عن خدمات البشر في قاعات التحرير؟
سعت وسائل الإعلام منذ نشأة كل وسيلة، بدءًا بالصحيفة، إلى تملك التكنولوجيا، فأصبح تطورها مرتبطًا بالاختراعات التكنولوجية المتتالية، بل مكونًا أساسيًّا من مكوناتها. إذًا لماذا كل هذا القلق؟
ما التكنولوجيا الذكية؟
يبدو أن الذكاء الاصطناعي مصطلحًا رجراجًا، بل غامضًا، خاصة عند شيوع تداوله في 2022م، حيث أضحى من الصعوبة بمكان حصر الواقع الذي يغطيه؛ بدليل أن مجلس الاتحاد الأوروبي طالب بتحديد الفروق القائمة بينه وبين ما سبقه من ذكاء جسدته تطبيقات الواب وخوارزميات الميديا الاجتماعية.
يرى الباحث شارلي بكيت، الأستاذ الجامعي ومؤسس مجموعة التفكير في الصحافة الدولية “بوليس” (Polis): “أن مصطلح الذكاء الاصطناعي يشمل طائفة من التكنولوجيا؛ منها التعلم الآلي، والآتمتة، وتحليل البيانات”.
وترى الكاتبة “تارا كيلي”: “بأن الذكاء الاصطناعي هو برنامج معلوماتي قادر على القيام بالمهام التي تتطلب عادة مستوى معين من الذكاء البشري”.
وبناءً عليه طمأنت الصحافيين وكل المتخوفين من مخاطر هذا الذكاء بالقول: “إن مختلف التجارب التي تمت لحد الآن في مجال الآتمتة لا تؤكد قط بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان، فكل ما في الأمر، أنه يغير في أسلوب العمل”.
ولتبسيط الفكرة أكثر، تؤكد بأن الذكاء الاصطناعي هو أداة تنجز العمل الذي لا يعجز الإنسان عن القيام به، بل يتطلب منه الكثير من الوقت والجهد والصبر.
مهما اختلفت تعريفات الذكاء الاصطناعي، فإنها لا تبدد قلق الصحافيين الذين تباينت مواقفهم منه، مثلما تباينت من التكنولوجيا التي سبقته، لعل البعض يتذكر قلق الصحافيين وتخوفهم وردود أفعالهم من ظهور شبكة الإنترنت، ثم من استخدام الجيل الثاني من الواب، ومواقع الشبكات الاجتماعية.
على العموم لم يتخذ الصحافيون وأرباب المؤسسات الإعلامية موقفًا موحدًا من الذكاء الاصطناعي، بل تباينت مواقفهم التي وصفها البعض بالغموض، الذي لا يختلف عن ذاك الذي طبع تعامل المؤسسات الإعلامية مع المبتكرات التكنولوجيا السالفة.
لقد لخصتها الباحثة “لورانس ديرييسكس”، من جامعة بلجيكا الحرة، في ثلاثة مواقف:
-الموقف القدري: الذي يؤمن بالحتميّة التكنولوجية، ويعتقد بأن الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة، إن عاجلاً أو آجلاً، وسيعمل على تعزيز المعايير المهنية السائدة.
-الموقف المتفائل: الذي يرى بأن الذكاء الاصطناعي يشكل رافدًا أساسيًّا لابتكار نوع جديد من الصحافة.
-الموقف المتشائم: الذي يرى أن الذكاء الاصطناعي سيتعارض مع قيم الإعلام وممارساته، ويشكل تهديدًا لمناصب العمل في المؤسسات الإعلامية.
من المبكر تقييم تجربة الذكاء الاصطناعي في قاعات التحرير في بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، لكن يمكن تحديد مجالات استخدامه، وهي: جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والاستعانة به في الإنتاج الإعلامي، وتوظيفه لبث وتوزيع الأخبار والمعلومات.
إنها المجالات التي أسهمت في ميلاد ما أصبح يعرف بالصحافة المضافة أو المزيدة (Augmented Journalism).
جمع البيانات وتحليلها
تستطيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي القيام بمهمة جمع البيانات بدقة شديدة على أوسع نطاق وفي أسرع وقت، ويمكن أن نوضح ذلك على سبيل المثال وليس الحصر بتقديم كشف كامل عن الموضوعات الأكثر تداولاً في مواقع الشبكات الاجتماعية والتي تبيّن اهتمامات الناس في بلد معين وانشغالاتهم واتجاهاتهم.
وتستغل وسائل الإعلام التقليدية هذا الكشف لتوجيه اهتماماتها نحو الموضوعات المذكورة، وتقوم التطبيقات المذكورة بقياس زوار موقع إخباري في شبكة الإنترنت أو متابعي “البودكاست” لهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، وتحديد خصائصهم الاجتماعية والثقافية.
إنه القياس الذي كان يتطلب القيام باستطلاع الآراء الذي يتطلب إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، والانتظار لأسابيع إن لم تكن أشهر حتى تُجمع البيانات ويتم تحليلها.
وبالرغم من أن ما يقوم به الذكاء الاصطناعي في مجال جمع البيانات وتحليلها، مثل قياس جمهور وسائل الإعلام، له إيجابيات عديدة منها تحرير وسائل الإعلام من تصورها المجرد لجمهورها، وتقديمه في حالته الملموسة، إلا أن هذا القياس لا يخلو من مخاطر، منها سجن الوسيلة الإعلامية في الصورة التي صاغتها عن جمهورها، فالقياس الآلي في هذه الحالة يعمق توجه هذه الوسيلة نحو إغراء جمهورها وسحره، بدل إعلامه وتثقيفه، وذلك لأن ما يقاس في حقيقة الأمر، هو النقرات على الرابط الرقمي الذي يؤدي إلى موقع الوسيلة في شبكة الإنترنت أو على أيقونة “الإعجاب”.
أما لماذا نقر؟ وما دلالات نقره؟ وسياقات النقر، فتلك مسائل أخرى.
الإنتاج
قدم الباحثان نيكولاس سنت جرمان، وباتريك وات من جامعة الكيبك بموريال بكندا، العديد من الأمثلة عن إسهام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار في قاعات التحرير، وأول هذه الأمثلة هو أتمتة إنتاج الأخبار، ويقصد بها المسار الرامي إلى تحويل البيانات إلى نصوص أو رسوم بيانية أو أي شكل من أشكال تمثيلها المرئي، فبعض قاعات التحرير سمحت لعُدّة الذكاء الاصطناعي بصياغة الأخبار الروتينية والمعتادة، مثل أخبار الرياضة والمال والبورصة، فتقوم بلَمِّ البيانات عن الموضوع وتركيبها في شكل خبر، هذا علاوة على استنساخ المقابلات الصحفية التي يجريها الصحافيون، ففي العادة كان الصحافي يقوم بتفريغ ما تم تسجيله بمسجله أو عبر الهاتف الذكي لحواره مع شخصية ما، وكان عملا مضنيًّا يأخذ منه الكثير من الوقت، الآن أصبح بإمكان تطبيق الذكاء الاصطناعي أن يقوم بذلك في وقت قياسي.
يبدو أن الذكاء الاصطناعي أبلى البلاء الحسن في مجال الترجمة، ويسّر العمل الصحفي ومنح الفرصة لمنتجه العبور إلى شعوب وأمم أخرى، فوسائل الإعلام المختلفة لم تعد تكتفي بالتطبيقات الخاصة بالترجمة المرتبطة عضويًّا بمحركات البحث المعروفة والموجهة للعامة، فسعى بعضها إلى اختراع عُدَّته الذكية الخاصة في مجال الترجمة، نذكر منهم، على سبيل المثال وليس الحصر، وكالة الأنباء الفرنسيّة التي ابتكرت برنامج “ترنسكريبر” (Transcriber)، ووضعته تحت تصرف صحافييها ومراسليها لنقل الأخبار إلى عشرين لغة، واتجهت وكالة الأنباء الكندية إلى اختراع برنامج مماثل، يسمى “ايلتراد” (Ultrad) للترجمة الآلية للبرقيات المكتوبة باللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية، سواء التي تنتجها الوكالة ذاتها أو تلك التي “تشتريها” من وكالات الأنباء الأجنبية، مثل “أسوسيتد برس”، ويقوم الصحافيون بمراجعة الترجمة، والغاية من هذه المراجعة لا تقتصر على الحرص على تفادي الأخطاء في نقل الأسماء والعبارات، بل في التصويبات والتدقيق، وإثراء سجل المترجم الآلي بالكلمات المناسبة والمرادفات الدقيقة، بمعنى مساعدة هذا البرنامج على التعلم من أخطائه.
البث والتوزيع
يعرض الباحثان المذكوران الأشكال المختلفة لتدخل عدة الذكاء الاصطناعي في إبراز المواد الإعلامية سواء في موقع الواب أو مواقع الميديا الاجتماعية، ويذكران على سبيل المثال الصحيفة الكندية الصادرة باللغة الإنجليزية، “ذو غلوب أند مايل” (The Globe and Mail)، التي ابتكرت برنامج “صوفي”، الذي قدم لها خدمات جليلة، ففضلاً عن رفع سمعتها في عالم الصحافة، وسع دائرة المطلعين على إنتاجها.
فـــ”صوفي”، ثمرة الذكاء الاصطناعي، يعمل بطريقة آلية على تحديث كل صفحات موقعها في شبكة الإنترنت وإعادة ترتيبه كل عشر دقائق! حسب عائدات كل مادة صحفية، بل يعيّن المواد التي يجب تبويبها في خانة تلك التي تتطلب دفع المقابل المالي للاطلاع عليها، وبفضل “صوفي” ازداد عدد المشتركين في موقعها بنسبة (51%)، ليبلغوا (170) ألف مشتركًا في 2021م، إنهم يساهمون بنسبة (70%) في تمويل الصحيفة؛ أي النسبة ذاتها التي كانت الصحيفة تحصل عليها من عائدات الإعلان.
إن بثّ الأخبار العاجلة عبر الهاتف في شكل رسائل نصية قصيرة أضحت ممارسة راسخة في القنوات التلفزيونية المتخصصة في الأخبار، لكن التلفزيون العمومي الفنلندي “يال” (Yle) تجاوزها وأصبح يقدم الخدمة ذاتها عبر رسائل صوتية قصيرة، إذ يتصل على أرقام هواتف المشاركين، فإن وجد استعدادًا واستجابة شرع في بثّ الخبر العاجل، وهذه الخدمة لا تتطلب من مالك الهاتف أي جهد سوى الاستماع، خاصة إن كان يمارس الرياضة أو يقود سيارته؛ أي إذا كان في وضع لا يسمح له بقراءة النص.
تحديات ومخاطر بالجملة
إن كانت هذه هي الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لوسائل الإعلام المختلفة وجمهورها، فما التحديات والمخاطر التي تواجهها مع جمهورها؟
لقد شعرت الهيئات الحكومية بمخاطر هذا الذكاء، مثل مجلس الاتحاد الأوروبي، والبيت الأبيض الأمريكي، فأصدرت اللوائح وصاغت التشريعات الرامية إلى تطويق مخاطره، ودفعت هيئات المجتمع المهني، مثل الهيئات الصحفية، إلى رسم الحدود التي يتطلب من المؤسسة الإعلامية عدم تجاوزها في استخدامها للذكاء الاصطناعي.
إن أكبر هذه المخاطر لا يكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي الرهيبة في اختلاق الأحداث والصور والفيديوهات التي تشبه الحقيقة إلى حد محو الاختلاف عنها، ولا في مقدرتها على التغلغل في تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص، بل في ضعف الأشخاص وقابليتهم لتصديق أي شيء يستثر عواطفهم في عصر ما بعد الحقيقة.
لقد عرّف قاموس أكسفورد في 2016م، هذه الحقيقة بالقول: “إنها صفة تشير إلى الظروف التي يكون للأحداث الموضوعية تأثير على الرأي العام أقل ممّا تثيره العواطف والمعتقد الشخصي”، هذا في ظل التنافس الرهيب بين شركات المعلوماتية.
فشركة “أوبن ايه آي” (Open AI) التي ظلت مؤسسة غير ربحية حتى عام 2019م، استفادت من استثمار يقدر بمليار دولار من شركة “مايكروسفت”، التي تريد إدماج مبتكراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في محرك بحثها “بانغ”، لتنافس الشركة العملاقة مالكة غوغل، وقد صاحب هذا التنافس تخلي العديد من مؤسسات المعلوماتية والإعلام عن تقديم خدماتها مجانًا، فالعديد من الصحف على سبيل المثال، مثل “نيويورك تايمز” سحبت أرشيفها المجاني، الذي شكل مصدر قوتها التنافسية، وأصبح الاطلاع عليه بمقابل مالي.
هذا التحول في البيئة الإعلامية التي أصبح الذكاء الاصطناعي أحد فاعليها الأساسيين دفع “جيف جرفيس”، الكاتب الأمريكي المختص في الصحافة الرقمية، إلى التساؤل بحيرة عن مصير المنظومة الإعلامية: هل سيصبح الحق في الإعلام مقتصرًا على من يملك القدرة الشرائية لدفع المقابل المالي لما “يستهلكه” من أخبار ومعلومات، وتترك بقية البشر فريسة للأخبار المزيفة والتضليل الإعلامي والدعاية! فأين هي مسؤولية الدولة في إعلام مواطنيها وتثقيفهم؟
صنف مجلس الأخلاقيات الصحفية والوساطة، الذي نشأ بفرنسا عام 2019م، كهيئة مستقلة للوساطة بين الصحافيين ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء والجمهور حول القضايا ذات الصلة بأخلاقيات العمل الإعلامي مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أصناف:
-الصنف الأول: يتضمن المخاطر البسيطة، والمتمثلة في قيام الآلة الذكية بالتدقيق اللغوي للنصّ الصحفي، وتصحيح أخطائه النحوية والصرفية، والترجمة الآلية للنصوص.
-الصنف الثاني: يشمل المخاطر المعتدلة؛ أي تلك التي تتطلب إشعار الجمهور، مثلاً بإنجاز بعض المحتوى الصحفي بواسطة الذكاء الاصطناعي بغية نشره وبثه، أو كل ما يعرض على الجمهور ويكون نتيجة ذكاء غير بشري، مثل ترجمة منتج صحفي إلى لغة أجنبية، كأن يكون النص الأصلي منشورًا باللغة الإنجليزية ويقوم الذكاء الاصطناعي بترجمته ليبث عبر قناة تلفزيونية باللغة العربية أو الإسبانية على سبيل المثال، وقيام الرجل الآلي “الروبوت” بقراءة النص الصحفي بدلًا من البشر، وتلخيص النصوص الصحفية أو شريط الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتدخل في تصنيف المنتج الصحفي وترتيبه.
-الصنف الثالث: فهو ذاك الخطير، الذي يتطلب من السلطات العامة ووسائل الإعلام حظره تمامًا، مثل نشر منتج إعلامي بواسطة الذكاء الاصطناعي كاملاً، أو بث أخبار دون مراقبة الصحافيين ومراجعتها، فالمؤسسة الإعلامية مسؤولة عمّا تنشر وتتحمل تبعاته إن تضمن أخطاء أو خالف ما تنص عليه قوانين الإعلام، ونشر الصور والفيديوهات والأخبار التي تحدث الغموض والبلبلة لدى الجمهور، والادعاء بصحتها على الرغم من تناقضها مع الواقع.
ما أشبه اليوم بالبارحة
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مع وسائل الإعلام التقليدية، لقد خاضت الصحافة حربًا ضروسًا ضد الإذاعة وصحفيها في بداية نشاطها، إذ اتهمتها بأنها تعيش عالة عليها، وتستغل جهدها دون مقابل مالي، ويذكرنا الكاتب الأمريكي “جيف جرفيس” باتفاقية “بلتمور”، المبرمة في عام 1933م، بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي هدد فيها ناشرو الصحف بالتوقف عن طباعة برامج البث الإذاعي، وأرغموا المحطات الإذاعية على الاكتفاء ببث موجزي أنباء في اليوم، وشراء الأخبار التي يبثونها من وكالات الأنباء، والامتناع عن التعليق على الأخبار والأحداث إلا بعد (12) ساعة من حدوثها، ولم يكتف الصحافيون بهذا، بل ذهبوا إلى حد طرد صحافيي الإذاعة من دخول قاعة الكونغرس الأمريكي، ومن التظاهرات السياسية والثقافية.
تجدّد الاتهام ذاته لمحركات البحث، خاصة “غوغل نيوز”، فالصحف لم تر فيه المنافس الشرس مثل الإذاعة؛ لأنه لا ينتج أخبارًا تنافسها، بل يستغل منتجاتها، إذ يحيل إلى منشوراتها ويجني من خلالها أموالاً طائلة نتيجة حصوله على عائدات الإعلان، وقد وصل الخلاف بين نقابة ناشري الصحف وشركة “غوغل” إلى أروقة المحاكم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وانتهى في الغالب إما بترضية نقابة ناشرين الصحف بعشرات الملايين من الدولارات لترضيتها والسماح لها بالإحالة إلى عناوين موادها الصحفية، كما هو الشأن مع نقابة الناشرين البلجيكيين، أو الكف عن الإشارة إلى عناوين الصحف في شريطها الإخباري، كما حدث مع الصحافة الإيطالية.
بعد وصول الخلاف بين صحيفة “نيويورك تايمز” ومؤسسة الذكاء الاصطناعي، “أوبن ايه آي” (Open AI) إلى أروقة المحاكم، أصبحت جلّ الصحف مطالبة اليوم بتبني إستراتيجية لتسوية الخلاف مع المؤسسة ذاتها حول اقتسام القيمة المضافة التي تجنيها من جمع بياناتها واستغلال منشوراتها، وبالتالي الحفاظ على حقوق صحافييها.