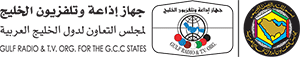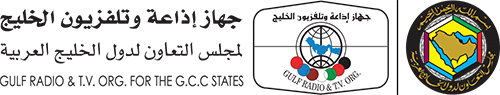كان تخصص الإعلام، أو ما يسمى بـ “الاتصال الجماهيري” إلى وقت قريب، هو النشاط الأكثر بالاهتمام والدراسة بين بقية أنواع الاتصال “الشخصي والجمعي”، إذْ انفرد لمدة ليست بالقصيرة بنقل الأخبار، وتسيد مصادر نشر المعلومات حول كل جديد على نحوٍ جعله الأداة الأبرز في تشكيل الصور الذهنية وتعزيزها، فمارس هذا الدور بقوة، ليس لصالح الأفراد والجماعات فحسب، بل وحتى للدول والمؤسسات، وكان مما ساعده في ذلك حقيقة مفادها أنه كان استحوذ على أهم أدوات وأساليب الاتصال المستقلة والنافذة، وقاده في ذلك متخصصون (الإعلاميون) متمكنون وبارعون في كيفية التعامل معها، وعزز من نجاحهم وتفوقهم نشأة مؤسسات تعليمية تبحث في هذا الفن وتُدرِّس وتُدرِّب الملتحقين بها، لتؤهلهم وفق مهارات نوعية قادرة على جذب الجمهور والتأثير فيهم.
إن مما تستوجبه محاولة التعرف على كنه التحول الجذري في عالم الاتصال، النظر إليه من خلال وجود فضاءين أو عالمين مستقلين وفقاً لسمات وخصائص متفاوتة، وتشكل كل واحدة منهما مرحلة مهمة في تاريخ الاتصال، يتم في ضوءها الحكم على طبيعة الوسائل بما في ذلك الإعلامية.
الأول: دائرة الفضاء التقليدي، وهي المرحلة التي بدأت منذ اختراع المطبعة، وما تبعها من ابتكارات إعلامية شملت السينما، والصحافة، والإذاعة والتلفزيون، حتى مرحلة استخدام الانترنت من قبل العامة في تسعينات القرن الماضي، ولعل أبرز سمات هذا الفضاء هو أن عدد مستخدميه كان محدوداً جداً، نذكر منهم: شركات الاتصالات، وسائل الإعلام، والمؤسسات الأمنية.
الثاني: دائرة الفضاء الرقمي، وتؤرخ بفترة نهاية المرحلة الأولى، وبالرغم من استفادتها من نظيرتها السابقة في بعض أسسها بناءً على تراكماتها، إلا أنها غدت فريدة في خصائصها، واستطاعت ابتلاع معظم وسائلها، وتقديمها بشكل مختلف، وأكثر فاعلية، ذلك أن بزوغ نجم الشبكة العنكبوتية “الانترنت” قاد إلى تطور تقني غير مسبوق، خصوصاً مع اندماج خاصيتها الاتصالية مع حقل المعلومات، وتمكنها، على نحوٍ غير مسبوق، من نسج خطوطها على كوكب الأرض، وفتح الأبواب، على حين غرة، لأفراد المجتمعات ومؤسساتها دون استثناء للدخول في محيطها، وهو ما هيأ أفقاً فسيحاً ومتعدداً، يختلف جذرياً في سرعته وتجدده ومرونته عن سابقه، ولم يكتف بهذا الفتح إلى عوالم غير متناهية؛ بل مكن أولئك الأفراد والمؤسسات من الإفادة من جميع أدواته، كما منحهم المساحة الكافية للابتكار وتقديم أشكالٍ متنوعة من المواد حفزت كافة فئاتهم، وفتقت لديهم روح الإبداع والعطاء المتواصل، لتتغير بذلك قواعد اللعبة، وتتسبب في مشهد تراجيدي ومأساوي في اختفاء الكثير من الوظائف والأنشطة، وفي تقليص الحاجة لموارد بشرية ضخمة، أو لاستخدام آلات وأجهزة ذات أحجام كبيرة، أو حتى لمساحات مكانية واسعة، لم يكن يتم إنجاز وظائف النشر الجماهيري بدونها.
مزاحمة وإزاحة
هذا التحول أدى إلى مزاحمة القادمين الجدد لأصحاب تخصص الإعلام في صنعتهم، واستطاعوا بفضل الخصائص التي احتواها الفضاء الرقمي، أن يجتزئوا الكثير من مهامهم ويقلصوا الحاجة إلى وسائلهم، وكانت المفاجأة الأكبر، أن تمكن بعض ممن استثمر قدراته الفطرية، وعمل على تطويرها، أن يتفوق على بعض تلك الوسائل في مقدراتها، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قدرة العامة على تحقيق قصب السبق في نشر الأخبار بصورة فورية، وهي الخاصية التي أدت إلى احتراق ميزة كانت شبه خاصة بوسائل نشر الإخبار.
كما أن هذا التغير الجذري أدى إلى تعرض معظم مقدرات تخصص الإعلام ومؤسساته إلى ضعف جلي، وإلى فقدانها لقيمتها، وعجزها عن الإسهام في تشكيل الرأي العام كما كانت تفعل، الأمر الذي أدى بسبب هجر السواد الأعظم من الجمهور لها، إلى انصراف المعلنين الذين هم مصدر تمويلها الرئيس عنها، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الانهيار هائل للعديد من المؤسسات الصحفية على مستوى العالم، وكذا خسارة الآلاف من الإعلاميين (رؤساء التحرير والمحررون والكتاب والفنيين في الصحف) لمواقعهم، نتيجة تجاهلهم للتهديد الذي كان يحوم حولهم على مدى قرابة عقدين كاملين، وحتماً عجزهم، وهم الذين تخصص معظمهم على مدى سنين طويلة في قراءة الظواهر بكافة أنواعها، والنقد المجتمعي، والتحذير من مواطن الخطر ومصادره.
وفي ذات الإطار، بات الإعلام نفسه في ثوبه التقليدي، وفي ظل التحولات المربكة، شبه عاجز عن حماية صورته الذهنية أو إعادة تشكيلها كما يجب، الأمر الذي يحتم على من يريد المواكبة والتطوير، أن يقرأ بتمعن واقع الفضاء الاتصالي الرقمي المختلف شكلاً وسمات في نماذجه وأدواته، من خلال تأمل تفاصيله وانعكاساتها على المهن الاتصالية، وكذا المهن الأخرى بشكل عام التي بات الاتصال جزء من مكوناتها، ومن ثم العمل على إعادة هيكلة بنائه في كلا حقليه المعرفي والمهني، بغرض الخروج بشخصية تخصص متكامل، يواءم متطلبات المرحلة، ويحقق أهداف الاتصال بشموليتها، ولا يحصر ذاته في مسار واحد فحسب.
إن مما يفرض ذلك على تخصص الإعلام بوجه خاص، أنه بات وفقاً لآلياته السابقة، يعيش حالات ضعف يشبه الموت الذي يوكده التراجع الهائل في واقع وسائله، ولا أدل على ذلك من تلاشي معظم سماته على نحوٍ أصبح القائمون على مؤسساته التقليدية يبحثون في كيفية الحفاظ على مكانتهم، واضطرارهم للجوء إلى حلول مؤقتة هشة، لا تظهر وجود مبررات مقنعة أو أنها ذات جدوى لخدمة المهنة أو إنعاشها، منها على سبيل المثال الاستثمار فيما تبقى من مدخرات المؤسسات، كتأجير مقرات الصحف لتسيير الوضع الراهن فقط، وليس لتطويره، ومعالجة أسباب الضعف والتقهقر.
هل انتهى عصر الإعلام؟!
ربما يكون السؤال المطروح في ضوء تلك المقدمة هو: هل دنت شمس تخصص الإعلام من المغيب؟!.
الإجابة المباشرة عن هذا السؤال هي النفي تماماً، وينبغي ألا يعد تواني الممارسين للإعلام في الفضاء التقليدي، أو عجزهم عن المواكبة، أو حتى توقفهم عن المهنة مؤشراً على نهايتها، والحكم يجب أن يؤسس على أسباب نشأة الإعلام نفسه؛ إذ أنها جاءت تلبية لمتطلبات غريزة البحث عن الأخبار، التي وُجِدت لدى الناس منذ بدء الخليقة، وستبقى كذلك إلى نهايتها، فقد مارسوا مهمة الحصول عليها في مستهل تلك الحقبة عبر أدوات بدائية استطاعت أن تلبي إلى حد ما رغبات الأفراد والمجتمعات وتشبع فضولهم، ولأهمية تلك الحاجة نمت تلك الأدوات، وتطورت في أشكال متعددة تمكن من خلالها الانسان أن يوسع دائرة جمهور المتلقين، كما عمل على مضاعفة أعدادهم، ليتجاوز الحدود المكانية الضيقة إلى رحاب أوسع، موظفاً في مرحلة النمو والتطوير عدداً من الأساليب الجمالية والمعبرة لتحقيق غاياته.
وبالرغم من النقلات النوعية التي تحققت، إلا أن الواقع يفرض الاستمرار في تطوير الأدوات والأساليب، والاستغناء عما لم تعد الحاجة لها قائمة، خاصة في ظل التغيرات التقنية الكبيرة، وستبقى الحاجة مستمرة إلى إعادة تقييم الواقع وتغييره وفقاً لطبيعة الاحتياجات التي يمكن أن توفرها تقنية الاتصال المطورة وتبعاً لآليات التشغيل الميسرة.
واستناداً على مبدأ الحاجة هذا، نستطيع القول أن الاعتقاد بأن الإعلام أصبح مجرداً من وظائفه أو أنه خسر خصائصه الجوهرية، هو حكم متسرع، ولا يمكن قبوله على إطلاقه، فهو لا يزال، وسيبقى عبر أدوات وأساليب متجددة، النشاط الأقدر على الوصول إلى مواقع الأحداث والأماكن المقيدة في حالات لا يستطيع الآخرون بلوغها لأسباب قسرية، أو رسمية، فالبقع الساخنة نتيجة الحروب أو الكوارث هي أماكن لا يجرؤ- في الغالب- أحد من العامة على اقتحامها، ليصبح إنجاز المهمة شبه محصور على العاملين في مهنة المتاعب، فهم يكلفون من قبل مؤسسات متخصصة للوصول إليها، لينقلوا للعالم الحدث ويصفوا ملابساته.
وغني عن القول بأنه حتى وإن تمكن مستخدمو بعض وسائل التواصل الحديثة من الوصول إليها، فإنهم، ومهما بلغت أعدادهم، أو جهودهم لا يمكن أن ينالوا الثقة كما هو الحال مع وسائل إعلامية قوية ترجح كفة تفوقها، وتراهن على قدراتها في أن تبقى مصدراً مهماً يعتد به دون سواه، وهو ما يمكن ملاحظته مع واقع وكالات الأنباء العالمية التي استطاعت الصمود، واستفادت بقوة من خصائص الفضاء الجديد ومزايا أدواته.
هذا الأمر يقود إلى القول بأن وسائل الإعلام ستبقى متصدرة المشهد في تغطية الأحداث الرسمية والجسام، في حين أن قدرات غيرها مثل منصات التواصل الاجتماعي، فتظل محصورة في فئات محدودة من الجمهور، وفي إطار الأخبار الشخصية أو المجتمعية.
وبناءً عليه، فإن الوصول إلى الشكل الجديد للإعلام المطور، يفرض أن يتم في ضوء طبيعة نظرة الأفراد إلى هذا النشاط، ليس بوصفهم متلقين فقط، ولكن بوصفهم شركاء بعد أن غدوا مساهمين في صناعة المحتوى ونشره.
إن الإصرار على أن وسائل الإعلام لم تتأثر سلباً بالتغيرات التي طرأت عليها، هو موقف يستند أحياناً في واقعه على قياس قبل عقود لطبيعة التطورات التي كانت تحدث في إطار الفضاء التقليدي، وبالتالي فإنها تنطلق في رؤيتها من قاعدة تصدق على أدوات كل فضاء على حده، وليس على فضاءات متعددة، ففي كل فضاء يعد التغير في شكل الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى توفير بديل أفضل عن سابقتها، فابتكار شريط الكاسيت على سبيل المثال لم يكن سوى بديلاً عن الأسطوانة الممغنطة آنذاك، كما أن التحول من جيل الصحفيين الرواد، من فئة المثقفين والأدباء، الذين مارسوا العمل الإعلامي، في بدايات الصحافة في العالم العربي، إلى جيل جديد متخصص تعلم الأساليب المهنية للصحافة، بناءً على مفهومها الحقيقي، ووفقاً لأسس وقواعد ممارسة العمل الصحفي وطبيعته، حالة أملتها فترة استثنائية عابرة بسبب الحاجة إلى متمكنين في صياغة الرسائل التي كانت هي محور النشاط الإعلامي حينئذٍ.
هذا التبادل في أشكال الوسائل وأدوار الممارسين، يوجب التخلص من التفكير بمنطق الماضي، إذ لا يمكن قبول فكرة الاعتقاد بأن وسيلة اتصالية بعينها من فضاء رقمي، جاءت بديلة عن وسيلة أخرى من الفضاء التقليدي، بمعنى أنه لا يصح التخمين بأن منصة الفيسبوك التي هي إحدى منصات التواصل الاجتماعي -على سبيل المثال- قادرة على أن تحل تماماً محل الصحف التقليدية، إذ إن تحولات الاتصال الجديدة تختلف في النماذج عما كان عليه نماذج الفضاء التقليدي؛ ولا أدل على ذلك من أنها عَرَّفت بمتغيرات مؤثرة في صناعة الإعلام لم تكن متوفرة في السابق، في مقدمتها التفاعلية، والرقمنة.
ملامح الإعلام الجديد وكيفية هيكلته
إن معالجة أية ظاهرة يعتريها الضعف، أو يصيبها الوهن كما هو الحال مع نشاط الإعلام وصناعته في الوقت الراهن، يستدعي -كما ذكرنا- تشخيص واقعه الحالي، ومعرفة مراحل تغيره، مع البحث في أسباب تراجعه، وكذلك العوامل المؤثرة في الحالة بموضوعية تامة، مع العمل على تحديد عناصر القوة والضعف، وبالرغم من أن هذا القول يستدعي التخلي عما لم يعد ضمن نطاقه، كما يستدعي استيعاب ما يجب استيعابه، وإدراجه في ضمن محيط مهامه المحدثة.
وبناءً على هذه القاعدة، فإنه يجب الاعتراف بأن إعلام الأمس، لم يعد تماماً إعلام اليوم، لا من حيث وسائله، ولا من حيث ممارسيه، فصناعة الإعلام مرت بمرحلتين وفقاً لفضاءات الاتصال سابقة الذكر، مرحلة إعلام ما قبل الانترنت (الفضاء التقليدي)، وما بعدها (الفضاء الرقمي)، وأن الأولى شهدت عصراً ذهبياً لوسائل رائدة امتلكت قدرات فعالة في صناعة الرأي العام، وتشكيل اتجاهاته، والقدرة على استقطاب جمهوره، ساعدها على ذلك استئثارها بمنابر الاتصال الجماهيري دون أن تشاركها وسائل أخرى.
أما المرحلة الثانية، فقد شهدت ولأول مرة دخول منافسين جدد للوسائل، وهذا يوجب تقييم عميق ودقيق لطبيعة المنافسة والتخلص مما لم يعد خاصاً بها، مع العمل على الإفادة من مجالات دائرة الاتصال الرقمي التي أصبحت أكثر سعة، وباتت توفر خيارات تفوق ما كان متاحاً قبلها، وهذه المرحلة غدت تملي التخلص من البناء التقليدي للاتصال من حيث الأنواع والخصائص، أخذاً بالاعتبار أن الفضاء الرقمي الحالي أصبح يوفر كل أنواع الاتصال الثلاثة أو إثنين منها في وسيلة واحدة، فمن شبكات التواصل ما يعطي خاصية الاتصال الشخصي، كما يوفر خاصية الاتصال الجمعي، عبر إمكانية إنشاء مجموعات تسمح بممارسته من خلال توجيه الرسائل لحشود محددة، كما هو الحال مع منصة الواتساب، كما أن بعض تلك المنصات يوفر خدمة مخاطبة الجماهير الغفيرة دون حد معين لأعدادهم، مثل منصة الفيسبوك ومنصة X.
ماذا بقي للإعلام؟
في خضم هذه التحولات الكبيرة، يخطئ من يظن أن وسائل الإعلام أصبحت مجردة من وظائفها أو أنها خسرت خصائها الجوهرية، فهي لا تزال الأداة الأقدر على الوصول إلى مواقع الأحداث والأماكن في حالات لا يستطيع الآخرون لأسباب قسرية، أو رسمية الوصول اليها، كما هو الحال مع البقع الساخنة نتيجة الحروب أو الكوارث. ومن هذا المنطق فإن الواقع يقرر ضرورة العمل على تطوير النشاط الإعلامي بما يتواءم مع طبيعة التغيرات التي تشهدها ساحته، والبحث عن الفرص التي قد تتضمنها البيئة الجديدة.
خارطة طريق إلى الإعلام المطور
لابد من الاعتراف سلفاً بأن العمل على إعادة بناء تخصص الإعلام لا يمكن أن يتم إلا من خلال النظر إليه على أنه مشروع متكامل، يتطلب التخطيط السليم له من حيث وضوح الأهداف، ويحتاج إلى توافر الأدوات البشرية والبحثية التي تعين على التعرف على ما يحتاجه التخصص من الفضاء الجديد، والكشف عن مواطن التميز والتفرد اللذين أشرنا لهما سابقاً، ولاشك بأن هذا المشروع بحاجة إلى أصحاب الرؤية الشمولية والخبرة العميقة التي تعين على تحديد مكونات الصناعة الإعلامية وأدواتها المناسبة، مع القدرة على رصد جوانب التغيير، وفحص سمات الشركاء الجدد الذين دخلوا مع وسائل الإعلام في بعض مهامها، ليس لسلخ تلك المهام من التخصص، وإنما للتحقق من تمكنهم بالفعل من أداء الوظائف الإعلامية بالشكل المهني، واعتبارهم شركاء بناءً على قدراتهم، ومدى الحاجة لأدوارهم وجدواها، مع الحذر من فكرة العمل على الإقصاء، التي يستند أصحابها على معايير تقليدية لم يعد لها وجود.
لذا لابد من التنبه إلى أن الخوض في مهمة إعادة هيكلة التخصص، يوجب التحذير من إطلاق الأحكام جزافاً حول ما يعد خاصاً بالإعلام أو ببدائله، كما أن الواقع يملي القول بأن على الإعلام -بمفهومه السابق- التخلي من بعض مهامه لصالح أدوات أكثر مهنية في سرعة نقل المعلومة ونشرها بأشكال جديدة وفعالة، من بينها القدرة على القيام بمخاطبة فئات محدودة تتم وفقاً لأساليب الاتصال الشخصي والجمعي.
وعليه فإنه لابد من تأمل المتغيرات المتداخلة والبالغة التعقيد في الفضاء الرقمي، بنظرة فاحصة، والعمل على البحث في العلاقات بين عناصرها، وتحديد مدى قدرتها على الإسهام في الحصول على أية نتائج مثمرة تلبي الاحتياجات الاتصالية المجتمعية، وذلك من أجل بناء متكامل لتخصص أشمل قادر على أن يمثل الاتصال والقبول بحقيقة التداخل الطارئ على التخصصات، مثل الإعلام، والاتصال بنوعيه الشخصي الجمعي، والتسويق والعلاقات العامة، ولعل أولى الجهات عناية بهذا الجانب مؤسسات تعليم الاتصال، وتحديداً كليات وأقسام الإعلام، التي بات عليها – بعد أن أصبح الإعلام جزءً من مجموعة فنون اتصالية جديدة – أن تعيد النظر في مسمياتها، وتعنى بتدريس جميع تلك الفنون، ولعل التسمية المقترحة الأنسب لها أن تستبدل مصطلح “الإعلام” في مسمياتها بـ “فنون الاتصال”.
وفي هذا الإطار الجديد، فإن على تلك المؤسسات في ثوبها الجديد أن توسع دائرة خدماتها، لتغطي جميع الاحتياجات ذات الصلة بالاتصال، وهو ما يتطلب:
- العناية بتعليم مهارات الاتصال بكافة أنواعه، لجميع مستخدمي وسائل الاتصال الرقمية، بما يعين على الارتقاء بقدراتهم على المستوى الشخصي أو الوظيفي، على أن يشمل هذا جميع العاملين في كافة المهن المكتبية أو الميدانية.
- التعريف بمقررات تخصصية تتناسب مع طبيعة الاتصال الرقمي، الذي عَرَّف بأشكال جديدة في طريقة اعداد المواد الإعلامية، ومن ذلك إعداد الأفلام الموجزة (Promos)، مع مراعاة العوامل المهنية المؤثرة في إنتاجها.
- الاهتمام بدعم قدرات الدارسين لفهم علم الدلالات، وكيفية توظيفه في صناعة الأحداث والفعاليات، واستثمار رمزيات المعالم؛ لتجسيد رسائل اتصالية مؤثرة وفاعلة، وذلك على نحوٍ يحفز مستخدمي المنصات المجتمعية الرقمية لنشرها على نطاق أوسع، ويمكن الاستشهاد على أهمية هذا بفكرة هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الرائدة، حين نقلت ثلاث طائرات عبر الطريق البري من جدة إلى العاصمة الرياض، في تظاهرة احتفالية كبيرة حققت تفاعلات قوية لدى الجماهير بمختلف فئاتهم، شملت سكان المحافظات والمراكز والقرى التي مرت بها قافلة تلك الطائرات.
- تعزيز العلاقة بين تخصص الاتصال والتخصصات البينية الأخرى، بما يعين على تحقيق الفوائد المتبادلة، مع العمل على تعزيز ثقافة احترام التخصصات، وتقدير حجم إسهاماتها في تقوية التخصص.
- التركيز على المقررات العملية، واعتماد معيار “مدى الصلة بالاتصال الرقمي”، منهجاً لاعتماد الخطط التعليمية، وتكثيف التطبيق والممارسة في ذات الإطار؛ لضمان فهم وتنمية المهارات اللازمة لدى الدارسين، مع تقليل الاعتماد على المقررات التي انبثقت من تراكمات معرفية تقليدية، وعدم التردد في حذف ما لا يقدم قيمة مضافة في ضوء البيئة الجديدة.
- الاهتمام بقواعد البيانات الإعلامية، وسبل تطويرها، وكذلك طرق استدعاء موادها وأساليب التوظيف المباشر في النشر، وتنمية قدرات الطلبة في كيفية التعامل معها، مع ضرورة التخلص من الأساليب القديمة في حفظ المعلومات مثل ما يسمى بـ “مكتبة الصور”، أو الأرشيف.
نختم بالقول بأنه قد آن الأوان لوجود كيانات تعليمية اتصالية عصرية، تستطيع أن تستوعب الممارسين الجدد في محيطها، خاصة بعد أن أصبح الاتصال الرقمي جزءً من ثقافة أفراد المجتمعات ومؤسساتها، مما يوجب تقديم خدمات تطويرية لقدراتهم المعرفية والمهنية، بما يمكنهم من الممارسة الفاعلة في مجال التخصص، مع تذكر أن التقصير في القيام بهذا سيؤدي إلى بحثهم عن جهات وأساليب بديلة قد تعيد اختراع العجلة في فهم الاتصال، وهو ما قد يؤدي إلى سحب البساط من تحت أقدامها.