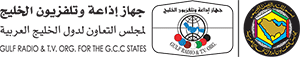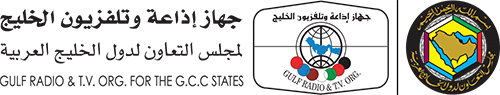إذا كانت المعلومة الجديدة عن حدثٍ ما، تُنعت بـ “الخبر”، الذي هو أساس “الإعلام”، فإن قيمتها الحقيقية لا تنتهي عند ذلك الحد، وإنما تتجاوزه إلى ما هو أكبر وأعمق؛ فهي جوهر لا يمكن أن يخفت بريقه ويطويه النسيان طالما حُفِظت في قواعد المعلومات ودونتها سجلات التاريخ؛ ذلك أن المعلومة تنتقل من كونها سلعة مهمة لدى فئات الممارسين لمهنة الإعلام، إلى أن تصبح مادةً نفيسة لدى دارسي “التاريخ” والمهتمين به، وربما زاد ثراؤها عبر الزمن، لترتقي إلى مكانة أعلى يختص بها علماء الآثار والمتاحف.
ووفقاً لهذا المكانة القيمة يقرر الواقع بأن “إعلام الأمس هو تاريخ اليوم، وربما آثار الغد”.
وبناءً عليه فإن القاسم المشترك بين المنتسبين لهذه التخصصات، هو محتوىً ثمين يشكل مادة مطلوبة من قبل المتلقين، وأن معظمه سيبقى رصيداً يعني الكثير للأفراد والشعوب والدول، خاصة إذا كانت موضوعاته تتمحور حول أحداث مفصلية عن تلك الأمم وقادتها ومقوماتها، فهي توثق لمحطات جوهرية في مراحل نموها وتطورها.
نحو استثمار أمثل للمعلومات:
بالرغم من أنه قد يُفهم من تلك المعادلة الثلاثية الأطراف، بأن تحول المادة من تخصص لآخر هو انتقال حاد للمحتوى، يصنع الاستقلال لكل طرف ويمنع التداخل بينها، فبعد أن ينتقل من عهدة الإعلام، يُنقل – كما يُظن – بطريقة حصرية إلى خزائن التاريخ، ومن ثم -وإن كان نادراً- إلى مدافن الآثار في حال فقدانه، وأن ذلك التحول يرسم حدوداً بينية، تنتهي إلى قطيعة بين هذه التخصصات، إلا أن الحقيقة التي يفترض العمل بموجبها أنها جميعها بحاجة ماسة لبعضها البعض؛ وأن الإبقاء الدائم والمتجدد على خطوط الصلة كفيل بأن يمكّن كل طرف من أداء مهامه ومسؤولياته بطرق أفضل وعلى أكمل وجه، فاسترجاع الماضي بأقصى تفاصيله، وعرضه بأسلوب يحاكي كيفية حدوثه بدقة، هو الأسلوب النموذجي لاستحضاره والإفادة منه على نحوٍ يخدم كل الأطراف بصورة مهنية رفيعة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الجميع، بحيث يتم الانتقال إلى أساليب عصرية تقدم الأحداث وشخوصها، بأشكال مبهرة تقربنا للواقع، وتختلف عن طرق التدوين والكتابة التقليدية التي اتُّبِعت لقرون عديدة في حفظ تاريخ الأمم على مر العصور، وبالتالي فإنه قد آن الأوان لإخراجها من أوعية التعليب إلى عالم ينبض بالحياة؛ لتنقلنا إلى الواقع الافتراضي في أدق صوره.
هذه الحقيقة تقرر بأن قيمة المعلومات قد علا شأنها مع تطور تقنيات الاتصال أكثر من ذي قبل، وغدت منجماً ثرياً متجدداً يستحق المزيد من الاهتمام في طريقة تعدينها وتشكيل نتاجها، وينبغي أن ألا تتوقف في محطة بعينها، بل لا بد من استثمارها، وتدويرها بالصورة التي تبقيها جاذبة وقادرة على إحداث الأثر المطلوب على كافة المستويات، بما في ذلك – وهو مهم للغاية – تقديم ثقافات الشعوب، وتعزيز الصورة الحقيقية للأمم، وأن تقادمها يضاعف ثراءها وجمالها، خاصة إذا ارتبط موضوعها باهتمامات المجتمعات وأفراده عبر الأجيال، ولعل مما يؤكد ذلك ويجسده، حجم الفرحة التي تعتري علماء الآثار عند اكتشافاتهم لموروث الأولين ومقتنياتهم، ليمتد الاحتفاء إلى القائمين على المتاحف في أشكال متنوعة، تبرز أهمية الصلة بين البشر عبر الحضارات المتعاقبة، وذلك على نحوٍ يجعلنا نأسى على الكم الهائل من تاريخ البشرية الذي فقدناه مقارنة بحجم الأحداث التي لا نعرف منها سوى النزر اليسير.
إن إدراك أطراف التخصصات الثلاثة لقيمة كل طرف في الارتقاء بصنعتهم، وتقديرهم لها القائم على الاحترام المتبادل، شرط أساس لتحقيق أهدافهم، وحري بتعزيز الأدوار التكاملية، وهو ما يوصل إلى ثمارٍ غنية في حال حاجة الأمم إلى تقديم مواد “وثائقية” عميقة تتجاوز المهام التي اعتاد أصحاب كل تخصص على القيام بها بصورة شبه منفردة، وتكون في معظمها مبتورة في العرض في ظل غياب التكامل، والأخطر من ذلك أن الانفراد في الطرح لا يقدم في غالب الأحيان إلا جزءً من الحقيقة، الذي يقصِّر كثيراً في وصف الأحداث.
إن شرح تفاصيل المشروع التكاملي في توثيق وتجسيد الأحداث، وأدوار المتخصصين في الإعلام والتاريخ والآثار، وربما غيرهم من التخصصات فيه، هو بحد ذاته مشروع بحثي يستحق العناية والاهتمام، ولأن المساحة محصورة، فإننا سنقصر الحديث هنا على جزئيتين سريعتين من مهام الإعلام في نشاط التوثيق، فهو في جزء منه أصبح يغذي التاريخ بتوثيقه الفوري للأحداث والوقائع بأشكال متعددة منها المكتوب والمسموع والمرئي، وفي مهمة أخرى غدا هذا التخصص الحديث نسبياً وسيلة فاعلة وغير مسبوقة لإحياء التاريخ، وهو ما يشهد به -على سبيل المثال- المتابع للأفلام الوثائقية، سواء التي سجلت الأحداث في حينها، أو المسلسلات الدرامية التي تستمد محتواها من القصص الاجتماعية، أو تعيد تمثيل الماضي وتجسد أبرز شخصيات التاريخ.
شح في المهارات لا شح في النص:
لعل من نتائج القطيعة بين التخصصات أن يردد بعض فناني الدراما من وقت لآخر الحديث عن معاناتهم من غياب النصوص الجيدة، وأن ذلك يشكل عائقاً نحو تقديم المزيد من الأعمال، وهي معضلة لا يمكن قبولها فيما يتعلق بغياب القصة المتكاملة في احتياجات الإنتاج من حيث الحبكة وعناصر العقدة والمفاجأة والإثارة، إذ إن الاستماع لكبار السن، ورواد المجالس من الرواة ومحبي القصص، كافٍ للقول بأن هناك وفرٌ في هذا الجانب لم يُحسَن استثماره، والواقع أن السبب الحقيقي هو عدم وجود من يحسن إعداد تلك القصص وهندستها في إطار سيناريو يضمن توزيع الأدوار بصورة فنية عالية، والإبقاء على تعلق المشاهد بمشاهد الفيلم أو المسلسلة.
هذا يقودنا إلى القول إنه من غير الإنصاف الاعتقاد بان الإعلاميين يمارسون مهنتهم بنفس المستوى مهارةً أو عطاءً؛ فالسواد الأعظم في مجال النشر – على سبيل المثال – يندرجون ضمن الفئة التي تمارس تحرير الأخبار أو نقلها، أو كتابة المقال، أما أكثر فئات الإعلاميين تميزاً في المهارة والعطاء رغم تواريهم عن الأنظار، فهم أولئك الذين يجيدون التوثيق وبخاصة منتجو الأفلام الوثائقية، التي قد تكون أغلى أنواع الإنتاج الإعلامي كلفةَ، وأصعبها في التعامل مع متطلباتها، خاصة ما يتعلق منها بالجانب المهاري، والقدرات الفنية المفعمة بالحس المرهف على تقريب واقعها للمتلقي، وهو ما يفسر وجود مواد في غاية الدقة لعنايتها الدقيقة بالتفاصيل، ووجود مواد رديئة في الإنتاج، تسيء لقصصها ولرموز محتوياتها البشرية والمكانية؛ الأمر الذي يفسر رفض العديد من المعنيين بالتاريخ لفكرة تمثيل الكثير من مواده خشية تسطيح قيمته، وفقدانها لخاصية التخيل لدى قرائه التي غالباً ما تتجاوز قدرات المنتجين أنفسهم، ولو أن العقوبات الرادعة بالتمني لطالب متذوقو هذا الفن ان يُوقَع بمن يخفق في الإنتاج الدرامي للوقائع والأحداث أشد العقوبات، لتشويههم للحقائق وإساءاتهم للتاريخ، وهو ما يُملي الحاجة لوجود جهات رقابية حازمة لتقييم قدرات وكالات وشركات الإنتاج قبل الإقدام على إنتاج أعمال وثائقية، وتقييم مخرجاتها بعد الانتهاء منها وقرب عرضها للجمهور.
التوثيق الإعلامي إلى أين؟!
تكاد تنحصر جهود التوثيق الإعلامي، وربما مفهومه، في معظم الأحوال على عملية رصد مواد الوسائل الاتصالية وتحليلها لأغراض مؤسساتية هدفها الرئيس التعرف على موقف الرأي العام تجاهها، ومن ثم التفاعل معه بما يعينها على التطوير.
ومع ابتكار الهاتف الذكي وحلول شبكات التواصل الاجتماعي، بات معظم الأفراد في كافة المجتمعات يمارسون شكلاً آخر من أشكال التوثيق السريع، خاصة في المناسبات الاجتماعية بما في ذلك اللقاءات العابرة أو الرحلات والتنقل بين الأماكن، غير أن هذا النوع من التوثيق في الغالب، لا يعدو أن يكون اجتهاداً عفوياً يخلو من الجدية والتخطيط القريب أو البعيد.
ويدعم هذا القول أن أصحابه سرعان ما يفقدون موادهم جراء إهمالها وتجاهلها، متهاونين في قيمتها التي قد تتجلى لهم بعد فوات الأوان، ويؤكد هذا تحسر البعض على صورهم الفوتوغرافية القديمة التي تعرضت للتلف أو الفقدان.
نخلص من هذا إلى أن التوثيق الإعلامي على مستوى الأفراد أو المؤسسات بكافة أنواعها ومسؤولياتها، لم تول هذا النشاط الثمين الاهتمام الذي يستحقه، وربما حان الوقت لأن تقوم الجهات الإعلامية والثقافية بالدور المأمول للنهوض بهذه الصناعة المُهملة والمنسية التي يحتاجها الماضي والحاضر والمستقبل.