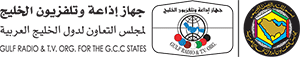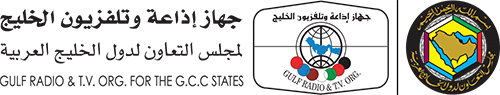مقدمة:
تختص السينما – خلافًا لباقي الفنون الأخرى – بكونها صناعة متكاملة تقوم على اقتصاد التأليف والإنتاج والتوزيع، وبالنظر إلى هذه الحقيقة فإن نجاح أي عمل سينمائي لا يقوم على أساس الإمكانيات المادية الهائلة التي توفر له وليس كذلك على وجود مخرج محترف، ولكنه يقوم بدرجة كبيرة على نهج سردي محكم يحمل قصة متماسكة مؤثرة قادرة على ملامسة هموم الجمهور وتطلعاته المتغيرة بتغير وتيرة العيش.
إن التأكيد على فكرة مواكبة انشغالات المتلقي الفنية، يعني البحث في ما يصوغ مسارات التحولات الاجتماعية والهموم الإنسانية في حبكة قوية متينة قادرة على أن تخلد في الذاكرة وتصبح علامة فارقة ومميزة في سماء الفن السابع.
ومثل هذا الهدف قد لا يتحقق، إذا ما بقيت السينما بعيدة عن النصوص القيمة التي صنعت مجدها، والتي استطاعت أن تجعل من الأعمال الأدبية العالمية المسرحية والقصصية معينًا لا ينضب لأفلامها.
لقد أبدع القائمون على السينما العربية قديمًا في استثمار كل حدود المثاقفة الفنية مع الآخر، فكان الاقتباس من الروايات المهمة التي حققت نجاحًا وقت ظهورها مثل رواية هيمنغواي (العجوز والبحر)، وسرفانتيس (دون كيشوت) أو فيلم (ذهب مع الريح) لمارغريت ميتشل… وغيرها من الأعمال الأدبية التي تحولت إلى روائع السينما العربية في عصرها الذهبي.
ولم يكن الأدب العالمي وحده وراء نجاح السينما العربية في بداياتها، ولكنها نهلت أيضًا مما جادت به قريحة الكتّاب الأدباء العرب مثل طه حسين في (دعاء الكروان)، ويحيى حقي في (قنديل أم هاشم)، وإحسان عبد القدوس في (الوسادة الخالية)، ونجيب محفوظ… وغيرهم من الذين أثروا حقل السينما بأعمالهم المتميزة.
والآن، وفي أخر توسعات الرواية والقصة كنوع أدبي والتي أسهمت وسائط الإعلام الجديدة في ترويجها، لا تزال السينما العربية بإجماع النقاد تعيش حالة تخبط فني بسبب أزمة النصوص وغياب أهل السرد وهو ما أنتج أفلامًا تتشابه في حبكاتها وتحيد في كثير من الأحيان عن الدراما المركبة التي تتعامل بنظرة فلسفية عميقة مع ما يشغل المواطن العربي من هموم وتطلعات، وهو الوضع الذي يجعلنا نتساءل عن مكمن قوة السينما العربية قديمًا وعن مهنة كاتب السيناريو المحترف؟ وعن كل ما أحدثه دعاة كسر القوالب التقليدية للصورة وأنصار فكرة التجريب في السينما؟
1-السينما العربية: جدل المفهوم وإشكالات الحسم النقدي
يطرح سؤال “الهوية” عمومًا إشكالات عدة في زمن العولمة بعضها يتعلق بالجانب اللغوي والثقافي والبعض الآخر يتصل بالمعيار الإثني والعرقي، وإزاء هذه التجاذبات تغدو “هوية السينما العربية” كمعطى نقدي عصية على التحديد.
فهل هي أحادية أم تعددية مركبة؟
وهل يكفي توظيف اللغة العربية في بلورة الخطاب السينمائي للحكم على السينما بكونها “عربية”؟، وفي هذه الحالة كيف نحدد العائدية القومية والثقافية للأفلام ذات الإنتاج المشترك؟ بل كيف نصنف الأفلام التي تناولت الهم العربي في المهجر؟
مثل هذه الإشكالات والهواجس فتحت الباب واسعًا أمام المهتمين بشأن السينما لإثراء السجال النقدي حول هذا الموضوع بطروحات متصادمة طورًا ومتكاملة طورًا آخر، حيث اعتبر البعض أن ” العربي” في تعريفه الضيق هو الذي يتكلم العربية ويحوي جنسية دولة لغتها هي العربية، ولعل هذا التحديث قد يكون غير قابل للإحاطة والجزم إذا ما أدرجنا في هذا التصنيف الأصول الإثنية والعرقية المختلفة للمجتمعات العربية وما يتبع ذلك من لهجات ولغات فرعية متباينة([1]).
إن هذا الامتزاج بين الهويات، يجعل مصطلح “المجتمع العربي” نفسه محل مساءلة ومراجعة، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أزمة تعريف السينما العربية هي انعكاس لأزمة الهوية التي يعيشها العرب كأفراد ودول ومجتمعات([2]).
فلو افترضنا أن شخصًا ما جزائري أمازيغي الأصل أسرته تتكلم العربية منذ أجيال ويعيش في فرنسا ويتكلم لغتها ويحمل جنسيتها ومشبع بالثقافة الفرنسية، وأقدم على صناعة فيلم تدور أحداثه في فرنسا في أوساط المهاجرين المغاربة، ولغته تجمع بين العربية والفرنسية، فهل فيلمه عربي أم فرنسي؟
تشي هذه المفارقة لا ريب بأن هناك غموضًا أكثر شمولاً من موضوع السينما وهو سؤال: من هو “العربي” أساسًا؟ وهل الإقرار بالانتماء إلى ذات الوطن “العربي” والحديث بلغته يعني إمكانية التجاوز عن الثقافات الموجودة في مجتمعاته؟
لهذه الاعتبارات، أضحت مسألة تحديد هوية السينما والفيلم العربي بشكل قطعي مهمة مستعصية على الحسم، ولذلك غالبًا ما تترك لاجتهادات النقاد وأعضاء لجان التحكيم المسؤولين عن فحص الأفلام وتصنيفها، وفقًا لمعايير مختلفة تقرها قواعد فن وصناعة السينما التي تخضع لحسابات السوق ودلالة شباك التذاكر وتقييم المهرجانات السينمائية الكبرى([3]).
2-السينما العربية وبدايات الاقتباس للشاشة
يقرن الكثير من النقاد مسألة رواج وانتعاش السينما العربية في بداياتها إلى تزاوجها الجميل مع السرد الروائي الكلاسيكي([4])، فاستلهمت منه عالمها التخيلي المليء بالإبداع والتشويق، وهو ما انتهى إلى تخريج روائع سينمائية بالنظر إلى الجوائز التي حصدتها في المهرجانات العالمية والأثر الطيب الذي تركته في نفوس المشاهدين([5]).
ويكفي أن نحصي الأفلام التي صنعت مجد السينما العربية لنبين أن معظمها كان نتاج مزاوجة بين فنيات الرواية كنوع أدبي له مصنفات بنائية وجمالية مخصوصة، والسيناريو الذي ينطوي على “أقلمة” النص الأدبي وإعادة صياغته وفق إستراتيجيات لغوية لفظية تختلف بين الشرح والتكثيف وإعادة التشكيل([6]).
هكذا وجدت السينما العربية في الأدب ما كانت تحتاج إليه، إذ كان لها بمثابة المادة الأولية، كيف لا، وهو يذخر بإرث فكري ثري، متنوع، طافح بالحكايات والقصص، والأشعار والأساطير مما مكن السينما من أن تتغذى منها وبذلك كانت عملية “الاقتباس” بمثابة أداة ناجعة ومفيدة لها([7]).
لقد أدى استئناس السينما العربية بالاقتباس إلى مهارات أخرى في مجال تطويع الأدب كبعد مجرد إلى نص سينمائي قوامه الحركة والصورة، وتقديم الشخصيات والأمكنة والأزمنة بشكل يرسخ في ذاكرة الجمهور([8]).
ولعل هذا الارتباط بين الرواية والسينما هو الذي أفضى إلى أعمال خالدة مثل فيلم “النداهة، وقاع المدينة، والحرام” ليوسف إدريس، وأفلام “بداية ونهاية، واللص والكلاب، وبين القصرين” لنجيب محفوظ، وفيلم “أبي فوق الشجرة” لإحسان عبد القدوس، والذي اعتبر في زمانه نقلة جديدة في مجال السينما الاستعراضية، بالإضافة إلى ما تلاه من أعمال مثل: “أنف وثلاثة عيون”، و”إمبراطورية ميم”، وفيلم “العذراء والشعر الأبيض”، و”في بيتنا رجل” … و غيرها من الروايات التي تحولت إلى أفلام ومسلسلات والتي بلغت قرابة (70) فيلمًا لإحسان عبد القدوس وحده([9]).
من هنا يمكن استنباط سر نجاح السينما العربية قديمًا، فهي لم تكن بمنأى عن حياة الإنسان العربي المهمش، وعن هموم المجتمعات المضطهدة، وعن الصراع الطبقي، وعن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تؤرق حياة المواطن العربي في الأرياف كما في المدن.
ولم يكن السرد الروائي عضد السينما المبدعة في مصر فحسب، ولكنه كان ظاهرة شائعة في الأقطار العربية كلها، حيث استفادت السينما الجزائرية من أعمال روائيين كبار كمحمد ديب في فيلم “الحريق”، و”ريح الجنوب” لرائد الرواية الجزائرية عبد الحميد بن هدوقة، و” ذاكرة الجسد” لأحلام مستغنامي … وغيرها من الأعمال الأدبية التي ما تزال تشكل علامة مميزة في الكتابة الروائية الجزائرية([10]).
على هذا النحو أوجد السرد الروائي الكلاسيكي من السينما العربية صناعة مبدعة عمت كل الأوطان على استثناءات قليلة، يمكن أن نذكر منها السينما التونسية التي لم يهتم فيها السينمائيون والمهنيون بثراء المدونة الأدبية التونسية وامتلاكها لنصوص جيدة صالحة لأن تكون منطلقا لأفلام ناجحة([11]).
وهي الإستراتيجية التي استثمرت فيها بنجاح السينما المغربية، حيث وجهت كل إنتاجها السينمائي الجديد نحو الاقتباس من الرواية والتراث المغربي، فكانت أفلام مثل: “صلاة الغائب” عام 1995م، المقتبس عن رواية “صلاة الغائب” للطاهر بنجلون، وفيلم “الغرفة السوداء” المقتبس عن رواية “الغرفة السوداء” لجواد مديدش عام 2004م، وفيلم “جناح الهوى” عن رواية قطع مختارة للكاتب محمد نضالي عام 2011م، وفيلم “بولنوار” المقتبس عن رواية “بولنوار” للكاتب عثمان أشقرا عام 2014م… وغيرها من النماذج التي كرست عودة السينما المغربية إلى متون الروايات والأعمال الأدبية من أجل الارتقاء بمستوى أفلامها([12]).
واللافت للنظر، أنه مثلما أغنت الرواية السينما العربية بسيناريوهات هادفة وناجحة، كان لتلك الترجمة السينمائية أثرها على الأعمال الأدبية أو لنقل على مبيعات هذه المؤلفات، حيث تعد هذه الأعمال السينمائية المقتبسة نوع من أنواع الإشهار والترويج للنصوص الأدبية وذلك من خلال الشخصيات الممثلة، وكثيرًا ما نجد بعض الناشرين ممن أعادوا نشر تلك الأعمال الأدبية المترجمة سينمائيًا، نظرًا لما لاقته من رواج([13]).
هكذا ولَد الاقتباس في السينما جواهر خالدة، استطاع فيها المخرجون التوفيق بين نمطين مختلفين من التعبير: بين الأدب والسينما، بين الكلمة والصورة، بين السردي والمرئي، بين المجرد والمتجسد، بين القلم وآلة التصوير، وبين صفحات عديدة ودقائق معدودة، وهو ما أدى إلى رؤى إبداعية أثرت السينما بأفلام رومانسية، استعراضية، بالإضافة إلى تجارب سينمائية خالدة عبرت بصدق عن تيارات متتابعة، كالواقعية والواقعية الجديدة والانطباعية والسوريالية… وغيرها من التيارات التي سجلت حضورها المرموق في تاريخ السينما العربية([14]).
إن الحديث عن الاقتباس ودوره في الارتقاء بالإنتاج السينمائي العربي لا يتم حتما دون تنويه بمهنة السيناريست المحترف الذي استطاع تطويع الكم الهائل من الأحداث والشخصيات الموجودة في الرواية والتصرف فيها فنيًا بشكل يضمن الإبقاء على عنصر التشويق الذي تقوم عليه أحداث الرواية من جهة والإبقاء على تسلسلها التراتبي من جهة أخرى([15]).
وغني عن البيان أن مهنة السيناريست لم تكن قرينة الاقتباس فقط، ولكنها عبرت عن توجه مستقل له ضوابطه في صناعة الأفلام، وهو ما ساعد على ظهور جيل من كتّاب السيناريو والقصة ممن أبدعوا في اقتراح سيناريوهات ذات حبكة فنية جيدة هي الآن علامات في مجال السينما العربية نذكر في هذا الإطار ما قدمه “أسامة أنور عكاشة” من كتابة متميزة للشاشة.
نستشف مما سبق، أن كتابة السيناريو ليست مهنة للمتطفلين على فنون السرد ولا هي مجال للخواطر العابرة ولا مجرد أفكار يراد توصيلها للمشاهد أو المتلقي من خلال الشاشة ولكنها نصوص فنية خالصة مكتوبة في شكل قصة وحوار موجه للسينما([16])، وهي تتكون من مجموعة من العناصر الأساسية التي تتضافر مع بعضها وتتفاعل لتمنح النص الشكل الدرامي المطلوب لعرض ممتع هادف ومشوق.
ويستند النص الدرامي القويم على فكرة ينسجها الكاتب في حكاية محبوكة الأطراف، تقوم على شخصيات تجسدها من خلال الحوار والصراع والأحداث، والسيناريست المبدع هو الذي لا يهتم بعنصر من هذه العناصر على حساب العناصر الأخرى، بل يتقنها جميعا لتبدو في شكل منسجم وفي توازن تام يوحي بلحمة فنية خلاقة وهادفة([17]).
تأسيسًا على ما سبق يقر النقاد بالإجماع بأن ضعف السيناريوهات الحالية هي من الأسباب البنيوية في أزمة السينما المعاصرة، وهو ما فتح المجال واسعًا لظهور أفلام تجارية وأفلام “الأكشن” والكوميديا الهزلية الفارغة من محتواها، بل إن حتى الأفلام الاجتماعية لم تعد تعكس رؤيا إنسانية عميقة قادرة على الإسهام في عرض ومناقشة قضايا الإنسان المعاصر([18]).
ولئن كان غياب السيناريست المحترف وتراجع السينما عن الاقتباس من الأدب سببًا في تعميق أزمة السرد السينمائي، فإن ما يزيد هذا الإشكال حدة هو بروز أصوات واتجاهات تعمل على كسر القوالب التقليدية للسرد بدعوى الاجتهاد والإبداع الفني.
3-السينما العربية وإشكالية تجديد طرائق السرد
على الرغم من أن فكرة التجديد تستبطن عادة دلالات إيجابية نحو التغيير، إلا أنها في حالة السينما العربية قد أفضت إلى ما يشبه الفوضى التي أدت إلى تداخل المهام، حيث أصبح المخرج ومؤلف الفيلم، وعوضًا عن أن تكتب العبارة التقليدية: “فيلم من إخراج فلان” تستبدل بـ”فيلم لفلان” أو “فكرة فلان”.
ويستند دعاة هذه “الموجة الجديدة” في صناعة السينما إلى أن مخرج الفيلم هو أهم من كاتب السيناريو، بل أن الكاتب ليس إلا مجرد “حرفي ” يمكنه نقل رواية أدبية أو مسرحية مثلاً إلى لغة السينما، أما المخرج فهو يعبر عن رؤيته الخاصة باعتباره مؤلف أفلامه([19]).
وأدى التشبث بهذا الطرح الذي يختزل نظرية “المخرج المؤلف” إلى التركيز على الصورة واللغة السينمائية وتجاوز روح كل عمل سينمائي في التعلق بمسار سردي محكوم بترابط منطقي، عبر سلسلة الوظائف الفاعلة في تتابع الأحداث، بالإضافة إلى جمالية الوصف وفعالية الحوار وقوة الرسالة والهدف المراد بلوغه([20]).
وإذا كانت فلسفة صناعة السينما تقتضي أن يعهد كل ركن فيها إلى ذوي الاختصاص من كتّاب سيناريو ومخرجين ونقاد ومحكمين في مهرجانات، فإن واقع الحال في الوطن العربي غير ذلك، حيث يمكن لأي مخرج أن يصبح فيلسوفًا ومنظرًا وناقدًا لأفلامه، بل وحتى أفلام الآخرين.
وقد أدى هذا التوجه بغالبية المخرجين العرب الذين بدؤوا مسارهم الفني بأفلام طموحة وجذابة، إلى الانتهاء بعد فترة إلى تكرار أنفسهم أو الدوران حول الأفكار نفسها التي سبق لهم تناولها في أفلامهم الأولى وهو ما يتنافى وفكرة الإبداع والتجديد([21]).
ها هنا، يتأكد أن تحقيق الدراما السينمائية المركبة، لا يتم عن طريق تحريك الكاميرا فحسب أو اللجوء للقطعات والانتقالات السريعة من خلال المونتاج دون أن يكون لهذا أي ضرورة فنية في السياق السينمائي نفسه، ولكنه ينبني بالأساس على قصة مشوقة، هادفة، محكمة السرد، وما لغة المشهد إلا نقل تصويري فني لهذه القصة([22]).
هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن تفصيل آخر شديد الارتباط بمسألة تدني مستوى السرد في السينما العربية وهو ما يتعلق بموضة “ورش الكتابة الدرامية”، حيث يلتقي مجموعة من المؤلفين لاقتراح أفكار سيناريوهات موحدة وهو ما يتعارض مع هدف تجانس الرؤى في بوتقة السرد، الأمر الذي ينتج في غالب الأحيان أعمال تفتقد إلى الأسلوبية الروائية، وتشابك عنصري الزمان والمكان، وتداخل الأزمنة، وضعف الحبكة والصراع وهامشية الحوار وانزياحه عن تخوم الحكي وآفاقه([23]).
على هذا النحو، أدى الإفراط في تجريب طرائق جديدة في السرد إلى تراجع مستوى السينما العربية مقارنة بفترة إشراقتها الأولى([24])، وهو ما دفع بعض النقاد والعارفين بشؤون الكتابة الدرامية إلى المناداة بالعودة إلى زمن الاقتباس، حيث كان المنتجون يتنافسون على تقديم الأجود من متون الحكي المبنية على الحدث الدرامي المتصاعد والشخصيات والإثارة والتشويق والرسالة الضمنية الهادفة([25]).
وليس المقصود هنا الإفادة من نضم السرد العربي فقط، وإنما من كل ما يمكن أن يختزل إنسانية الحكي عالميًا، خاصة في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وما سمحت به من تلاقي وتلاقح للطموحات الإبداعية عبر القارات.
خاتمة
مما تقدم نخلص إلى أنه يتعين على صناع السينما العربية في الوقت الراهن الإيمان بحقيقة أساسية مفادها أن السينما ليست فقط مشهدًا ولا مهرجانـًا، ولكنها عبارة عن نص يختزن معنى كبيرًا، تتحدث فيه باختصار وظيفة الفن السابع باعتباره فنـًا يحاول التواصل مع الذات ومع الآخر لكي يفهم شيء آخر غير ذلك الذي يظهر في الصورة، ذلك الشيء هو “المعنى” الذي يحقق الشرط الأساسي في السينما وهو المتعة والمتعة في النهاية غير التسلية.
الهوامش
([1]) Francine Bordeleau: cinéma et societés arabes edition, Gallimard, Paris, 2018, P16.
([3]) Jeanne – Marie Clerc : L’avénement du cinéma arabe, Collection ” critique” édition Minuit, Paris, 1999, P9.
([6]) Cecile Boex: le cinéma arabe: du roman au film, édition l’harmattan, Paris, 2016, P49.
([9]) دانيال فراميتون: الفيلموسوفيا (نحو فلسفة للسينما)، ترجمة: أحمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة: ط2، 2010م، ص175.
([13]) Cecile Boex: le cinéma arabe du: roman au film, Op, cit, P67.
([15]) كين دانسايجر: الكتابة للشاشة، كيف تصبح سيناريست متميز، ترجمة: أحمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط2، 2011م، ص134.
([19]) Ray Deckinson: new arab cinema, Rootledge, London, 2017, P7.
([22]) Cecile Boex: le cinéma arabe: du roman au film op, cit, P89.