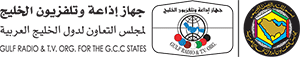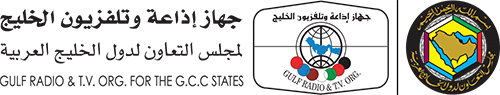أحدثت ثورة تقنيات الاتصال، وفي فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة عقود ثلاث موجات متتالية في أشكال هزات قوية، تسببت بشكل ملحوظ أساليب لا يُنكر أثرها الفعال في تشكيل هوية الإعلام، إذ أنها أدت وبمستويات متفاوتة إلى تحولات جذرية في آليات ممارسته ووسعت دائرة ممارسيه؛ أما الموجة الأولى، فتمثلت في ابتكار شبكة الانترنت، التي أوجدت فضاءً دراماتيكياً فسيحاً ليس للباحثين عن المعلومات فقط، بل للعامة دون استثناء، وتضمن ذلك احتوائها لكافة وسائل الإعلام بأشكالها ومضامينها، لتمكنها من اختصار مسافات وصولها الآني لجمهورها في شتى البقاع، وقبل أن يستفيق العالم من هذا التطور المذهل، عرَّف هذا الفضاء بابتكار عبقري تمثل في شبكات التواصل الاجتماعي، ليس ليمكن المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية من التعريف بأخبارها وتسويق ذواتها فحسب؛ بل ليمنح الأفراد ولأول مرة فرصة غير مسبوقة من ممارسة مهنة الإعلام بكل يسر وسهولة، ومن التواصل والوصول لبعضهم البعض في شتى بقاع الأرض دون أية مقابل، فبعد أن كان الفرد يعتمد على طرق بدائية تشبه إلى حد كبير تلك الأساليب التي استخدمها البشر منذ آلاف السنين، ونقصد بها الرسائل البريدية الملموسة والمدونة على أجسام كالورق والجلد والرقاع، أصبح قادراً على التخاطب صوتاً وصورة مع الآخرين، وبشكل فوري في أي موقع من هذا الكوكب.
مفاجأة الذكاء الاصطناعي
ولعل من المفارقات في هذه التحولات المذهلة، اعتقاد البعض أن كل تحول شكل في إبهاره النقلة النهائية والحاسمة في بلوغ ذروة الاتصال والإعلام، وبينما كان تخصص الاتصال هو الأكثر تأثراً بالفضاء الرقمي، بوصفه روح مادتها والقيمة المضافة لمستخدميه، جاء ابتكار ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي مفاجئاً للتخصصات جميعها، وضاعف من قوته هذا النوع تجاوزه في قدراته وإمكاناته التصورات المحدودة حول مفهومه آنذاك، فبينما كان يتلخص في مجموعة من الأنظمة، والمعادلات أو البرمجيات التي تقود إلى نتائج محصورة في حدود تحكم البشر، جاء في هيئة تقنية ثورية مستوحاة من طريقة تفكير العقل البشري نفسه، قادرة على أن تقرأ البيانات، وتحلل أبعادها وتربط بين تفاصيلها وعلاقاتها بأسلوب منطقي؛ وتنتهي بسرعة مذهلة إلى تقديم مخرجات مٌبهرة في دقة موادها، وكان مما يبعث على الإعجاب بها، قربها المتناهي مع تفكير بني البشر وقدراتهم على نحوٍ اختلفت حوله الآراء من حيث النظرة إليه سلباً من حيث تهديده لمقدراتهم، أو إيجاباً من حيث قدرته على الإضافة المهنية لخدماتهم، ولأن طبيعة النفس البشرية مجبولةٌ بالحرص على مصالحها القريبة أولاً، أصبح الاعتقاد بأنه قادر على القيام بمعظم مهامه يشكل خطراً موقوتاً يهدد مستقبله الوظيفي، مما يجعله سبباً في زيادة نسبة البطالة، وعامل هدم يفاقم مشكلات عيشه، ويقلص موارد دخله، في حين نظر البعض وهم قلة إلى هذا الذكاء الاصطناعي على أنه فتح كبير لآفاق جديدة نحو حياة أكثر تطوراً ونمواً.
التحديات والفرص:
قبل الخوض في مُعادلتيْ الخسارة والربح من خلال البحث في مواطن التحديات والفرص، لابد من القول بأن بقاء المختصين في أية مجال وتحديداً الإعلام والاتصال، أسرى لما اعتادوا عليه، أو لما يحسنون عمله، والخوف من المجهول، قبل حدوث أية تغيير أو تطور معين، يجب أن لا يكون موجهاً للحكم على كل ما هو جديد، ذلك أن التجدد والتحولات شكلت ولا تزال عرفاً دأبت عليه كافة شؤون الحياة، وذلك في إطار البحث المستمر عن الأدوات التي تحسن الواقع، وتيسر التعامل معه، بما في ذلك التخلص من التعقيدات التي عادةً ما تنشأ ابتداءً في خطوات السير نحو الهدف، قبل تطويرها.
وبناءً على هذه القاعدة فإن التسرع في الحكم سلباً على مستقل ومآلات تخصص الإعلام ووسائله مع هذا القادم الجديد، هو أسلوب لا يمت للموضوعية بصلة، وفي الوقت الذي يتحتم النظر له على أن الذكاء الاصطناعي وسيلة متقدمة جداً في تعزيز الإبداع البشري في النشاط الاتصالي بمفهومه العريض، إلا أنه لا يمكن أن يحل محلها بأشكالها المتنوعة والمختلفة، فعلاوة على أنه أداة مهولة في قدرتها على اختصار المسافات الطويلة للوصول إلى الهدف، إلا إنه يبقى وسيلة ولن يكون الهدف ذاته، الذي هو المحصلة النهائية التي شكلت باستمرار، سواء في الماضي والحاضر والمستقبل، الوسائل المناسبة لإيصال الرسائل وفق آليات دقيقة مرتبطة بمشاعر حصرية لدى البشر، مما يعني أن تقلص هذه الرابطة، ستظل تستدعي تدخل بني البشر لمعالجتها، وتطويعها بما يقربها للواقع، ويؤكد ذلك أن المطلع على منتجات الذكاء الاصطناعي الاتصالية، ممن هو قادر على تفحصها بعمق، يستطيع – خاصة الخبير في المهنة – أن يميز بين المادة المصنعة شبه الجامدة أو المقولبة، وبين نظيرتها العفوية ذات الطابع الانسيابي المشبع بالإحساس الذي يلامس كيميائياً وجدان الناس ومشاعرهم.
هذا لا يعني مطلقاً أن الفارق بين المنتج البشري والتقني على إطلاقه في شدده وضوح وإمكانية تمييزه، فالموضوعية تقتضي الاعتراف بأن الفارق بينهما وصل في شدة التقارب في بعض حالاته إلى مرحلة مشابهة، ويؤكد ذلك – على سبيل المثال- التقرير الذي بثته قبل أيام قلائل محطة الـ CBS التلفزيونية الأمريكية، عن قيام إحدى ممثلات الذكاء الاصطناعي، اسمها تيلي نورود، من خلال منتجيها، بالبحث عن وكالة إنتاج في مدينة صناعة السينما الشهيرة هوليود لتمكنها من القيام كغيرها من آلاف الممثلين في أدوار تصنع منها نجمة سينمائية منافسة، الأمر الذي أثار القلق في نفوس العيديدين في الوسط الفني خشية فقدانهم لأدوارهم، وفرص عملهم.
ورغم أن المنتج الهولندي لهذه الممثلة الافتراضية مع شريكه الكوميدي Eline Van der Velden المالك لشركة Xicoia يتطلعان إلى أن يكونا أول مستثمرين في مجال أستوديوهات خاصة بمواهب الذكاء الاصطناعي، إلا أن فكرتهما قوبلت بالمعارضة الشديدة من قبل أصحاب المهنة، الذين أصروا أن تبقى أدوار تمثيل القصص الانسانية محصورة في العنصر البشري دون غيره.
غزو التقارير
ولا يقتصر توظيف التقنية الذكية في المجال الإعلامي على هذا الجانب، بل إن هناك نماذج أخرى تظهر مزيتها في تعزيز الأداء الإعلامي للوسائل والعاملين بها، بل وقدرتها على التعرف على مواقف جمهورها ومستوى تفاعلهم معها، من ذلك ما أشارت إليه الإحصاءات في أن وكالة “أسوشيتد برس” تنتج أكثر من 4,000 تقرير مالي شهرياً باستخدام تقنيات الكتابة الآلية، مما يوفر للصحفيين وقتاً للتركيز على التحقيقات المعمقة، وكذلك استعانة صحيفة “الجارديان” بالذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك القراء وتقديم اقتراحات مخصصة، مما أدى إلى زيادة معدل المشاركة بنسبة 23%، كما أن الصحف الكبرى مثل “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” غدت تعتمد اعتماداً كبيراً على الذكاء الاصطناعي في إنتاجها للتقارير الرياضية والمالية، ولا يقتصر الأمر في ذلك على مجرد إعداد المواد الصحفية، بل إنها باتت تستخدم هذه التقنية كجهازٍ فاحص ومؤتمن في تنقيح المعلومات والتحقق من صحتها وكذلك في مكافحة الشائعات، وفي هذا الصدد طورت شركات متخصصة مثل “Full Fact”، أي “الحقيقة التامة”، أدواتٍ ذكية متقدمة يمكن من خلالها فحص آلاف المقالات يومياً للتأكد من دقتها.
بقي أن نشير إلى أن هناك تفاوت كبير بين إنجازات المؤسسات الإعلامية الغربية وبين غيرها من مناطق العالم؛ حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن 67% من المؤسسات الإعلامية الكبرى في الدول المتقدمة تستخدم بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 34% فقط في المنطقة العربية.
ربما يكمن السؤال الذي يقفز إلى الذهن مع هذه النماذج، التي يبدو أن بعضها تجسد شكلاً من أشكال التهديد لأنشطة من نشاطات الإنتاج الإعلامي، هو: هل تعد هذه الحادثة مقياساً مؤشراً على قرب انتهاء دور الإعلاميين؟!
الجواب هو أنها وسائل عصرية في مضمار تطوير المهنة، لا يمكنها أن تستغني عن خواص الحس البشري، إذ أن التقنية مهما تقدمت، لن تلغي الحد الفاصل بين ما تنتجه الآلة، وبين ما يجود به العقل الذي مُيِّز به الانسان عن غيره من المخلوقات والأشياء، التي تشمل هذا النوع من التقنية؛ فهي من صنعه وابتكاره، مما يعني أن مخرجات العقل، ومنتجات التقنية مهما تقاربت في بعض نماذجها، ستظل بالنظر إلى تفصيلاتها وملامحها علامة فارقة في التعرف على مصادرها ومدى التفاعل معها.
إعلام الذكاء الاصطناعي إلى أين؟
مما تقدم يتضح بأن مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وبين صناعة الإعلام، يخضع بالدرجة الأولى للكيفية التي يُنظر فيها إلى حجم الدور الذي يمكن أن تقوم بها التقنية، كأداة عظيمة للارتقاء بالأداء الإعلامي إلى مراتب أعلى، لكنها ستبقى ضمن إطار محدد لا يكتمل إلا بالتدخل البشري لتهذيبه، والنجاح في استثماره يتطلب مواكبة حجم التسارع في وتيرة التطور التقني، والمرونة في مواكبة تحولاته الجذرية التي لم يسبق له مثيل منذ اختراع المطبعة، وهو ما يستدعي إعادة تعريف مفهوم العمل الصحفي، والتعرف على أدق طرق إنتاج المحتوى الإعلامي الجديدة، وصياغة أدبيات تعليمها وأشكال تدريب ممارستها، وهي مهمة نحتاج إلى تعزيز العلاقة البينية بين كليات ومعاهد الإعلام ونظيراتها المتخصصة في الحاسب الآلي وتقنياته، مع العمل على التخلص من كافة مكونات الإرث التي عفا عليها الزمن، وأصبحت جزءً من تاريخ الإعلام.