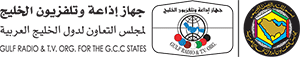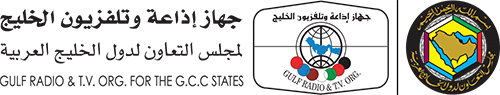يخطئ مـَن يقيس ربح وسائل الإعلام بحجم إيرادات الدخل الإعلاني الذي تحققه؛ فهذا البـُعد، الذي ينحصر في تطلعات الوسائل، لا يعدو أن يكون في حقيقة أمره سوى هدف هامشي أمام مطلب أعمق وأشمل يرتبط بكينونة دول الوسائل وتعول عليه من دون استثناء، بوصف الإعلام أحد معززات استقرارها ونمائها وازدهارها التي قد لا تستتب عندما يضعف: إخبارًا وتعريفـًا، ورقابة، وتصحيحـًا لمغالطات أو إشاعات كيدية تربك الجهود وتحبط المعنويات، وتقوض الآمال والطموحات.
من هذا المنطلق، فإن الخط الفاصل في تقسيم المتخصصين لوسائل الإعلام، من حيث ملكيتها، إلى نوعين: حكومي وخاص، يتحول في هذا السياق إلى خط وهمي خاصة في أثناء الأزمات وفي إطار التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات.
صحيح أن هناك اختلافـًا في سمات كل نوع؛ حيث تغلب على طابع الإعلام الحكومي الرسمية، ويمثل في كثير من أشكاله سياسات الدول وشخصيتها، بل إنه يتسم بخضوعه التـّام لتحكّمها مباشرة أو عبر وسيط يتناغم في تشغيله لها مع تلك السياسات، في حين إن الإعلام الخاص يبدو – عيانـًا – لجمهوره بأنه متفرد تمامـًا في إدارته، ومنعتق من القيود التي تطوق النوع الأول، كما أنه – على الرغم من وجود خيوط خفية وعلاقات وثيقة بين قياداته وحكومات الدول التي تنتمي لها الوسائل – يحظى بمرونة أعلى تمكن من إخفاء الصلة، ليتمكن من خلال ممارسته المهنية التي يفضلها الجمهور ويثق في معلوماتها، وبفضل التوازن الأقرب للمهنية في تغطيته للأحداث، من الانسياب بسلاسة إلى عقول الناس، ومن القدرة على إقناعهم بدقة المضامين وموضوعية الطرح، وبخاصة فيما يتعلق بالأخبار، وبالتالي يستطيع تشكيل المواقف، والسيطرة على ما يسمى بالرأي العام، الذي يـُعدُّ قوة حاسمة في التماهي مع القرارات والتفاعل معها إيجابـًا أو سلبـًا.
إن قدرة بعض وسائل الإعلام المهارية في إخفاء انتماءاتها، عبر تجنبها للألوان الرسمية، هي السبب الرئيس في إبقاء فكرة الفوارق بين النوعين جلية ومقنعة، وظهور الحدود والحواجز، وبخاصة في الدول التي تحمل لواء حرية التعبير، وهو ما جعل الأهداف الإستراتيجية الموحدة بين النوعين ومقاصدهما الحقيقة غير بائنة، ولا تظهر إلى السطح إلا حينما يتعرض الأمن الوطني للتهديد، فيصبح توحد المواقف أمرًا حتميـًّا إما طوعـًا أو كرهـًا، ولا عذر حينها لمن يتأخر أو يتغيب عن الساحة، إذ تبرز الخطوط الحمراء بشكل تلقائي لا يمكن للحكومات أن تقبل بالاقتراب منها؛ بل إن الشعوب نفسها ترفض وقتها مبدأ الحيادية المهنية الإعلامية في هذا الأمر.
في هذا الجانب تحضر بقوة قصة تسريح قناة الـ(NBC) الأمريكية لمراسلها الأمريكي الشهير، النيوزلندي الأصل، “بيتر أرنيت” (Peter Arnett)، الحاصل على جائزة بوليتزر، التي تـُعدُّ أعلى جائزة عالمية في مجال الصحافة نظير تغطيته النوعية لحرب فيتنام بسبب نوعية تقاريره، وذلك حين وافق في عام 2003م على طلب التلفزيون العراقي بمقابلته، فعلى الرغم من دعم القناة لموقفه ابتداءً بحجة أنها كانت مجاملة مقبولة منه، إلا أنها غيرت موقفها بشكل مفاجئ، وتخلت عنه لأنه، كما قالت القناة، وفقـًا لما نشرته الجارديان البريطانية: “صرح للعراقيين في وقت حرب، وكان خطأً أن يعبر عن ملاحظاته وآرائه الشخصية حينها”.
هذه الخطوة، التي كانت ستُعدُّ تعسفيةً، ومخالفةً لحقوق الإنسان، لو أقدمت عليها وسيلة إعلامية تنتمي للدول النامية، لم تكن الأولى مع الصحفي نفسه، بل سبقها تصرف مماثل من محطة (CNN)، في إجراءين غريبين يُلقيان بظلال الشك القريب إلى الثبوت على دور الحكومة الأمريكية، وتحديدًا وزارة الدفاع، في إقصائه وتنصل القناتين منه.
فقد كان بيتر أرنيت مراسلاً للمحطة العالمية الإخبارية إبان حرب تحرير الكويت عام 1991م، ولتميزه في تغطية الحروب والصراعات، وحرصـًا منها على توحيد الرسالة التي تصدر من الوسائل الإعلامية عبر مصدر واحد لكافة القنوات ولملايين المشاهدين حول العالم ويكون تحت أنظارها، رأت الحكومة العراقية أن تطرد جميع الإعلاميين الأجانب والإبقاء على أرنيت فقط، الذي وجد في ذلك فرصة ذهبية ليكون المصدر الحصري لأخبار يتعطش إليها الجميع، فآثر أن يبقى النزيل الإعلامي الوحيد في فندق الرشيد في بغداد في يناير من عام 1991م، فحظي حينها بتسهيلات استثنائية من الجانب العراقي، حتى أنه مُنِح مفاجأة لم يتوقعها، حين نـُقل مكمم العينين إلى إحدى ضواحي العاصمة، ليجد نفسه في أحد المخابئ، وجهـًا لوجه مع الرئيس صدام حسين ليُجريَ مقابلة تاريخية تـُعدُّ من أهم المواد الإعلامية التي وثقت أحداث الحروب، وربما الحروب أجمع.
استمر أرنيت في موافاة العالم بتغطياته لآثار الضربات الموجهة للداخل العراقي، إلى أن جاءت القشة التي أججت غضب الحكومة الأمريكية؛ يوم كشف بالأدلة عن حقيقة ادعاء جيشها ضرب أحد مصانع الأسلحة الكيماوية، الذي برهن المراسل على أنه لم يعدو عن كونه مصنعـًا لبودرة حليب الأطفال، ولم تتسبب هذه المعلومة في ردّة فعل عنيفة من الجهات الرسمية فحسب؛ بل نال صاحبها انتقادات حادة من كافة الأطراف مؤسساتٍ وأفرادًا؛ بما في ذلك أشهر الصحف العالمية “نيويورك تايمز” التي وصفت تواجده في العراق بأنه “خدمة لبغداد أكثر من واشنطن”، وهذا التعبير الصريح بحدِّ ذاته يؤكد بقوة أن قيم “الموضوعية” و”الحيادية” المطلقة، حتى لدى أعتى الوسائل الإعلامية، حكومية أو خاصة، لا تَصدُق إلا لدى المنظرين.
مثل هذا الإجراء يكشف بجلاء عن خيوط العلاقة بين الحكومات ووسائل الإعلام، وهو ما يجعل الأولى تتدخل لصالح الأخيرة عندما تتعرض للتحديات التي قد تتسبب في إضعافها، بغض النظر عن طبيعة ملكيتها، فاستقلالية الوسائل ومؤسساتيتها لا يعني تخلي الحكومات عنها في حال الأزمات التي قد تعتريها، حتى لدى أكثر الدول مناداة ببقاء الوسائل سلطة رابعة، ذات وظيفة رقابية على كافة السلطات، ليس في أمريكا فحسب؛ بل حتى في القارة الأوروبية، ففي السنوات الأخيرة، لم تقف كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا – على سبيل المثال لا الحصر – مكتوفة الأيدي تجاه تهديد طوفان شركات الاتصال والمعلومات الرقمية العملاقة وأدواتها، لمكانة وسائل إعلامها المؤسساتية المحلية ومقوماتها، فكان أن تدخلت بقوة لمعالجة تراجع إيراداتها الإعلانية عبر فرض جملة من التشريعات الصارمة التي تلزم الشركات الكبرى، بخاصة قوقل والفيسبوك وتويتر، بدفع مقابل لوسائلها المحلية عن أية مواد إعلامية مستقاة منها، بوصفها المصدر الرئيس، كجزء من حقوقها الفكرية.
ولم ينحصر هذ التدخل في تلك الدول، بل إن الاتحاد الأوروبي بأكمله اتخذ خطوات مماثله، كما أن بريطانيا هي الأخرى استشعرت خطورة الأضرار التي طالت وسائل إعلامها، وطالبت بشكل رسمي بالحفاظ على مكانة وسائل الإعلام، في خطوة من شأنها أن تمنع مسخ إعلامها الوطني العريق، وقدمت اعتراضها في صيغة دعوة لتدخل الحكومات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فقد صرح وزير الثقافة والخدمات الرقمية أوليفر داودن، بجملة تـُعدُّ مؤشرًا على أهمية إعادة النظر في الفوضى الراهنة بما يضبطها، حين قال: نحن ندخل عصرًا جديدًا يملي على الشركات الرقمية أهمية استشعارها لمسؤولياتها وضرورة الالتزام بها تجاه الأطفال ومستخدمي منصاتها، لإعادة الثقة في نشاط النشر الإعلامي.
هذه الدعوة لإعادة الثقة في نشاط النشر الإعلامي هو ليس فقط مجرد الانتصار للوسائل المحلية لتواصل وظيفتها المعتادة، وإنما لأهمية أدوارها الرصينة للدول والحكومات، فلم يكن لدول أوروبا أن تسمح لأحد أن يتعرض بالتعطيل لمكائنها الإعلامية ذات الدور السيادي المهم، وما من شك في أن هذا التصدي لأي تهديد خارجي لأذرعها الإعلامية سيقابله تصدي مواز لأي تهديد داخلي، مهما كان نوعه، بما في ذلك الضعف الذي قد يعتري أساليب أداء الإدارة العليا وكوادرها البشرية والفنية، في حال عجزت عن مواكبة التطور المذهل في تقنيات الاتصال، فالأخذ بيدها في الحالات التي تنتكس فيها أوضاعها، هو في واقع الأمر جزء من الحفاظ على الأمن الوطني نفسه.