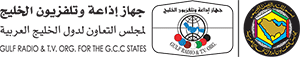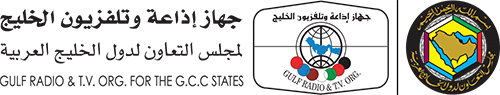القول إن الأخبار: “بضاعة” تنتجها وسائل الإعلام، لتقدمها للمستهلك (الجمهور)، ليست وليدة اللحظة، بل كانت إحدى المقولات المعروفة لدى المتخصصين والباحثين في حقل الإعلام منذ فترة ليست بالقصيرة، وإن كانت القناعات بالفكرة الوجيهة لم تصل إلى مرحلة التطبيق المتعارف عليه في أسواق التجارة على نحو يجعلها من المسلمات، والسبب في هذا أمور كثيرة من أبرزها قيام مستفيدي الصفوف الأمامية (الساسة، والتجار، وقادة الرأي..) بدفع التكلفة الحقيقة للمنتجين، (الإعلاميين)، نظير الفوائد الجمّة التي يجنونها في ساحة الرأي العام المكون من الأفراد والجماعات والمؤسسات.
وعلى الرغم من أن تعدد الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية، كان قد أوجد نوعًا من المنافسة العالية بينها، إلا أن تلك الوسائل كان بينها لغة مشتركة، مكنها من العمل بسلاسة وتفاهم تام واحترام متبادل، بخاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية، كما حافظت على التوازن المطلوب مع كافة الأطراف لتحقيق المكاسب المرجوة مع الجميع، بما في ذلك الجمهور العريض (المستهلكون) الذين كانوا بحاجة إلى رعاية خاصة ليس في الأسعار الرمزية في الاشتراكات أو المبيعات، بل في العمل على تلبية حاجاتهم المعرفية والترفيهية والاجتماعية عبر مضامين وأشكال متنوعة قادرة على التسويق والجذب الفعال.
كان من نتائج هذه المعادلة في ساحة النشر الإعلامي الوصول إلى فـَهم مشترك، شكل في جوهره اتفاقًا غير مدون بين الأطراف ذوي العلاقة، وسجلت الوسائل، وهذا ما يهمها بالدرجة الأولى، عوائد مادية ضخمة تحتفي بنموها سنة بعد أخرى، في مظاهر نشوة لا تخلو من الاطمئنان لمستقبل أكثر إشراقـًا وزاد من اطمئنانها.
إن معظم الإصدارات المستجدة، بما في ذلك النشرات الإعلامية الأخرى المجانية لم تتمكن من دخول حلبة المنافسة، وهو ما منحها ثقة عالية تدعمها فيه صورة ذهنية راسخة، هي حصيلة سنوات من التواجد الدوري، الذي شكل إحدى وسائل تعزيز الولاء والسمعة.

نقطة التحول
استمر الأمر كذلك إلى لحظة بزوغ نجم شبكة الإنترنت التي فتحت فضاءً جديدًا قلب موازين كثيرة في مكونات العملية الاتصالية، إذ قدم هذا الفضاء نموذجًا مختلفًا في النشر الاتصالي لامس كافة عناصره وغير معالم خريطته، فأحدثت الشبكة في العقدين الأخيرين تغيرًا شموليًّا في أدوات الاتصال ليس من حيث الشكل فقط؛ بل ومن حيث مفهوم القائم بالاتصال، وأساليب تواصله، وكان مما زاد في تعقيده أن تلك التغيرات كانت أسرع من أن يستوعبها أبرز الممارسين في حقله آنذاك، وبخاصة الإعلاميون الذين استأثروا بأبرز أدواته ومعظم أشكاله لفترة طويلة من دون وجود منافسين لهم قبل حلول التحول الاستثنائي، بعد أن كانت صلتهم الوثيقة بها أوصلتهم إلى الاعتقاد شبه الجازم أن قدراتهم المهنية، وصلاحياتهم التي مُنِحت لهم ستبقى الحصن الإعلامي الحصري آنذاك سالمًا من أية عوارض، لا سيما وأنهم كانوا يملكون المنبر و”المايك”، ويتمتعون بخاصية إرسال آحادية، لا تسمح لغيرهم بالتعبير بذات المستوى أو الفعالية.
وحدثت المفاجأة.. طوفان هائل ينقلهم إلى فضاء رقمي غير مألوف، فيلغي في وقت وجيز أسوار المهنة بمفهومها التقليدي، ويقتلع جذورها، وتنال أمواجه العاتية كافة المجالات ليصبح تفعيل الاتصال هو السمة والمؤشر على التميز، بل إنه أُعطى ومن دون شرط أو قيد العامة مزايا من كان في الميدان وزاد عليها خصائص لم تكن متوافرة من قبل لدى الرّواد، وجراء ذلك أصيب مَن كان داخل الدائرة الحصرية بالذهول، على الرغم من أن كثيرين منهم لم يكونوا جاهلين بالقادم الجديد، لكنهم تجاهلوه، ولم يقدروا حجم تهديده وخطورته.
وبعد أن ظهرت آثاره وتبينت تبعاته التي هزّت أركان الصناعة التقليدية، شرع أصحابها، بعد فوات الأوان، بالبحث عن حلول تحفظ جزءًا من المجد الذي توار بريقه، فقدموا من دون استيعاب تام لطبيعة الفضاء الجديد حلولاً اجتهادية لم تخرج كثيرًا عن دائرة فكر الماضي، إذ لم تعدوا أن تكون محاولات لترتيب أوراق تطاير عصرها، وغدت الرقمنة ومنتجاتها المتنوعة في الأشكال والأساليب هي سيد الموقف، والحق أن التغيرات كانت ضخمة ومربكة، ليس للمؤسسات الإعلامية فحسب؛ بل امتدت حتى إلى محابر المشرعين وواضعي الأنظمة والقوانين، فلم يجدوا لعدم فـَهم المشهد كذلك سبيلاً مناسبًا لمدِّ يد العون، ليغرق المشهد في ساحة فوضى غير مسبوقة.
الخروج من المأزق
اتضح من الدروس الأولية لنتائج التغيرات، أن عدم استشراف السواد الأعظم، من صنّاع الإعلام للتبعات التي آلت إليها الحال، بما في ذلك المؤسسات التعليمية المتخصصة ودارسي الإعلام أنفسهم، وكذلك عدم استثمارهم العملي للفضاء الجديد الواسع والمتجدد، أدى إلى خسارتهم فرصًا قيمة تفوق بكثير الحال التي استكان إليها كثيرون منهم، فقد كانوا حيال منجمٍ ثري لا ينضب، لم يحسنوا التعامل معه، ويومًًا بعد آخر كانت المؤشرات كافية للتأكيد على أن المأزق الذي وجدت فيه الوسائل أنفسها، هو أكبر مما كان متوقعًا، وأن معظم الوسائل القديمة لم تحسب للبيئة الجديدة حساباتها، وزاد الأمر سوءًا عدم فاعلية محاولات المواكبة في التعامل، إذ كُتب لمعظمها الفشل، لأنها ركنت إلى اجتهادات المجتهدين، باستثناء النزر اليسير الذي تمكن من الخروج من المأزق وبات يُنظر إليه على أنه نموذج يشار إليه بالبنان، من أبرزها “نيويورك تايمز” و”الواشنطن بوست”، فالأولى فطنت جيدًا لأبعاد التغييرات، ومآلاتها، فبادرت باتخاذ خطوات إستراتيجية منذ البدايات العملية للنشر عبر الإنترنت.

نموذج “نيويورك تايمز”
قرأت صحيفة “نيويورك تايمز” العملاقة، المشهد مبكرًا وبادرت باتخاذ خطوات جريئة، تؤكد على ممارستها الحقـّة لمفهوم العمل المؤسساتي، إذ خلت تلك الخطوات من مغبة العرف السائد في معظم المؤسسات الإعلامية التي تؤمن بأن الإدارة العليا يجب أن تكون لهذا اليد الطولى في سائر شؤون المؤسسة، فقد أدركت أن القادم الجديد هو نتاج تكاتف أطراف أخرى يجب أن تكون حاضر بقوة في كيفية التعامل معه، ظهر هذا جليًّا في إعلان استباقي نشر في شكل خبر صحفي قبل أكثر من ربع قرن، وتحديدًا في 22 يناير من عام 1996م، أشارت فيه إلى عزمها على إصدار أول رقمي على شبكة الإنترنت، وذكرت في ذلك الخبر الصحفي الذي بدا عاديًّا في مظهره، عميقًا في مخبره، بل قد يكون الأهم في تاريخها، أن نموذج نشرها الجديد لا يعدو أن يكون سوى نسخة مشابهة لما تنشره ورقيًّا من أجل أن تصل لشريحة أوسع تشمل العالم أجمع.
إلى هنا والأمر يبدو طبيعيًّا ومتوقعًا، شأنها في ذلك شأن مـَن بدأ في خوض التجربة في شكل جديد، غير أن اللافت هو ما ورد في نهاية الخبر، ونصـّه: “إن ما نقوم به هو جزء من إستراتيجية تهدف لمنح فرص لشركة الصناعة الإعلامية الإلكترونية التي أنشأتها الصحيفة في عام 1995م، لتطوير منتجات في حقل النشر الرقمي المتنامي”.
لم يكن هذا النص كما قد يتوقع البعض تعبيرًا إنشائيًّا لتعظيم قيمة الخبر، أو أنه رهان خاسر قد لا يُعمّر طويلاً، لكنه كان خطوة علمية وعملية ذات دلالات عميقة ظهرت نتائجها بجلاء فيما بعد، فقد اتضحت جدوى هذا الإجراء في السنوات التالية برهن أن عمل الصحيفة العملاقة يتكئ على ثقافة مؤسساتية مرهفة الحس، ونظرة تؤكد على أن رأسمالها الحقيقي ليس في قيمة الإعلانات التي كانت تدرها عليها الجريدة الأشهر في ساحة الإعلام المطبوع، وذلك على الرغم من أهميته وإنما يتجاوزه إلى أصل نشأتها القائم على صناعة بضاعة تتنوع في أشكال تحريرية مختلفة منها الخبر والتقرير والحوار والصورة والحوار والمقال، وأن جوهر هذه الأشكال في واقع الأمر مواد خام مرنة (منتج أو بضاعة) يمكن استثمارها في منتجات أخرى يتم تطويعها حسب مقتضيات النشر التي تفرضها المتغيرات، وكانت تدرك تمامًا في هذا الشأن أن سرَّ نجاحها وتميزها يكمن في جودة منتجها الذي يكاد لا يجاريها مصدرٌ إعلامي آخر، وهو مبدأ لا تحيد عنه ولا تسمح بأن يشغلها عنه جوانب ليست في صلب العمل الإعلامي.
وعلاوة على ذلك، تبين أنها كانت تدرك جيدًا، وفق ما يقتضيه المفهوم الصحيح والدقيق للعمل المؤسساتي، أن نجاحها في المضمون لا يعني الانشغال بتخصصات خطوط إيصال المنتج ومقومات تهيئته لمجرد أنها توجد ضمن الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتجهيزه وتقديمه للآخرين، بعبارة أخرى لم يكن لها أن تخلط بين ثروة المحتوى التي يتقن طاقمها الصحفي صناعته، وبين شكل الوسيلة (Form) ومدى قدرتها على الوصول الفعال للجمهور المستهدف، فقد نظرت إليه على أنه جانب تقني في أساليب نشر لا يحسن طاقمها التعامل معه أو قد لا يفهمه على الإطلاق، وانصب تركيزها على ضمان استمرار تفوقها في صناعة المحتوى، السلعة التي كسبت عبرها منذ نشأتها سمعتها، وتمكنت من خلالها تشكيل صورتها التي بوأتها المكانة الأبرز بين الصحف، موقنة أن ولاء المتلقين وتعطش الباحثين عن “بضاعة” المحتوى الجيد سيزداد، في مرحلة ضباب قاتم قادم قوامه الشائعات وتلفيق المعلومات بعد أن تُرك الحبل على الغارب لكل أحد كي يغرد في فضاءات متناهية، فوجب عليها ألا تنشغل كما فعلت قريناتها بالوسيلة عن الهدف، فحافظت الصحيفة على مقومات نجاحها، وبخاصة كوادرها البشرية من أصحاب الخبرة الطويلة وذوي المهارة العالية في العمل الصحفي الذين لم تستطع تلك القرينات الحفاظ عليهم، وذلك بعد أن عجزت معظم الوسائل التقليدية عن الوفاء بحقوقهم.
هذا الإدراك العميق لمتغيرات البيئة الجديدة ومستقبلها، جعل الـ”نيويورك تايمز” تبذل جهودًا مضاعفة في الحفاظ على المحتوى الإعلامي وتطويره، وأوكلت مهمة معالجة أزمة الوسيلة لأهل الاختصاص، ومنحتهم صلاحيات البحث عن الحلول.

بعبارة أخرى، لم ينشغل المهنيون الذين يشكلون جزءًا من ثروة المعمل الصحفي في “نيويورك تايمز” بهاجس مستقبلهم، أو الدخول في معمعة مقاومة الطوفان، وكفتهم عن القيام بذلك شركة الصناعة الإعلامية الإلكترونية، ذات الكوادر المؤهلة التي تحسن تشخيص الأدوات التقنية وتقدم العلاج الأنسب لاستثمار منتجها كما يجب، واضعةً نصب عينها رأسمالها الأصيل المتمثل في سلعة قيمة عُرفت بها منذ بزوغ نجم الصحافة الحديث، وبهذا الإجراء كانت على يقين أن اندفاع الهواة والعامة في ممارسة النشر، وفق إمكاناتهم محدودة، وتخبطاتهم العشوائية ستظلّ عاجزة عن المنافسة، وأن تمسكها القوي بثروة المحتوى، والعمل على تجويده سيقطع الطريق على المزايدات، أمام جمهور واعٍ يميز بين الغث والسمين، ولثقتها التامة في شركتها الوليدة، تفاعلت الصحيفة إيجابًا مع كل ما يشير به أصحاب الشأن بها، ولم تمانع في أن تضحي لسنوات في تقديم بضاعة النشر مجانـًا لسكان العالم أجمع، في إطار إستراتيجية تسويقية دقيقة، حتى إذا تهافت كثيرون على استهلاك أخبارها وموادها التحريرية الجاذبة، بدأت في تقديم عروض تدريجية لهم، كان من بينها أن تسمح للقاري بعدد محدد في الشهر من موادها، ليضطر كثيرون إلى الاشتراك بعد أن أيقنوا أنهم لن يحصلوا على بضاعة نشر أجود.
ووفقًا لهذا النموذج المبتكر، أصبحت الصحيفة تسير في خط تصاعدي مذهل، لم يكن ليتحقق من دون واقعيتها، التي اتسمت بالسباحة مع التيار والبحث عن مواطن الفرص، بخلاف السواد الأعظم من صحف العالم التي كانت تبدو سابحة عكسه، فشُغلت وانشغلت بما عطّل مسيرتها.
باستعراض هذه التجربة، وما تمخض عنها من نتائج باهرة، يمكن أن نصل إلى نتيجة، قد لا تعجب الإدارات العليا للوسائل التقليدية، أن السبب الرئيس في تراجع تلك الوسائل وتلاشي العديد منها هي تلك الإدارات التي أصرت على مواجهة التغيرات وفقًا لرؤيتها الضيقة والمحصورة في مجال مختلف عن مجال خبرتها، وهو الخطأ الذي كانت ستقع فيه “نيويورك تايمز” لو سلكت المنهج نفسه.
لعل من المفارقات أن علامات انحسار شعبية الإعلام التقليدي ظهرت في أوج العصر الذهبي للصحف ووسائل الإعلام التقليدية عمومًا، فكانت قبل حلول الإنترنت تمتلك من الموارد المالية ما كان يمكنها من الاستفادة من التجارب الناجحة، وبخاصة تجربة أوسع الصحف الأمريكية انتشارًا، التي أعلنت في الخبر المذكور خطتها القادمة، مما يعني أنها لا تمانع في تعريف الآخرين بإستراتيجيتها التي ربما تجاهلها كثير من المؤسسات، فتساقطت الواحدة تلو الأخرى، إذ توارت عن الأنظار صحف عريقة تجاوز عمرها المائة عام على غرار صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور”، حتى الصحف التي حاولت المقاومة باجتهادات غير المختصين لم تسلم من هزات عنيفة أفقدتها كثيرًا من وهجها الذي عُرفت بها، كما حدث مع مجلات عريقة مثل:”التايم” و”النيوزويك” و”الإيكونيميست”.

نموذج “الواشنطن بوست”
لم يكن قطب الصحافة الأمريكية الثاني صحيفة “الواشنطن بوست” الوسيلة العملاقة المنافسة للـ”نيويورك تايم” أن تسلم هي الأخرى من الإعصار العاتي، جاء ذلك لعدم تبني الصحيفة، كما فعلت منافستها، إستراتيجية واضحة في التعامل مع التغيرات، ولم يكن لديها – ربما لضبابية الأفق – خطة عمل واضحة تحدد آليات التحول، فأوشكت أن تقع في مهب الريح، وبدأ الضعف سنة بعد أخرى يسري في شرايينها، وظهر ذلك بجلاء في انحسار كبير في حجم الدخل الإعلاني والاشتراكات، حتى إذا دبّ اليأس في أوصالها، وباتت الخسائر تهدد كينونتها، لم تجد عائلة “غراهام” التي هيمنت على الصحيفة لثمانية عقود بدًّا من عرضها للبيع في الوقت الصعب، وتحديدًا في عام 2013م.
وتوقع كثيرون أن الصحيفة ستلحق بغيرها، لتطوي وراءها تاريخًا لا ينساه عالم الصحافة، وهي الصحيفة التي ظلت بحكم تواجدها في عاصمة صنع القرارات العالمية حاضرة بقوة في دهاليز السياسة الأمريكية، ومنبرًا قويًّا من منابر عاصمة القوة العظمى، إذ يكفي أنها كانت السبب يومًا ما في إجبار الرئيس “نيكسون” على تقديم استقالته في أعقاب فضيحة “ووتر جيت” الشهيرة التي قدح شرارتها صحفيان ينتميان إليها في تقرير ترددت أصدائه في أركان المعمورة.
وكان السؤال الأبرز هو: مـَن الذي سيقدم على الشراء في الوقت الذي بات فيه كثير من الصحف تغلق أبوابها؟ وبات جليًّا أنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا مـَن لم يكتوا بنيران البدائل الجديدة، فقد يدرك شيئًا مختلفًا عمـّا يعرفه المنكسرون، ولا يأبه بنظرة المراهنين على الإخفاق، كانت الصحيفة بحاجة إلى شخصية تمتلك مواصفات خاصة، تعرف جيدًا موطن الخلل، كما تعرف تمامًا وصفة العلاج، تنظر من زاوية النشر الرقمي الحقيقي بعين الخبير، بعيدًا عن إطار محدود طوق آفاق أصحاب المهنة، على أن يكون في الوقت نفسه ممّن يقدر دورها الإعلامي وتميزها في صناعة المحتوى.
كانت المفاجأة، ولحسن حظّ الصحيفة، أن تقدم للصفقة رجل أعمال من طراز فريد، صاحب تجربة ناجحة في التجارة الإلكترونية، يتحدث بثقافة السلع والمنتجات كما تملي عليه طبيعة مجموعته الاستثنائية العابرة للحدود، ذلكم هو مؤسس مجموعة “أمازون” جيف بيزوس الذي لم يتردد في أن يدفع رقمًا فلكيًّا لشراء الصحيفة بمبلغ ربع مليار دولار أمريكي.
كان مجلس إدارة الصحيفة، لإدراكه طبيعة الخطأ الذي وقعت فيه الصحيفة في تطبيق الإدارة المركزية على كافة خطوط إنتاجها المهنية والتقنية، على قناعة بأن “جيف بيزوس” هو الخيار الأفضل بين سائر الراغبين في الشراء، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي السابق للصحيفة “دونالد غراهام” الذي قال: “إن تميزه في عالم التكنولوجيا والأعمال هما الخاصيتان اللتان جعلت منه مرشحًا مميزًا، فذلك كفيل بأن يُخرج الصحيفة من التحديات التي واجهتها في السنوات الأخيرة”.
هذا التصريح جاء ليؤكد أن الخلل الحقيقي الذي وقع فيه الإعلام التقليدي لم يكن بسبب إشكالية في الخبرة في عالم الصحافة والإعلام، ولكن يكمن في الثقة في الذات أو الاعتداد بها في الوقت الخطأ، مما أدى إلى غياب حسِّ الخبير في قطاع الأعمال، وأنها بحاجة كذلك إلى أن يكون هذا المرشح للشراء يتمتع بتجربة ثرية في التسويق الإلكتروني الذي تفتقده الصحيفة، ومن سيكون أفضل من مالك موقع “أمازون” في هاتين المزيّتين.
اللافت أن المالك الجديد عندما التقى بهيئة تحرير الصحيفة حاول أن يغرس ثقافة جديدة لديهم تقوم على أهمية تسويق بضاعتهم، ولخصت إحدى الصحف التي تحدثت عن فحوى حديثه لهم في عبارة توجز التوجه الجديد بقولها: “إنه أبلغهم أنه يجب ألا يستمروا في العيش في الزمن الماضي”.
حقوق الملكية: ضوء جديد في النفق!
لم يكن للخسائر الفادحة التي تكبدتها معظم وسائل الإعلام أن تفت بشكل سريع في عضد القائمين عليها، بل إنها في كل مرة تظهر مؤشرات إيجابية تحكي نجاحات النماذج القلائل، يستبشر أصحابها على أن هناك حلولاً ما من شأنها أن تعيد لها شيئًا من الماضي، عدا عن حقيقة أن الكثير منها حاول على مدى العشرين السنة الماضية، أن يلتقط نفسه لأكثر من مرّة، وشيئـًا فشيئـًا بدا كالسباح الماهر الذي استنزفت الأمواج عنفوانه، حتى وصل إلى مرحلة اقتنع معها كثيرون أن الخطر قادم لا محالة، بخاصة وأن شواهدها ظهرت بقوة في توالي انهيار مؤسسات وكيانات إعلامية كانت ملء السمع والبصر.
ولأن وسائل الإعلام المحلية في كل دولة تمثل أداة مهمة من أدوات الأمن الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لها، أدركت بعض الدول أن خسائر وسائلها الوطنية، هو تهديد لأمنها الوطني، مما يعني وجوب الحفاظ على سلامتها، وألا تسمح لتنين شركات المعلومات والشبكات الاجتماعية الوافدة أن تمسخها وتلغي كياناتها، وظهر هذا بجلاء مع الدول الأوروبية التي تصدت مؤخرًا لهذه الشركات، ولم تتوان عن تضييق الخناق على أساليب نشرها للمعلومات وفقًا لضوابطها التشريعية وقوانينها التنظيمية.
ففي هذا الإطار اتخذت بعض الدول إجراءات صارمة تجاه شركات النشر الرقمية العملاقة، شملت في بداياتها عقوبات في هيئة غرامات مالية على غرار قيام الاتحاد الأوروبي بتغريم محرك البحث الشهير “قوقل” قرابة عشرة مليارات دولار، وواصلت تطبيق سياسة الغرامات مع شبكات التواصل الاجتماعي نظير إخفاقها في التصدي للمعلومات المغلوطة أو ما يتضمن رسائل تحثُّ على الإرهاب أو الكراهية، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل هددت بعض الدول، من بينها بريطانيا، هذه الشركات بإيقاف خدماتها محليًّا.
هذا التهديد والتصدي، ألهم وسائل الإعلام وبخاصة في فرنسا، بالبحث عن الثغرات التي كانت غائبة عن كثير من الوسائل، ووجدت أهمها بالنسبة للوسائل، والتي تكمن في تعدي وسطو الشركات والشبكات الرقمية المباشر وغير المباشر على حقوق ملكية الوسائل الإعلامية لكم هائل من المضامين القيمة التي شكلت ولسنوات عديدة مادة ثرية لانتشارها، وتأسيسًا على حقيقة أن النشر الإعلامي المعروف في عمومه بالتزامه بقيم مهنية عالية يثق فيها الجمهور بأنواعه، أدركت أن كونها المرجع الأقوى الذي يلجئون إليه للتحقق من مصداقية مواد النشر من عدمها.
ولأن الوسائل الجديدة تعرف أهمية هذا البـُعد، وضرورة المحافظة عليه، لم يكن أمامها سوى الانصياع للمطالب المشروعة لملاك المحتوى، وكان من أوائل ثمار استجاباتها، ما نقلته وكالة “رويترز” عن أن حكمًا قضائيًّا صدر في فرنسا في بداية هذا العام يلزم “قوقل” بأن تفتح قنوات اتصالية مع الناشرين في هذا البلد الأوروبي للقيام بدفع مقابل مادي مجزٍ نظير استخدامها لمضامين وسائلهم، ولأن القرائن والحجة قوية، فقد تمِّ في أقل من شهرين التوصل لما يثبت أحقية الناشرين بمطالبهم، وبدأ بالفعل تنفيذ ما هو في صالح الوسائل الإعلامية الفرنسية، وانتهى الأمر بتوقيع الشركة في منتصف شهر نوفمبر من هذا العام اتفاقًا مع ست صحف ومجلات فرنسية من بينها “الليموند” و”ليفارغو” تحفظ لها بموجبه “قوقل” حقوق ملكيتها للمواد التي تنشرها، ولم يكتف محرك البحث الضخم بتبيان هذه الخطوة؛ بل نشر بيانـًا أوضح فيه أنه بصدد التوقيع على إطار عمل مع نقابة الصحف الفرنسية قبل نهاية العام.
كان حريًّا بهذا الاختراق التاريخي في صناعة الإعلام أن يدفع دولاً أخرى إلى أن تحذو حذو فرنسا، وتحاكي تجربتها، إذ سرعان ما انتقلت المطالبات إلى الطرف الجنوبي من الكرة الأرضية، فأثار البرلمان الأسترالي الموضوع ذاته في 24 فبراير من هذا العام، وانتهى إلى إصدار قانون يلزم مجموعات تكنولوجيا الاتصال العملاقة بدفع أموال تعويضية لوسائل الإعلام مقابل نشر محتوياتها.
وعلى الرغم من محاولة “فيسبوك” الخروج من المأزق بالتصدي ابتداءً للخطوة الأسترالية عبر خطوات عملية من بينها إحجامها في ذلك البلد عن نشر كم هائل من روابط المواد الإخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دولية ردًّا على مشروع القانون، وانسياق بعض شبكات التواصل الاجتماعية الأخرى معها، إلا أن مواقفهم اصطدمت بتحديات أكبر قد تقود إلى خسائر أكبر على المستوى العالمي، وكان من ملامحه إعلان رئيس وزراء أستراليا “سكوت ماريسون” أنه تلقى تأييدًا من قادة العالم فيما ذهبت إليه أستراليا، وفي ذلك رسالة قوية إلى حجم التبعات التي قد تطال الشبكة، ولعل ذلك ما يُفسر تراجع شبكات “إنستغرام” و”واتساب”، عن مواقف مشابهة، وأبرامهما لاتفاق مع أستراليا لضمان حقوق ملكية المحتوى.
هل سيعود المجد المفقود؟
استبشر كثير من وسائل الإعلام العالمية بالحدثين الفرنسي والأسترالي، وأشادت بمواقف الحكومتين الحازم تجاه شركات المعلومات وشبكات التواصل، فتأملت أن يكون انتزاع حقوق الملكية المستحقة هو بداية الطريق للعودة إلى المكانة التي كانت عليها المؤسسات الإعلامية سابقًا، وربما السؤال الذي يطرح نفسه: هل الأمر على إطلاقه؟
الإجابة تستدعي النظر جليًّا في القيمة الحقيقية للمضامين المتنازع عليها، إذ شتان بين السلعة الثمينة التي لا تتوافر عند الوسائل الأخرى، وبين سلعة مشاعة يصنعها الأفراد والعامة، ذلك أن المحتوى الإعلامي الذي يرقى إلى مستوى السلعة أو البضاعة، هو الذي تتوافر فيه مقومات صناعته الحقيقية شكلاً ومضمونـًا، ويجد فيه المتلقي قيمة مضافة تدفعه إلى الرغبة الأكيدة في الحصول عليه.
لذا، فإن البشرى يمكن أن تكتمل، ويمكن للوسائل أن تتفاءل في حال نأت الوسائل أنفسها عن العيش في الماضي، وعملت على إنتاج بضاعة قيمة متكاملة تستحق تنطبق عليها مواصفات الملكية ثمينة، وهذا يعني أن تراجع الوسائل نفسها حساباتها فيما يتعلق بهذا الجانب، وتستوعب تمامًا معنى حقوق الملكية الذي لم يحترمه بعض منها كما يجب، بخاصة مع مـَن يعمل بها أو مـَن تستقطبه أو تستضيفه للمشاركة بمادة إعلامية، في إيحاء بأنها صاحبة الفضل عليه، وهو ما يؤدي إلى إحجام الأكفاء عن التفاعل، مما يقود إلى كساد البضائع وضعف أثرها.