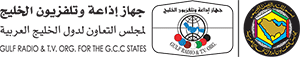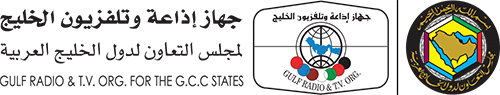لماذا غاب التلفزيون عن المدرسة؟
في وقت مضى، حكم التربويون بشكل مسبق على وسائل الإعلام ‒ بخاصة التلفزيون ‒ أنها الخصم الأول للتربية، والمعوّل الأساس المقوّض لجهود التعليم، وعوضًا عن التصدي لهذا الحكم ممّن هو قادر على تفنيد قبوله على إطلاقه، صدّق السّواد الأعظم من المجتمع، أفراد ومؤسسات، هذا التهمة وسلّموا بمضمونها؛ بل إن كثيرًا من المصلحين الاجتماعيين تبنوها ووجدوا فيها مسارًا فسيحـًا للتأكيد عليها والتذكير بمخاطرها، وتشدد البعض في موقفه لينادي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه هذه الأدوات “الهدامة” ووسائل “الغزو الفكري والثقافي”، حسب تعبيرات رُوِّج لها، وغدت مألوفة في المحافل وقنوات النشر والمجالس العامة. !
أقل المنتقدين لوسائل الإعلام حدةً، دعوا من جانبهم، وبنبرة لا تخلوا من الوصاية تارة ومن الفوقية تارة أخرى، دعوا إلى أن تكون تلك الوسائل سندًا في إيصال الرّسالة التعليمية، وأن تقتدي بالمدرسة في أسلوب تعليمها لطلابها، من دون معرفة دقيقة لسمات كل وسيلة، وسُبل تشغيلها، ومقومات جذبها وتأثيرها، ومن دون فهم تام لطبيعة نشاط الإعلام بشكل عام وبيئته، ولعل مما يؤخذ على هذه الفئة عدم مبادرتهم إلى محاولة العمل بجدية على إيجاد شراكة حقيقية بين الطرفين تمكّن كوادر التعليم من استيعاب ثقافة الصناعة التلفزيونية، التي لا يمكن ‒ حسبما يعرف أربابها ‒ أن تقوم على التلقين الجامد أو الإملاءات التي تعدّ ‒ إن هم قبلوا بها ‒ بداية الطريق إلى الفشل والإخفاق.
باختصار، كان من أبرز الأسباب التي حجمت الاستفادة من التلفزيون في حقل التعليم، تطلع التربويين إلى أن يقوم الإعلاميون بدور مشابه لهم في ضوء الأهداف التعليمية، وتسلّحوا في موقفهم ذلك بجلالة مهنتهم التي يقدرها جميع أفراد المجتمع، وبطبيعة الحال لم يكن للإعلاميين أن يستجيبوا لذلك، لأنه يعني في منظورهم التخلي عن الديناميكية التي يجب أن تتسم بها العملية الإعلامية، التي تضمن جذب الجمهور وتشويقه وتفاعله، انطلاقـًا من حقيقة أن حجم الجمهور هو معيار إقبال المعلن ‒ مصدر الدعم المالي الرئيس لوسائل الإعلام ‒ على الوسيلة، وهذا يعني أن هناك تفاوتـًا في الأولويات بين الطرفين في الأهداف على نحوٍ يؤدي إلى التباين في صناعة المواد من حيث المضامين، والأشكال وطرق عرضها.
لقد كانت العلاقة بين التعليم الإعلام تقوم في معظمها على التوجس، وعدم الثقة، لتنشأ بينهما قطيعة طويلة كان من نتائجها خلو خطط التعليم ‒ إلا فيما ندر ‒ من محاولة استثمار أدوات الإنتاج التلفزيوني كوسائل تعليمية، وكأنَّ استخدامها ‒ ابتداءً ‒ في صناعة وبثِّ المواد يتنافى مع أخلاقيات التربية ومبادئها ويحيلها إلى أدوات منبوذة، وربما نظر إليها البعض على أنها من المحرمات عرفيًّا (Taboo) ولا تتسق مع بيئة المدرسة.
لقد كان من تبعات الحكم المسبق الذي أشرنا إليه آنفـًا، أنه شكل ضبابـًا كثيفـًا حجب الرؤية طويلاً وقاد إلى عدم التأمل في جملة من الحسنات والإيجابيات التي كان يمكن أن تجعل من الإعلام شريكـًا لا يبارى للتعليم، وفي الوقت الذي لم يشفع للإعلام حقيقة اشتراكه مع التعليم في أنهما مشتقان في مسماهما من أصل واحد، وهو الفعل الثلاثي “علم”، وغاب عن أنظار المؤججين حقيقة مفادها أن نشاطي التعليم والإعلام يجمعهما مسار الاتصال، وأنهما يعملان في إطار ديناميكي متشابه؛ بل متماثل، عناصرهما واحدة وإن اختلفت مسمياتها؛ إذ إن كلاً من العملية التعليمية ونظيرتها الإعلامية تتألف من: “رسالة ومرسل ووسيلة ومستقبل وردة فعل تشكل النتيجة المتوخاة أو الهدف من القيام بنشاط هذه أركانه ومكوناته”، ليس هذا فحسب؛ بل إن اتهام الإعلام، وبخاصة التلفزيون، بالإضرار بالتعليم انطلق في حقيقته من اعتراف ضمني بأنه أداة مؤثرة، وفاعلة في إحداث التغيير في المعرفة والسلوك الذي هو الهدف الرئيس للتعليم، وعوضًا عن أن يتم توظيف هذه الأداة الجديدة إيجابًا من قبل المؤسسات التعليمية اكتفى القائمون على التعليم بالتحذير منها، ولم تبذل جهود تذكر لتعرّف أسباب قدرتها على سلب الألباب طواعية، وليس إكراهًا كما هي عليه الحال مع طلاب المراحل المبكرة على وجه التحديد.
قد لا يكون ذلك الاختلاف في ظاهره غائبًا عن الأذهان لدى البعض، لكن تفاصيله من حيث التكاليف المالية، وتوفير الإمكانات البشرية والفنية التي تحتاج إلى عناية من نوع استثنائي يمكنه التوفيق بين الأهداف، ليست واضحة كما يجب، ولم يكن لها أن تكون كذلك في ظل غياب لغة مشتركة أو تقارب تام يقوم على احترام التخصص والاستفادة من إمكانات كل طرف بالصورة المهنية الفاعلة، وكان مؤكدًا أن محاولة التفرد باستخدام المقومات من دون الاستعانة بالآخر يؤدي إلى اتساع الفجوة ولا يحقق المبتغى، ولعل محاولات المؤسسة التعليمية تطبيق مفهوم “التربية الإعلامية” التي لم يكتب لها النجاح، خير شاهد على ذلك.
وغني عن القول إن البحث عن القواسم المشتركة وسُبل التعاون بين التعليم والإعلام لو تحقق، لكان حريًا بأن يُسهم في نجاحهما للوصول إلى أهداف ثرية ومثمرة تنعكس إيجابًا بصورة مضاعفة على المجتمعات بكافة فئاتها، فإدراك التعليميين لعمق نشاط الاتصال في العملية التعليمية كان من شأنه أن يؤصل لأهمية تفعيل الحسّ المهاري الاتصالي الذي هو أصل في تفعيل إيصال الرسالة بالطريقة السليمة والشائقة، التي افتقدتها كثير من قاعات الدراسة، وانعكست سلبًا على نظرة الطلاب للتعليم، وأدى إلى عجز ملحوظ لدى المؤسسات التعليمية في بناء العلاقة الحميمة المفترض وجودها معهم.
وغني عن القول إن إلقاء اللائمة في حدوث الفجوة بين تخصص التعليم والإعلام على المؤسسات التعليمية المشرفة على التعليم وحدها يتنافى مع الإنصاف؛ ذلك أن هذا التقارب المنطقي بينهما كان مفصولاً في الأساس بأسوار الأقسام الأكاديمية المنيعة بين أقسام التعليم والإعلام، شأنهما في ذلك شأن كثير من التخصصات التي أغفلت العلاقات البينية بين العديد من الأنشطة الحياتية في الواقع، والتي تئد بكل أسف فرصـًا ثمينة وقيمـًا مضافة يحتاجها المجتمع ومؤسساته، إذ غرقت معظم هذه الأقسام في وهم الاعتداد بالذات على نحوٍ يعطل مسيرتها أحيانـًا، ويفوت عليها مجالات مهمة في التطوير والتقدم.
كان للعلاقة البينية بين تخصصي التعليم والإعلام أن تنشأ وتترعرع في كنف الحقل الأكاديمي، ليقود الميدان إلى الوسائل الأقوى في إيصال المعرفة، بخاصة في المقررات التي تتطلب تجسيدًا لمضامينها، وكان يمكن للتعاون بين الجهات ذات العلاقة أن ترتقي بالتحصيل العلمي إلى أعلى مراتبه.
لنا أن نتخيل ‒ على سبيل المثال ‒ لو قامت وزارات التعليم ‒ بالتعاون مع مؤسسات الإعلام ومراكز بحوث التاريخ أو المكتبات العامة ‒ بإنتاج مواد فيلمية شائقة، ذات إخراج مهني رفيع، لتُقدَّم في حصص التاريخ للطلاب في كافة مراحل التعليم عوضـًا عن الأسلوب التقليدي المعروف.
هنا لن يحاجنا أحد بالقول إن مشاهدة مثل هذا المنتج ستكون قليلة…فنحن سنظفر بالنشء في لحظات تواجدهم الجسدي وتركيزهم الذهني بقاعات الدراسة، ونوصل رسائلنا بالشكل المطلوب.
ولتعرّف الأثر المتوقع حينها علينا أن نقارن بين درجة الاستيعاب والفـَهم الذي ستتحقق من مشاهدة الطلاب ‒ مثلاً ‒ لفيلم “ولد ملكـًا” الذي يجسد رحلة الملك فيصل ‒ رحمة الله ‒ إلى بريطانيا، مقارنة بمستوى الفـَهم والتفاعل في حال الاكتفاء بقراءتها أو مجرد سماعها من أستاذ المقرر على تفاوت مستويات ومهارات تواصلهم.