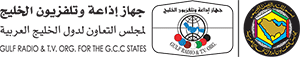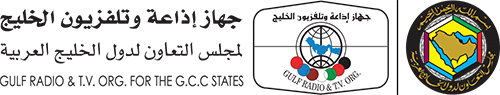حماسٌ شديدٌ وتركيزٌ عالٍ قاد مجموعة من الباحثين من مختلف تخصصات العلوم الإنسانية إلى تحليل إحدى الأساليب التي مكّنت أفرادًا بعينهم من إقناع الآخرين والحصول على القبول منهم والتأكيد، إلى جانب المشاركة الواسعة في قضية الرابح فيها طرف واحد فقط، بينما الضحية جماهير لم تكن تدرك لماذا وكيف تفاعلت عقولها التي تساق من دون هوادة نحو مصير مجهول، فالماكينات تعمل ليل نهار، والأساليب تتغير، والرابط المشترك بين مـَن يدير هذه الماكينات هو «الكذب».
اكذب أكثر حتّى تُصدّق نفسك
«اكذب، اكذب، ثمّ اكذب حتّى يصدقك الناس، ثم اكذب أكثر حتّى تصدق نفسك» تلك الحسنة الوحيدة التي خلّفها الوزير الألمانيّ «جوزيف غوبلز» لكلّ من تصدى لإدارة ماكينات التضليل الإعلامي في وقتنا الحاضر، كيف لا وهو مهندس الدعاية الألمانية ووزير الدعاية السياسية في عهد «أدولف هتلر»، وقبل ذلك هو مؤسس صحيفة (The Attack) «الهجوم» الأسبوعية في عام 1927م، والتي كانت تمثل الحزب النازي آنذاك، ليشغل بعدها منصب الوزير العام للدعاية في عام 1933م، في حين كان هتلر المستشار.
و»غوبلز» الذي استخدم منصبه الرسمي ليشرف على محتويات الصحف، والمجلات، والكتب، والراديو، والأفلام، لم يقف عند هذا الحد؛ بل إنه تصدّى لكلّ فن جميل، فعاث في استخدامات الموسيقى والمسرحيات؛ وهدفه الوحيد كان يتمثّل في ترسيخ فلسفة هتلر العدائية وإثارة الكراهية.
وحماس الباحثين لعله قاد إلى أسطورة «رجل الدعاية»، فكان من اللازم أن يتساءلوا عن مكامن قوته في استخدام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، وكيف استطاع التأثير والسيطرة في مواقف وأفكار وسلوكات الجماهير.
فـ»هارولد لاسويل» (Harold Dwight Lasswell) على سبيل المثال لا الحصر، وهو عالم الاجتماع الأمريكي الذي كتب في عام 1927م، حول تكتيكات الدعاية في الحرب العالمية الأولى، قال: «ما كان في السابق يتمُّ تحقيقه بالعنف والقهر، فإنه الآن يمكن أن يتمَّ عن طريق الجدل والإقناع»، فعن أيّ جدل وعن أيّ إقناع كان «لاسويل» يتحدث؟.
أعطني إعلامـًا من دون ضمير أُعطيك شعبـًا من دون وعي
عندما بدأت الحرب العالمية الثانية عام 1939م، استطاع «غوبلز» أن يدير وسائل الإعلام بفاعلية، بحسب ما سطـّرته الروايات التاريخية، والتي أشارت إلى أن هذا الرجل كان يقول: «ليست مهمّة الدعاية أن تكون دعايةً جيدة، بل أن تحقق النجاح»، إلى جانب أنه كان يقول: «أعطني إعلامـًا من دون ضمير، أُعطيك شعبـًا من دون وعي»؛ إلا أنه وفي نهاية المطاف أقدم على الانتحار مع زوجته وأطفاله الستة الذين كانت تتراوح أعمارهم بين الرابعة والحادية عشرة عامـًا، ليُخلّف لـمـَن أراد استخدام ماكينات التضليل مقولته الشهيرة «اكذب اكذب حتـّى يصدقك الناس وحتـّى تصّدق نفسك أيضًا».
اليوم، وفي ظلّ بيئة الإعلام الجديد، يبدو أن مقولة «غوبلز» تـُستخدم على نطاق واسع، وبطرق حديثة تفرضها البيئة الجديدة لوسائل الإعلام والاتصال الجماهيري؛ بخاصة أن أخلاقيات ومبادئ الاتصال أصبح من اليسير انتهاكها أو حتـّى عدم الالتزام بها؛ وهو الأمر الذي يطالب من أجله كثيرون بإيجاد ميثاق شرفيٍّ وأخلاقيٍّ لاستخدامات شبكات وقنوات الاتصال الجماهيري.
ولعلنا نشير في هذا السياق إلى ما نشرته وكالة «فرانس برس» على يد «سفيتكوفسكا ساسكا»، حينما كتبت قصة خبرية تحت عنوان: «الأيدي الخفيّة وراء صناعة التضليل الإعلامي في مقدونيا»، إذ تقول: «إن طالبًا يبلغ من العمر (20) عامـًا استطاع أن يحجز لنفسه إجازة في اليونان بعدما تمكّن من كسب (200) يورو في الشهر للمساهمة في تدفق سيل الأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت»، وبحسب رواية الوكالة، فإن هذا الطالب الذي يعيش في بلد فقير في البلقان، تمكّن في عام 2016م، وهو المتخصص في التكنولوجيا، من خوض غمار السباق لكسب الأموال عن كلّ نقرة لخبر يـُروِّج لأقوال عنصرية أو حتـّى يورد معلومة ملفقة عن أشخاص بعينهم في مواقع المشاهير والسيارات ونصائح التجميل، وعلى الرغم من أن هذا الطالب يرفض الكشف عن هويته، إلا أن الوكالة أوردت تعليقـًا لشخصٍ يدعى «بورتزي بيتزيف»، وهو مصمم مواقع على شبكة الإنترنت يقول فيه: «لقد أدرك الناس أنه يمكن تحقيق الأموال من السياسة أيضـًا».
والمسألة هنا يبدو أنها تعتمد إلى درجة كبيرة على أساليب الدعايات المعروفة، فهناك مـَن يستأجر الآخرين، وهناك مـَن يدير ويتحكم بالآلة الإعلامية، وهناك مـَن بحاجة إلى الأموال فلا رادع يمنعهم طالما أن المسألة لا تتجاوز نشر الأخبار والتعليقات الرسمية، والتي يتمُّ «تكييفها أو تعديلها قليلاً، ويُضاف لها عنوانــًا يشدُ القارئ»؛ لأغراض شتّـى.
وإذا كنّا اليوم أمام إستراتيجية جديدة تعتمد على أسلوب النشر، النشر، ثم النشر حتّى يُصدّق الناس، فليس مهمـًا بالنسبة للقائمين بالنشر إن كانوا يميلون لدول أو لأشخاص بعينهم، فالمهمّ بالنسبة لهم هو كسب ما يكفي من الأموال من خلال إيجاد آلية متجددة للوصول للجماهير.
وإذا كانت تلك حسنة بالنسبة لمسيّري ماكينات التضليل، فهي سيئة بالنسبة للمتخصصين في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري، فهم الذين يدركون مختلف التأثيرات التي تحدثها وسائل الإعلام ورسائله، ومن هذا المنطلق فهم يشيرون إلى أن الوسيلة الإعلامية إذا كان البعض يعتبرها سلاحـًا وأداة من أدوات الحروب الباردة، فيمكن القياس على ذلك باعتبارها أداة للسلم في الجانب الآخر.
في هذا السياق، يقول الدكتور علي بن دبكل العنزي، رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود وأستاذ الإعلام السياسي: «الدعاية وجدت منذ أن وجد الاتصال والتجمع البشري، ودائمـًا ما كانت تحاط بسؤال بارز مفاده: ما الهدف منها؟ ولو نظرنا اليوم إلى وسائل الإعلام، لوجدنا أن البعض يستخدمها كسلاح فتّاك يفوق قدرات الأسلحة الحربية، وكانت تستخدم في أوقات الحروب، وبرزت بشكلها المعروف اليوم منذ الحرب العالمية الثانية، وكان يستخدمها «جوزيف غوبلز» مهندس الدعاية النازية على نطاقين، ففي النطاق الأول كان يتبع أسلوب المنافسة، وفي النطاق الثاني كان يتبع أسلوب المواجهة، وفي حالة «غوبلز» مع وسائل الإعلام، كانت المواجهة تعني تقويض الروح المعنوية للعدو ومحاولة هزيمته نفسيـًّّا، واليوم يمكن أن نرى أسلوب النطاق القائم على الدعاية باتباع أسلوب للمنافسة».
ويضيف الدكتور العنزي على حديثه بالقول: «البيئة الإعلامية اليوم، هي بيئة تفاعلية، ولابد للعاملين فيها من أن يحاكوا وأن يتفاعلوا مع واقعها، فكثير من المواقع الإخبارية في وقتنا الحاضر تهدف إلى التضليل وهي آخذة في الانتشار طالما أن جمهور وسائل وشبكات الإعلام الاجتماعي يبحث عن المعلومة، فالأهم أن تكون حاضرًا أولاً بأول بالمعلومة الصحيحة».
وحول آلية مواجهة ماكينة الدعاية المضلِّلة، يشير الدكتور علي العنزي إلى أن السيطرة الكاملة على المعلومة في زمننا هذا لم تعدّْ ممكنة، فوسائل الاتصال ليست تحت السيطرة؛ لذا لابد من العمل على جانبين، الأول يتمثل في التوعية، والثاني يتمثل في توفير المعلومات.
مـَن؟ يقول ماذا؟ بأية وسيلة؟ لـمـّن؟ وبأي قصد؟
المتخصصون في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري يطرحون السؤال التالي في أكاديميات الإعلام: مـَن يتحكم في الآخر .. التقنية أم الإنسان؟ وهم يشيرون في هذه المسألة إلى العلاقة ما بين وسائل الإعلام والتقنية من جانب، ومن جانبٍ آخر إلى العلاقة ما بين الوسيلة والقائم بالرسالة؛ ليتضح لنا من آنف الذكر أن العلاقة ما بين الإنسان والتكنولوجيا تحظى باهتمام متزايد نظرًا لتأثيرات وسائل الاتصال على الفرد والمجتمع.
و»لاسويل» الذي حدد ثلاث وظائف للإعلام: مراقبة البيئة، العمل على ترابط أجزاء المجتمع، الاهتمام بنقل التراث الثقافي عبر الأجيال، لعله كان يشير إلى أننا إذا ما تفاعلنا مع الرسائل التي تصل إلينا عن طريق وسائل الإعلام، فالأسئلة الخمسة جديرة بفكِّ شفرات هذه الرسائل والهدف منها.
فوسائل الإعلام، والتي ينبغي على القائمين عليها أن يشاركوا الجمهور من خلالها بالمعلومات والبيانات حول مختلف الحوادث والمشكلات والقضايا التي تمثل أهمية بالنسبة لهم، بإمكانها أن تؤدي دورًا كبيرًا في مسألة التأثير في الرأي العام وفي الجانب الإخباري الذي يعذُ واحدًا من نشاطات الاتصال الجماهيري الأساسية المهمة، وهذا ما تجيد ماكينات التضليل العمل من خلاله، وذلك بإيراد معلومات صحيحة وتغليفها بأخرى كاذبة ومُزيفة للواقع.
وهنا لا يمكن أن تنجح مسألة تغييب الوعي الجماهيري في كلّ الأحوال؛ إذ لابد من أن تكون المعلومة حاضرة؛ فالمضلل يخاطب الوعي المغيّب بحسب ما يذكره الدكتور مطلق بن سعود المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بقسم الإعلام في جامعة الملك سعود، حيث يقول الدكتور المطيري في هذا السياق: «التضليل الإعلامي والدعاية السياسية كلاهما مصطلحين غير أخلاقييْن في العمل الإعلامي، وهناك التباس في المفاهيم حول هاتيْن المسألتيْن، فالدعاية يُمكن قياسها حينما يكون هناك حدثــًا صحيحًـا ويُضاف له معلومات أخرى بنوايا مسبقة، وأما التضليل فلا يوجد فيه لا حدث ولا معلومة صحيحة، وأساس التضليل هو الكذب، والقائم عليه يحاول أن يجابه الصدق والموضوعية بالكذب والخداع وتزييف الواقع».
ويستطرد الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي حديثه بالقول: «الدعاية السياسية تختلف عن التضليل الإعلامي، وقد يكون مقبولاً استخدام الدعاية في أوقات الحروب؛ فهي حملة منظمة بنوايا مسبقة هدفها خدمة مصالح القائم بالرسالة. أما في مسألة التضليل الإعلامي، فهذا الأمر يقوم به طرفٌ على حساب آخر، وهذا الأمر لا يحدث إلا إذا وُجد الطرف الآخر موضوعيـًّا، والطرف الأول يريد التقليل منه، وعلى سبيل المثال؛ تكون هناك دولة تعمل بشكل جيد وأخلاقي، وأخرى ترى بأن هذا التحرك إيجابي ويهدد المصالح، من هنا تبدأ الشائعات التي تنتشر وتأخذ في الانتشار في ظل وجود عاملي الغموض والأهمية؛ لذا لابد من أن تتوافر المعلومات وبشكل دائم للجماهير، حتى لا تحدث الفجوة في مسألة الوعي المغيّب، وهي المسألة التي نعاني منها في عالمنا العربي؛ فالعقلية العربية لا تقبل بالموضوعية، والإعلام التعبوي يبحث عنها ويتفاعل معها، ومن هنا تقبل العقلية غير الموضوعية الدعاية السياسية أكثر من قبولها للموضوعية».
وفي السياق ذاته، وعبر سلسلة من المقالات العلمية المنشورة في صحيفة أخبار اليوم المصرية، شخّص الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي مفهوم الشائعات ودوافعها وكيفية مواجهتها، بالقول: «الشائعة عبارة عن سلوك اجتماعي – لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات − فهي ظاهرة بشرية، وهي لكل سلوك تصدر عن دافع، وتهدف إلى غاية، وهي لصيقة بالمجتمع الذي تظهر فيه، تعكس ظروفه الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية، وعادةً ما يزيد انتشار الشائعات في أوقات الأزمات والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وحيث إن الشائعات توجد في كل المجتمعات بدرجاتٍ متفاوتة، إلا أن هناك علاقة وثيقة بين انتشار الشائعات وحجب المعلومات من الجهات المسؤولة».
كما يشير عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الشائعات كانت محط أنظار الدراسات العلمية والتحليل من جانب علماء النفس والاجتماع والسياسة والإعلام على حدٍ سواء، حتى جاء تعريفها على النحو التالي: «هي معلومة أو فكرة أو رأي حول شخص أو موضوع أو جهة أو قضية ما، يتم تداولها بين الأفراد عن طريق الاتصال المباشر، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الويب، من دون أن يتطلب ذلك قدرًا من البرهان أو الدليل».
ويفسّر الدكتور مكاوي النقطة الأخيرة بالقول: «القصد من ترديد الشائعة هو الاعتقاد بصحة المعلومات الواردة من دون توافر الأدلة اللازمة للتأكد من حقيقتها». ومن الأساليب المساعدة على انتشار الشائعات، اختلاق الأخبار والمبالغة في سردها وإن كانت تحوي جزء من الحقيقة، فهي «سوق سوداء للمعلومات» يلجأ إليها الجمهور طواعيةً متى ما غابت المعلومة حسب ما يذكر الدكتور مكاوي، وهي إذ تختفي متى ما زالت الظروف المحيطة بالمجتمع، خاصةً في أوقات الحروب والأزمات.
مـَن يتحكم في الآخر؟
يُستخدم الإعلام − أيضـًا − لغرض إيجاد آليات تنمي داخل الجمهور وعي الاستجابة للرسائل، كالحملات الإعلامية، وهذه الحملات قد تستخدم لأغراض توعوية مصممة لأغراض محددة، وأهداف موضوعة سلفـًا، يمكن قياسها وتحديد مدى الاستجابة لها من خلال مؤشرات يمكن رصدها، وقد تكون − أيضـًا − تضليلية، وذلك ما يعيدنا إلى نقطة البداية والتساؤل من جديد: ما الهدف من الحملات الإعلامية والتضليل، ومـَن يتحكم في الآخر .. التقنية أم الإنسان؟.
هنا يتفق المتخصصون في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري على أنه لا توجد نظرية واحدة يمكن الاتفاق عليها حول كيفية عمل وسائل الإعلام وعن تأثرها وتأثيراتها في الفرد والمجتمع؛ وأن النظريات الاجتماعية يمكن أن نصل من خلالها لتصورات مختلفة عن العملية الإعلامية وعن آثارها الاجتماعية. فمؤسسات الإعلام وإن كانت تتولى مهام الإنتاج المستمر كعمل أساسي، فهي تـُسهم − أيضـًا − في تكوين المخزون المعرفي للأفراد، والمؤسسة الإعلامية التي تقوم بوظيفة نقل المعرفة ويصل إليها الفرد بكل سهولة ويسر، يتكون على إثر وظيفتها علاقة افتراضية ما بين مرسل ومستقبل، ويـُفترض أن تكون هذه العلاقة توازنية، إلا أن هذه العلاقة ونظرًا لانتشار وسائل الإعلام، من شأنها أن تؤدي دورًا كبيرًا في الخبرات والتصور والإدراك، وكلّ ذلك يأتي بشكل تدريجي وغير محسوس.
ووسائل الإعلام التي تقوم بدور الوسيط في مجالات عدّة، هي وسيط بيننا وبين كثير من المؤسسات التي نتعامل معها، إذ تمثل قنوات اتصال بين أفراد المجتمع؛ عن طريقها نشكّل تصوراتنا عن الجماعات والمؤسسات والأحداث المختلفة؛ ومن خلالها تصورات الآخرين لنا تتأثر، والوساطة هنا نعني بها تمثيل أطراف مختلفة، والتحكم في طرف على حساب آخر؛ فهي إذًا مرآة عاكسة للمجتمع ولـمـَن يتحكم فيها أيضًا، وهي كذلك وسيلة للعرض وستار لمن يمارس من خلالها الدعاية.
لذا، يشير الدكتور حمود القشعان، عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، إلى أنه كلـّما زاد الإسراف في استخدام شبكة الإنترنت كلـّما قلت اللمسة الإنسانية والتواصل الحضاري بين المستخدمين، ويشدد الدكتور القشعان على أهمية اتباع أسلوب الشفافية لمواجهة التضليل الإعلامي: «بالشفافية تذوب كلّ الشبهات، لذا علينا جميعـًا أن نرفع شعار الشفافية والموضوعية، ومحاربة الفكر بالفكر».
أساليب جديدة للتضليل الإعلامي
تستخدم ماكينات التضليل أساليب الاتصال والإعلام اللازمة للتأثير في السلوك السياسي للجماهير في الدول الأخرى، وهذا الأمر يمكن قياسه على النشاطات الدعائية والإعلامية على حدٍ سواء، وهذا ما يعرف بالدعاية السياسية التي تدل على الجهود الواعية والمقصودة التي تستهدف نشر الأفكار والآراء والمعتقدات إلى جانب الأخبار المضللة، والهدف بالتأكيد التأثير في الرأي العام والسلوك الاجتماعي للجماهير.
ولذلك يشير الأستاذ نايف الضيط، وهو كاتب صحفي وأكاديمي متخصص في مجال الاتصال الإستراتيجي إلى أن «المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي هو أبرز من تحدث عن إستراتيجيات الخداع التي تمارسها وسائل الإعلام، فهو حدد عشرة أساليب تمارسها بعض وسائل الإعلام لتضليل الجمهور كسياسة الإلهاء، وتشتيت الجمهور وتجهيله، وصناعة الخوف الخارجي لتركه في حالة من الترقب المستمر، وافتعال المشكلات ومن ثم إيجاد الحلول لها».
ويضيف الضيط في مقالته التي نشرها في صحيفة «مكة» بالقول: «التجاهل نوع آخر من التضليل، حيث تعمد وسائل الإعلام المضللة إلى تجاهل أخبار مهمة، بينما تركز على أحداث أخرى ليست ذات أهمية بهدف توجيه الرأي العام، مثل السكوت عن المشكلات الاجتماعية والقضايا الأساسية والتطرق لموضوعات هامشية، وصنع المصطلحات الإعلامية ونشرها في التقارير والأخبار بهدف تشويه الآخر، وبما يتوافق مع توجه الوسيلة الإعلامية والقائمين عليها، كما تمارس دس السم في العسل بنشر الأخبار والتقارير، حيث تنشر المعلومات والأخبار لتشويه الحقائق وقولبتها، وتتعمد الاعتماد على مصادر مجهولة والتظاهر بأنها حقائق ومصادر موثوقة أو مطلعة لإثبات رأي معين وتجاهل الرأي الآخر والمصادر الأخرى.
ويرى نايف الضيط أن تطور تقنيات الإعلام أدى إلى بروز أشكال جديدة من التضليل والخداع الإعلامي، مثل: نشر الأخبار الكاذبة في المنصات الرقمية ومواقع الإنترنت، منوهًا بأن من أخطر أنواع التضليل في وقتنا الحالي، ما يسمى بتقنية الخداع العميق (Deepfake) وهي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة والشبكات العصبية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية وهذا الاستخدام دعا وكالة البحوث الدفاعية المتقدمة (DOPRA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إلى تطوير منصة تكشف التلاعب لتعرّف الصور والفيديو المشكوك فيها».
هذه المسألة تعدُّ تهديدًا خطيرًا للأفراد والأمن، فهل يقع اللوم على عاتق برمجيات الإنترنت في التضليل الإعلامي؟، أم أنه يقع على عاتق مـَن يدير هذه البرمجيات؟ فاليوم «يُسلـّط الضوء على الخوارزميات الـمـُستخدمة في محركات البحث ومواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، والـمـُتّهمة في أكثر الأحيان بإبراز المعلومات الـمـُلفّقة أو الخادعة بغض النظر عن عواقب ذلك»، وذلك بحسب ما نشره «جرنكس تيماز» في وكالة «فرانس برس»، والذي يشير إلى أن «البرمجيات تقوم باتخاذ قرارات من تلقاء نفسها، وتقوم بترتيب النتائج على محركات البحث، وتدير تغذية الأخبار في الشبكات الاجتماعية، وتوصي بمتابعة مواد بعينها، وهكذا توكل مهام معقدة وحساسة أحيانـًا إلى هذه الأنظمة التي تعمل بصورة مستقلة على نحو متزايد، وتتصرف بما يشبه (صناديق سوداء) تطور ذكاءها الاصطناعي من خلال البيانات التي نغذيها بها، والهدف الرئيس لـمـَن يقومون بتوظيف هذه الخوارزميات في الشبكات الاجتماعية، هو تعميم المحتوى الأكثر شعبية من دون الحكم على صحته، ولهذا السبب تتسبب في تضخيم تأثير الأخبار الملفقة”.
وتقنيات الإعلام المتطورة، إذا كانت تمثل تهديدًا خطيرًا للجماهير التي لا تدرك خطورة تعاطيها وتفاعلها مع المعلومات المضللة، فذاك نتاج طبيعي، بخاصةً وأن هناك مـَن يستخدم كلّ أدوات التضليل حتى يصل إلى مرحلة لا تتمكن فيها الجماهير من التفكير في الأسباب التي دفعتها لتبني آراء ومعتقدات معينة أو حتى البحث عن منطقيتها، فإذا كانت مثالية الإعلام تشير إلى أن الوسائل تستخدم بهدف نقل الحقائق والمعلومات للجماهير، فالدعاية شأنها شأن التضليل تهدف إلى غايات محددة، أبرزها يتمثل في قيادة الجماهير ودفعهم للاعتقاد بفكرة معينة أو مذهب سياسي معين، ولذلك نجد أن مـَن يستخدم الدعاية للوصول إلى أهدافه المرسومة مسبقـًا، فهو يستخدم بعض الحقائق وينطلق منها إلى تفسير ما يريده للوصول إلى نقطة التأثير الانفعالي في الجماهير, فأساليبهم هي الاستهواء والإغراء بصرف النظر عن منطقية الموضوعات المطروحة.
إذًا، فكلّ ما نراه اليوم من تضليل وخداع إعلامي، ما هي إلا حروب نفسية تُمارس في بيئة الإعلام الجديد، وهي شكل من أشكال الدعاية الهادفة إلى تثبيط الروح المعنوية من دون قتال فعلي بالتحام السلاح للقضاء على روح المقاومة والإقناع بالهزيمة.
لذا، تواجه وسائل وشبكات الإعلام الاجتماعية اتهامات من جهات عدّة، والأهمّ هنا هو أن نتساءل: مـَن يديرها؟ وماذا يقولون فيها؟ ولـمـَن يوجهون رسالتهم؟ وبأي قصد؟ وعلى الرغم من أن بعض الدول سنـَّت قوانينها لمحاربة الأخبار الكاذبة والمضللة، إلا أن «عليها أن تنشئ أجهزة قوية للعلاقات العامة الرسمية، إذا ما أرادت أن تقضي على الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات».
ويرى الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي في سلسلة مقالاته العلمية حول: مفهوم الشائعات:»إن تداول المعلومات على نطاق واسع ضرورة، ويمكن تنظيم ذلك وفق الضوابط والقوانين، ما يكفل حقّ المعرفة الذي يساعد على اتخاذ القرارات، وأن عرض الحقائق بوضوح وتجرد، وتحقيق العدالة والمساواة، وعدم التمييز والمحاباة والمحسوبية، من شأنه أن يكفل اكتساب ثقة الجمهور، والذي بات بحاجة إلى التوعية أكثر بمخاطر الجيل الرابع من الحروب، بخاصة وأن الجيل الرابع من الحروب يستخدم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الهادفة إلى هدم الدولة وإفشالها وتفتيها من الداخل، إما من خلال زرع عدد من العملاء تكون مهمتهم افتعال الأزمات، وزعزعة الاستقرار، وإثارة المواطنين للخروج ضد الأنظمة الحاكمة وإسقاطها، والعمل على هدم الثقة في المؤسسات الأمنية للدولة بدعوى تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان».
إذًا، شخصيات وأساليب المضللين في كلّ لحظة تتجدد؛ والمهم يكمن في مسألة الإدراك بأن وسائل الاتصال الجماهيري، تلك القادرة على نقل رسالة إلى جمهور واسع ومتنوع وفي آن واحد، يستطيع مـَن يديرها أن ينقل إلينا ما يريد في مضامين متنوعة؛ فإذا كان البعض يعتبرها سلاحـًا والبعض الآخر يراها سلطة فهي
− أيضًا − مرآة وأداة للسلم، فكيف يمكن لنا أن نوظف الرسائل الإعلامية والاتصالية بفاعلية مستفيدين من نظريات الإعلام والاتصال في الجانب الحسن لا السيء كما فعل من اتخذ «غوبلز» أبـًّا روحيـًّا وأسطورة يحتذى بها من أجل الكذب، ونشر الكذب، ومن ثمّ تصديق الكذب.
وما بين فترة وزير الدعاية النازي «غوبلز» في الثلاثينيات من القرن الماضي وبين حرب الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» مع وسائل إعلامية محددة في بلاده، نتيجة مواقف سياسية وحزبية، زادت وتيرة مصطلحات، مثل: «الأخبار الكاذبة» و»الوسيلة الإعلامية الكاذبة» وأصبح الجميع يطلقون مجازًا عبارة (Fake News) للدلالة واتخاذ موقف محدد، وهو ما برز مع الرئيس ترمب خصوصـًا، حتى لو تعدّى ذلك العرف والنسق الإعلامي الأمريكي المعتاد، والذي ربما يراه كثيرون قدوة في الشفافية والاستقلالية، لكن الأحداث والمواقف أظهرت العديد من التناقضات التي أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيجها وانتشارها بشكل واسع وعلى نطاق عالمي غير مسبوق، وبالتالي تبديل كثير من القناعات وكشف كثير من الأقنعة.