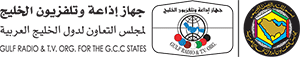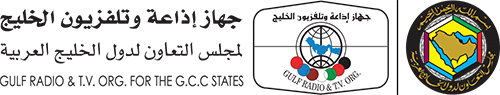أراد أحد “المتفذلكين” البولنديين أن يمازح أصدقاءه، ومتابعي مدونته الإلكترونيّة؛ فنشر الخبر التالي: “جهّز الجيش البولندي طائرة من سلاحه الجوي محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية والخيم لإغاثة وتقديم العون لضحايا زلزال جمهورية هايتي الذي خلف ما يقارب ثلاثمائة آلاف قتيل، وعددًا مماثلًا من الجرحى والمصابين، علاوة على حوالي (1.3) مليون دون مأوى؛ لكن قبطان الطائرة ضلّ طريقه؛ وحطّ في جزيرة “تهايتي”، لقد تشابه عليه أسم هذه الجزيرة التي تقع في المحيط الهادي، وهي بالمناسبة، أكبر جزر بولينيسيا الفرنسية، واسم جمهورية هايتي التي تقع في جزر الانتيل الكبرى في بحر الكاريبي.
الكلّ أدرك ببداهة أن هذا الخبر مجرد دعابة إلا بعض وسائل الإعلام التي بثته دون أن تفحصه وتمحصه وتتحرى صحته، بما فيها القنوات التلفزيونية ذات الشأن الكبير، مثل القناة الأولى – الخاصة – في التلفزيون الفرنسي، وهكذا تحولت الدعابة إلى قضية جدية أقلقت السلطات البولندية فسارعت إلى تفنيد الخبر جملة وتفصيلًا، وأكدت أن لا أساس له من الصحة، ويتجاوز المعقول في الملاحة الجوية.
حدث هذا في العاشر من شهر فبراير 2010م؛ أي قبل أن يرتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم، وينتشر ما أصبح يعرف بالأخبار المزيفة، وتتطور تقنيات ممارستها في وسائل الإعلام التقليدية، والميديا الاجتماعية على وجه الخصوص، وقبل أن يسمع الصحافيون وملاك وسائل الإعلام بالتزييف العميق (Deepfake)؛ الذي يعني التلاعب بالصور وشرائط الفيديو ومكوناتها لتصبح شديدة التطابق مع الصور الأصلية بحيث يعجز المرء، غير الخبير، عن تمييزها عن غيرها.
طوفان النشر الإلكتروني
يخبرنا موقع “ستاتيسكا” للبحث في شبكة الإنترنت إن عدد الإنترناتيين في العالم سيبلغ (5.56) مليار في نهاية السنة الجارية، وأن عدد الرسائل التي يتم تبادلها عبر منصة “الواتساب” يبلغ حوالي (42) مليون رسالة في الدقيقة الواحدة، وأن مليار ساعة من شرائط الفيديو تشاهد يوميًّا في منصة “اليوتيوب”! حسب صحيفة “لو دوفيني ليبيري” الفرنسية الصادرة في 23 أبريل 2025م، ويُدْرج (510) ألف منشور في الثانية الواحدة في موقع “الفيسبوك”!.
أمام هذا الطوفان من المواد المكتوبة والمسموعة و(السمعية/البصرية) المنشورة عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، المفروض من وسائل الإعلام التقليدية، التي تنهل منها وتعتبرها مصادر إخبارية، أن تعيش في حالة طوارئ دائمة من تحرّي الأخبار لاكتشاف المزيفة أو الملفقة فتحظر نشرها.
والأخبار المزيفة هي المصطنعة أو المُشَوَّهة أو المُحًرَّفة التي تنشرها وسائل الإعلام التقليدية أو تدسّ في الميديا الاجتماعية عن قصد لأسباب متعدّدة، نذكر منها: “تضليل الجمهور أو مستخدمي الإنترنت، وتشوّيه سمعة شخص أو مؤسسة ما أو بلد، وتفضيل حزب سياسي، والطعن في حقيقة علمية أو طبية مثبتة ومؤكدة، والتسلية، والحصول على منافع، وتصفية حسابات سياسية، ورفع عدد متابعي المنصّة الرقمية أو القناة التي تنشرها”.
ما معنى تحرّي الأخبار والبيانات؟
تجيب “صوفي مليبرو” (Sophie Malibeaux)، نائب رئيسة تحرير إذاعة فرنسا الدولية، عن هذا السؤال بالقول: إنها مجمل الممارسات والأدوات التي تسمح بالتحرّي بطرائق مختلفة عن الأخبار والمعلومات “صور، نصوص، شرائط فيديو، إشاعات تم بثها عبر الميديا الاجتماعية”، وغيرها من أنواع المحتويات.
ويعرفها بعض الباحثين بأنها: “مسار من التحليل وتدقيق الأخبار والمعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام في سياق خاص والتثبّت من صحتها”.
ويبدأ هذا المسار من المصدر الأصلي للأخبار والبيانات لينطلق في تحليل الصور وشرائط الفيديو، والتحرّي عن تصريحات رجال السياسة، وعن المعلومات الطبية والعلمية والتكنولوجية، وعن الإحصائيات المنشورة والمتعلقة بقطاع اقتصادي أو تجاري معين.
إنه مسار معقد وشاق يتطلب منهجية عمل، وصبر وتريّث في الحكم، وكفاءة تقنية، ومهارات لولوج مصادر المعلومات.
يعتقد بعض الباحثين أن ممارسة تحري الأخبار أنتجت نمطًا من الصحافة يقدم ضمانات للجمهور عن صحتها وصدقها، ويعمل على تحويل الأخبار والمعلومات إلى معرفة في خدمة المواطنين.
لقد استطاع هذا التحرّي أن يفرض قالبه التعبيري المستقل والقائم بذاته، على غرار بقية الأنواع الصحفية، مثل التقرير الصحفي، والمقال والعمود الصحافيين، وتخصّص له الصحف زاوية في الجريدة، مثل “المفكك” في صحيفة “لوموند” الفرنسية أو برنامج إذاعي، على غرار برنامج “ما وراء الخبر”، الذي تذيعه نائب رئيس التحرير “صوفي مليبرو”، على موجات إذاعة فرنسا الدولية، أو برنامج تلفزيوني مثل برنامج “الملاحظ” على قناة “فرنسا 24” التلفزيونية، وبرنامج “فك التشفير” الذي يبث على قناة “آرتي” التلفزيونية التابعة لفرنسا وألمانيا.
ويذهب بعض الباحثين في تنظريهم لتحرّي الأخبار في البيئة الرقمية إلى القول: “إنه أصبح يمثل اتجاهًا في الصحافة الرقمية يتّسم بالتعاون خارج حدود دائرة التحرير الصحفي التقليدي، يجمع الصحافيين، والجمهور، والعُدَّة التقنية، وهيئات المجتمع المدني”.
خلفًا لما يعتقد البعض، إن التحرّي عن صحة الأحداث والأخبار لم يظهر في مطلع هذا العقد، بل استخدمته الصحف الأمريكية في عشرينيات القرن الماضي، فصحيفة “التايم” الأمريكية، على سبيل المثال، وظفت صحافيين في عام 1920م، لمراجعة موادها الصحفية: يدققون في أسماء الأشخاص، والمدن والبلدان، والتواريخ، والأرقام، والمساحات، والأوزان، والأسعار، وفي تصريحات السياسيين، وفي الأحداث قبل نشرها.
وإن كانت غاية هذه العملية تكمن في إضفاء الشفافية على العمل الصحفي وطمأنة القارئ على صحة الأخبار والمعلومات التي تنشرها، فقد فرضها حرص الصحيفة وخوفها من المتابعات القضائية والغرامات المالية، إنْ نشرت أخبار مغلوطة عن أشخاص أو مؤسسات أو قدمت إحصائيات تضر بالشركات والمؤسسات.
لم تدرج مهنة تحرّي الأحداث والأخبار في التداول اليومي إلا في عام 1990م، بعد أن اختص بعض الصحافيين في الاستقصاء عن مضمون التصريحات التي يدلي بها السياسيون، ثم انتشرت هذه المهنة بعد أن اتسع الاستخدام الاجتماعي لشبكة الإنترنت، ووقوع أحداث 11 سبتمبر 2001م، حين زاد الشك في الرواية الرسمية عن هذه الأحداث، فراح كل مستخدم لشبكة الإنترنت يعلق عليها دون امتلاك معلومات كافية، وخلفية في العمل الصحفي، ولا التزام بالضوابط الأخلاقية التي يستلزمها العمل الإعلامي، وقد حققت له تكنولوجيا الاتصال ذلك، وهذا أدى إلى ارتفاع منسوب الأخبار المغلوطة وحتى المزورة في شبكة الإنترنت، وقد شعر الصحافيون الأمريكيون بأن الأخبار المزيفة أصبحت تهدد مهنتهم فقاموا بالرد، فأنشأوا مواقع في شبكة الإنترنت لفحص الأخبار، مثل موقع “بوليفاكت” في عام 2007م، التابع لصحيفة “تامبا باي تايمز” (Tampa Bay Times) الذي حصل على جائزة “بوليتزر” المشهورة في عام 2009م، لما قام به في مجال تحرّي الأخبار، الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أنشأت العديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية في العالم مواقع لها في شبكة الإنترنت لتحرّي الأخبار والمعلومات، بل أن عدد المنصات الرقمية التي أنشئت خارج المؤسسات الإعلامية التقليدية لهذا الغرض ما انفكت تزداد منذ بداية العقد الماضي، لتبلغ اليوم (300) منصة في العالم!
أسباب أخرى
تزايد الاهتمام بعملية تحرّي الأخبار والمعلومات منذ بداية العقد الثاني من الألفية الحالية نتيجة الانتشار السريع والواسع لظاهرة الأخبار المزيفة التي أصبحت بمثابة العملة الرديئة التي تطرد العملة الجيدة في السوق، لقد ازدهرت هذه الأخبار أثناء الحملات الانتخابية في البلدان الديموقراطية، لذا نلاحظ أن بعض وسائل الإعلام أنشأت مواقع لها خصيصًا للتحري فيما يروجه المرشحون للرئاسة في الحملات الانتخابية، هذا ما جرى في فرنسا، على سبيل المثال، في موعديها الانتخابيين، في 2012م و2017م، وفي زمن الأزمات والجوائح، مثل جائحة كورونا في 2019م.
توجد عوامل أخرى، تدفع إلى التدقيق في الأخبار والمعلومات المتداولة في وسائل الإعلام التقليدية أو في الميديا الاجتماعية، نذكر منها، على سبيل المثال وليس الحصر، التغيير الذي طرأ على قواعد العمل الصحفي، ففي عصر التكنولوجيا التناظرية كانت المؤسسات الإعلامية تتحرّى في أي خبر قبل أن تنشره، لكن اليوم تندفع المواقع والمنصات في شبكة الإنترنت، تحت واقع المنافسة، إلى نشر الأخبار أولًا، ثمّ تبحث عما يؤكد صحتها، وقد تتنصل من هذه المسؤولية وتضعها على كاهل الجمهور وفق منطق: “نحن ننشر وللجمهور مطلق الحرية في تصديق ما ننشره أو تكذيبه”، لذا نلاحظ أن القسط الأكبر من عملية تحرّي الأخبار والمعلومات يجري بعد نشرها أو بثها.
هذا علاوة على أن معايير الحكم على صحة الأخبار والمعلومات قد تغيرت هي الأخرى، ففي السابق كانت المصداقية تستشف من مصادر الأخبار، والمؤسسات الإعلامية التي تنشر الخبر أو تبثه، ومن الصحافي الذي يوسمه باسمه، أما اليوم فإن المصداقية “تكتسب” من عدد المطلعين على الخبر، فكلما أرتفع عددهم نال الخبر مصداقية أكثر، ولا يخفى على القارئ الكريم أن الميديا الاجتماعية تتفوق على الميديا التقليدية بآنيتها في نشر الأخبار، وبتواجدها في كل مكان، وبعدد متابعي صفحاتها أو مؤثريها والمتفاعلين معهم.
ما بعد الحقيقة
إن ما سبق عرضه من أسباب ليس سوى الجزء البارز من جبل الجليد، فالجبل في هذه الحالة هو ما أصبح يعرف بــ “ما بعد الحقيقة” التي أصبحت تهيمن على الحياة العامة وعلى ذهن الجمهور.
يعرف قاموس أكسفورد “ما بعد الحقيقة” بأنها: “تشير إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق الموضوعية أقل تأثيرًا في تشكيل الرأي العام الذي يناشد المشاعر والاعتقادات الخاصة”، فصفة “ما بعد” لا تعني بتاتا أننا نعيش مرحلة تجاوزنا فيها الحقيقة، بل تشير إلى تراجع مكانة الحقيقة في حياتنا اليومية أمام اندفاع المشاعر والعواطف، بمعنى أن الأحداث تصبح حقيقة إن أثارت مشاعرنا وعواطفنا وانساقت مع قناعاتنا، وليس انطلاقًا من تطابقها مع الواقع، ففي هذه الظروف برز مفهوم “الوقائع البديلة”.
ما يقلق رجال الصحافة والمؤسسات الإعلامية هو إخلال صاحب شركة “ميتا”، المالكة لمواقع “الفيسبوك، وانستغرام، واتساب”، بوعده بالإسهام في محاربة الأخبار المزيفة من خلال إشراك الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في عملية التدقيق والتحرّي في منشورات مواقعه، لقد انضم مؤخرًا إلى مالك موقع “إكس”، “تويتر” سابقًا، الذي يؤمن بأن عملية التحرّي نشاط مقيد لحرية التعبير، وعوضًا الاستعانة بمختصين وذوي خبرة في غربلة الأخبار واكتشاف المزيفة منها، والمالكين لمهارات التمييز بين الأخبار الصحيحة عن الكاذبة، اكتفى بملاحظات مستخدمي الموقع الذين يشيرون إلى أن هذا الخبر يتضمن معلومات مغلوطة أو تجاوزات أخلاقية، لقد شبه أحد المازحين هذا التحول في سياسة مالك شركة “ميتا”، بذاك الذي يعاني من تسرب المياه في مسكنه، فلم يلجأ إلى سَبَّاك، بل خرج إلى الشارع يطلب المساعدة من المارة للقضاء على تسرب المياه!
إن الإخلال بوعده، جمّد نشاط (80) منظمة مدنية تعمل في مجال التحرّي في صحة الأخبار والبيانات، وتستخدم (60) لغة، وقطع رزق ألفين مدقق خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
إنّ هذا الإخلال يثقل كاهل المؤسسات الإعلامية العاملة على تدقيق الأخبار ومحصها.
آليات التحرّي
إن تكنولوجيا الاتصال المعاصرة، على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي “برنار ستيغلر”، تعدّ بمثابة “فارماكوس”، وهي كلمة يونانية الأصل تعني السم والدواء في آن واحد.
بمعنى أنها سهلت نشر الأخبار المزيفة وانتشارها، ووفرت في الوقت ذاته العُدّة التقنية لمحاربتها من خلال تمكين المدققين والصحافيين من التأكد من صحة الأخبار والبيانات عبر منصات ومحركات بحث مختلفة، مثل منصة “هواكسي” (Hoaxy) لتحرّي المعلومات والأخبار، و محرك بحث “تين آي” Tin Eye)) الذي يبحث في ملايين الملفات عن مصدر الصور والتحويرات التي أدخلت عليها، وغيرها من محركات بحث.
بجانب التقصي الآلي أو الرقمي، لازالت بعض المؤسسات الإعلامية تمارس الاستقصاء اليدوي، أي الاتصال مع الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الخبر، والعودة إلى الأرشيف وبنك المعلومات والتقارير الرسمية للتأكد من صحة البيانات.
يركز القسم الأكبر من عملية التحرّي على الأخبار والمعلومات المنشورة، وفق مستويات مختلفة.
المستوى الأول؛ أي القاعدي، ويتمثل في تقديم الإجابة عن السؤال التالي: هل الخبر أو المعلومة صحيحة أم لا؟.
أما المستوى المتقدم، فيكشف عن نسبة الكذب أو الخطأ في الخبر، والجانب الناقص أو المسكوت عنه فيه، وعلامات انحيازه أو تضليله، ويكشف عن سياق نشره ومراميه المبطنة.
أخيرًا، يمكن القول: بصرف النظر عن الخلفية التي أدت إلى إنشاء مواقع تحرّي الأخبار والبيانات ونقائصها، فإنها تعدّ بمثابة إشعال شمعة ذات جدوى أفضل من لعن الظلام.