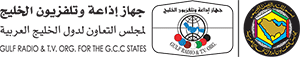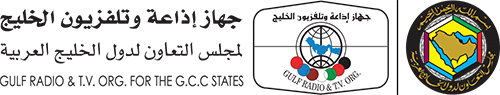لعل الكثير لاحظوا بمتعة، وربما باندهاش، تزايد عدد برامج الحديث الاستعراضي (Talk Show) في القنوات التلفزيونية العربيّة والأجنبيّة، والتي شكلت أرضية إضافية للتنافس المحتدم فيما بينها، لكن القليل منهم يتساءل عن السبب الذي أدى بالحديث (Interview) أو “المقابلة التلفزيونية”، التي تعتبر نوعًا من الأنواع الصحفية التقليدية، مثل الخبر أو التقرير الصحفي، لتصبح برنامجًا تلفزيونيًّا قائمًا بذاته يغري المشاهدين والمعلنين معًا، أو يحاول التفكير فيما ينجرّ عن تزايد هذه البرامج على الصناعة الإعلامية، وما يترتب عنها في مجال السياسة والثقافة والفن.
في تعريف “الحديث الاستعراضي”
يعرف الحديث الاستعراضي ” توك شو” بأنه برنامج إذاعي أو تلفزيوني يتراوح بين الخفّة والجدّة، ويتناول شتى المواضيع ذات الصلة بقضايا المجتمع ويتسم بطابعه الترفيهي، وبقدرته على تحقيق الفرجة عبر الحوار والمناقشة التي تجمع “مذيع/صحافي” وضيف أو مجموعة من الضيوف من المشاهير أو صانعي الأحداث السّياسيّة أو الثقافيّة أو الفنيّة أو الرياضيّة وغيرها، يتداولون الآراء والمعلومات والتجارب والخبرات والمشاعر والأحاسيس.
يعتقد الكاتب ميسون وين (Munson Wayne)، صاحب كتاب “الكل يتكلم: الحديث الاستعراضي في ثقافة الميديا”، الذي صدر باللّغة الإنجليزيّة عام 1993م، أن برنامج “التوك شو” أصبح نوعًا ثقافيًّا يشكل إنتاجه مصدرًا حيويًّا لاقتصاديات التلفزيون ويسهم في بناء الخطاب العمومي، وتشكيل المعرفة لدى قطاع واسع من المشاهدين.
يثير “التوك شو” الكثير من السجال، وحتىّ النزاع ليس بسبب مواضيعه غير المألوفة وحتّى الجريئة فحسب، ولا للخطاب الذي ينتجه والذي يتسم بالجرأة وحتى الطيش أحيانًا فقط، بل لكونه أصبح ظاهرة إعلامية مؤثرة، يقترح شكلاً من الترفيه الذي يثير خلافًا سياسيًّا وأخلاقيًّا، مثلما أشارت إليه الباحثة “كورنيليا إيلي” (Cornelia Ilie) من جامعة “مالمو” (Malmö) بالسويد، إذ تعتقد أن هذا النوع من البرامج يحمل في طياته مجموعة من المفارقات إن لم تكن تناقضات، إذ يجمع بين ما هو خاص وما هو عام، وما هو مؤسساتي وما هو شعبي، وبين التجربة الشخصية والعامة، وبين خبرة الراسخين في العلم وتجربة العامة من الناس، وبين الاتصال الشخصي الشِّفَاهِيِّ والاتصال الجماهيري.

تاريخ “التوك شو”
ترجح بعض المصادر أن تاريخ “توك شو” يعود إلى بداية البثّ التلفزيوني في نهاية أربعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكيّة، على الرغم من أن جهاز التلفزيون لم يكن آنذاك منتشرًا بشكل واسع، وقد استثمرت الشبكات التلفزيونيّة الكبرى الأمريكيّة: “أي بي سي” (ABC)، و”سي بي أس” (CBS)، و”أن بي سي” (NBC) في هذه البرامج إذ بلغ عددها نصف عدد البرامج التي كانت تبثـّها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، ولعل التاريخ يحتفظ باسمين ساهما في ترسيخ هذا البرنامج و تطويره، الأول هو الصحافي ومنتج الأفلام الأمريكي “فيل دوناهو” لأنه أول مـَن تبنى هذا النوع التلفزيوني الذي كان يسمى آنذاك “برنامج النقاش مع الجمهور” أو “برنامج النقاش في الاستوديو”، والثاني هي “أوبرا ونفري” (Oprah Winfrey) التي تربعت على عرش هذا البرنامج منذ عام 1984م.
انطلقت برامج الحديث الاستعراضي في التلفزيون من الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى بلدان أمريكا الجنوبية وكندا وأوروبا والبلدان العربيّة، وعلى الرغم من القالب العام الذي يجمع هذه البرامج وخضوعها للمنطق الاقتصادي إلا أنها تلوّنت بالمزاج الوطني الذي يطبع كل بلد، وبتقاليده الثقافيّة، ففي فرنسا على سبيل المثال؛ اتسمت برامج الحديث الاستعراضي بنزعتها اللسانية والأدبيّة على الرغم من محتواها الترفيهي، بينما اتجهت في إيطاليا إلى أسلوب البهرجة والسخرية، وبالإضافة إلى انشغالها بالقضايا السّياسيّة الراهنة، بخاصة في أثناء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، ركزت هذه البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية على المواضيع الاجتماعية، وعلى متاعب الحياة اليومية لقطاع واسع من المواطنين الأمريكيين وعلى حقوقهم المدنيّة، وأبرز مثال على ذلك برنامج “أوبرا ونفري”، والتي تقول عنها الكاتبة المصرية وخبيرة التخطيط وإدارة البرامج الثقافية للأشخاص ذوي الهمم “رشا إرنست”: “إنها استطاعت خلال (25) سنة من العطاء أن تمنح الفرصة لمشاهدي برنامجها للإبحار معها داخل ذواتهم ليكتشفوا مـَن هم، وليعترف كل واحد منهم بما في داخله ببساطة الأطفال ونضوج البالغين”.
لقد ظلـَّت “أوبرا ونفري” طيلة (4561) حلقة من برنامجها مثابرة على تحرير ضيوفها من خوفهم ومن شعورهم بالدونية وإحساسهم بالعار جراء الاعتراف بأخطائهم، وقد حوّلت برنامجها إلى ورشة يشارك فيها المشاهدون لتقويم السلوك وتعزيز التضامن الاجتماعي وإحياء النزعة الإنسانية التي سحقتها عقلانية السوق الفظـّة وجنوح السياسة الهوجاء.
السؤال
لماذا تحوّل الحديث التلفزيوني إلى برنامج قائم بذاته مُتَبَّلاً بالاستعراض والتسلية؟!
للإجابة عن هذا السؤال يمكن الإشارة إلى وجود جملة من الأسباب الاقتصاديّة والتقنيّة والثقافيّة، وهي ذاتها تقريبًا التي دفعت بالأغنية لتتحول إلى “فيديو كليب”، ففي ستينيات القرن الماضي كان التلفزيون يبث الأغاني بنوع من البساطة والتلقائية تضاهي تلقائية أداء المطربين آنذاك، وبدءًا من الثمانينيات أصبح العرض التلفزيوني للأغنية يتطلب مُنْتِجا تلفزيونيًّا أو سينمائيًّا، وفريقًا تقنيًّا متكاملاً يسهر على إنتاجه، يقوده مخرج تلفزيوني يستلهم عمله من سيناريو معد مسبقًا، فيُصور المغني ومـَن يرافقه في العرض من فنانين وممثلي الأداء في أماكن مختلفة، ويعزز بمؤثرات مرئية ذات إيقاع متسارع وسط ديكور مبهر، هذا فضلاً عن ابتلاعه ميزانية ضخمة.
لقد تبلور برنامج “التوك شو” في سياق ثقافي هيمن فيه الاستعراض على مختلف الأنشطة بدءًا بالرياضة وصولاً إلى السياسة، فعيون الكاميرا أصبحت هي الحاكم على السياسيين، بل إن تصويت الناخبين أصبح رهينة الصور التلفزيونية للمترشحين في الانتخابات النيابية والرئاسية، ولما يقدمونه من استعراض أمام كاميرات التلفزيون، فـ”تمشهدت” نشرات الأخبار هي الأخرى، أي تحولت إلى استعراض كبير، وتحوّل مذيعوها إلى نجوم ينافسون أبطال الأفلام والمسلسلات ولاعبي كرة القدم في الشهرة، وأصبح السرد التلفزيوني يُبنى دراميًّا من خلال إبراز الضحايا في النزاعات المسلحة، والفيضانات، والزلازل، والانفجارات، والحرائق، والأمراض الفتاكة مما يثير العاطفة والقلق.

خصائص
في ظل هذا السياق الثقافي، اكتسى برنامج “التوك شو” جملة من السمات، نذكر منها التركيز على الجمهور، فإن غاية هذا البرنامج هو بلوغ أكبر عدد من المشاهدين وإثارة تفاعلهم معه سواء كانوا داخل الاستوديو أو خارجه، وذلك بإبداء رضاهم على ما يدلي به هذا الضيف أو ذاك أو الاعتراض على ما يقوله، المهم ألا يظلّ هذا الجمهور محايدًا وساكنًا.
ويطبع كل مذيع برنامج “التوك شو” بطابعه الشخصي؛ نظرًا لكونه أضحى شخصية إعلامية مؤثرة، فهو الذي يحفز ضيوفه على الحديث، وهو الذي يتحكم في مجرى الحديث التلفزيوني ويوجهه، ويتبنى إستراتيجية “تسخين النقاش” سواء بالاستفزاز أو التواطؤ لدفع الضيف إلى الاعتراف أو التخلي عن تحفظه أو بتتبيل حديثه بالنوادر والنكت، وقد يكتسب ضيوف بعض هذه البرامج صيتًا وتزداد شعبيتهم، إذ يذكر على سبيل المثال؛ برنامج “التوك شو” الأدبي “أبوستروف” (Apostrophe) الذي كان يعده ويقدمه الصحافي “برنارد بيفو” (Bernard Pivot)، في التلفزيون الفرنسي – القناة الوطنية – الذي دفع به ليصبح علامة بارزة في الحياة الأدبيّة الفرنسيّة ومحفز دور النشر.
لقد خطب كثير من الكتّاب والروائيين وده ليحلّوا ضيوفًا على برنامجه، لأن ظهورهم التلفزيوني بجانبه يعني ضمان ارتفاع مبيعات كتبهم، وقد سبق لرئيسي فرنسا الراحلين: “فرنسوا ميتران وجيسكار ديستان” أن شاركا في هذا البرنامج من أجل كسب شرعية أدبيّة ونقديّة والظهور أمام الفرنسيين كمثقفين وليس سياسيين وحكام فقط.
يقوم هذا البرنامج على الاعتراف أو المواجهة التي تتحقّق بفضل طبيعة المواضيع الخلافية المختارة أو الشخصيات التي يستضيفها والتي تكون مثار جدل أو في اختيار جمهور الاستوديو الذي تمنح له فرصة التدخل والتعليق على ما يصرح به الضيوف وحتى التصويت على أدائهم أو منحهم علامة على ذلك.
وفي العموم، يفضل السياسيون المشاركة في برامج ” التوك شو” بجانب الفنانين والرياضيين والكتّاب للترويج لكتبهم التي تروي سيرتهم الذاتية أو لتقديم شهادتهم أو خبرتهم في إدارة الشأن العام، مثلما يجري في برنامج “لم ننم بعد” الذي كان يقدمه المذيع “لوران روكي” (Laurent Ruquier)، ويبثّ لمدة تزيد على ثلاث ساعات في التلفزيون الفرنسي في ساعة متأخرة من الليل في نهاية الأسبوع، فضلاً عن السعي لتجديد الثقة فيهم من خلال البروز كأشخاص عاديين وإنسانيين مثل بقية الضيوف: يمزحون ويلقون النكات، ويتأثرون، ويمكن أن يتحدثوا بصدق.
وإن كانت برامج “توك شو” أنزلت الخطاب التلفزيوني إلى الشارع، فقد دفعته للانزياح إلى “الشعبوية” بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين لرفع نصيب القناة التلفزيونيّة التي تبثّه من عائدات الإعلان، وفي هذه النزعة تتجلى خاصية خطاب هذا النوع من البرامج، حيث يقول عنه الكاتب “باتريك إمي” في كتابه المعنون بـ “كلمة التلفزيون وعُدّة التوك شو”: “إن سجل خطاب هذا البرنامج يفضل “إيتوس” éthos)) الضيوف؛ أي أسلوبهم لجذب المشاهدين وتماهيهم معهم “والباتوس” (pathos)، أي قدرة الضيف على إثارة عاطفة المتلقّي وإلهاب مشاعره، على حساب “اللوغوس” (logos)، أي عقل الضيوف وبلاغتهم وحججهم”.
وكان هذا الخطاب مؤسسًا لفلسفة التداخل بين الإعلام والترفيه، ولتجسيد هذه الفلسفة لجأت بعض برامج “التوك شو” إلى المزج بين أشكال التعبير: الشهادات، الجدل، سرد النكت والحكايات المشوقة، الألعاب، الشرائط السمعية، مقتطفات مصورة من أفلام أو مسرحيات، قراءة مقاطع من نصوص وغيرها مما يجعل “التوك شو” برنامجًا هجينًا.
لا يحتاج إنجاز برنامج “التوك شو” إلى ميزانية ضخمة، إذ تكلف الحلقة الواحدة التي تبثّ في القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة حوالي مائة ألف دولار أمريكي، وهذا خلافًا للمسلسل الدرامي الذي تكلف إحدى حلقاته مليون دولار أمريكي! وبالمقابل قد يجني “التوك شو”، الذي يبث قُبَيل زمن ذروة البثِّ أو في السهرة، مبالغ مالية عالية من عائدات الإعلان تفوق ما تجنيه المسلسلات التلفزيونيّة.
نعتقد أنه آن الأوان ليهتم البحث العلمي بتداعيات “التوك شو” على “تعليب” الثقافة وتسلية السياسة.
أخيرًا؛ هل يمكن القول عن برنامج “التوك شو” إنه الأداة التي تجسد ما قاله الروائي والفيلسوف الإيطالي “أنبرتو إيكو” عن التلفزيون: “إنه يُبَلِّد المثقفين، ويثقف الذين يعيشون حياة بليدة”؟.