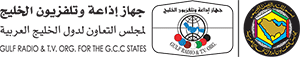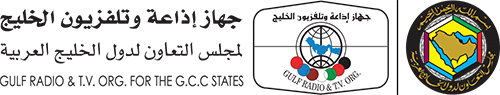مقدمة:
شكلت السينما على مر التاريخ وثيقة إبداعية حاملة لهموم الإنسان وانشغالاته، فكانت بحق أداة تفاهم وتبادل معرفي وثقافي أممي ومرآة عاكسة لقضايا الشعوب وطموحاتها.
وباكتساح السينما والأفلام يوميات الإنسان، أضحى بناء الذاكرة بوصفها متخيلاً وذكاء جمعيًّا مطلبًا ثقافيًّا ملحًا لحفظ الماضي وتعزيز أواصر التواصل مع الآخر.
ها هنا، طفت إلى السطح ضرورات الأرشفة والتوثيق لتبرز معها من منظور فني أهمية الفيلم الوثائقي الذي يعتمد على “التلقائية” أو الإخلاص في تصوير الواقع، حتى وإن كانت هذه “التلقائية” محفوفة في فهمها بكثير من اللبس والغموض.
وإذا قبلنا بالطرح الذي يدرج الفيلم الوثائقي ضمن مسمى “سينما الحقيقة” أو “سينما الواقع” فإن جماليات السينما ومقارباتها الإبداعية تضعنا حيال أسئلة محورية حاسمة متعلقة بالسياق العربي من قبيل: كيف يتمثل الفيلم الوثائقي في المشهد الإعلامي العربي؟ و إلى أي مدى نجح في الإفلات من مفهومه القاموسي ليعانق مساحات إبداعية جديدة كفيلة بإثارة فضول المشاهد العربي؟ أم أن المخيال العربي لا يزال غير قادر على تجاوز التصور التقليدي للفيلم الوثائقي الذي يربطه بالجانب التثقيفي المعرفي وبإعادة استنساخ الواقع؟ ألم يحن الوقت لإخراج هذا الجنس السينمائي من بوتقة التنميط إلى إثارة موضوعات تغني فكرة التحقيق والاستقصاء من خلال تطويع طرائق تصوير مبدعة؟
في البدء وقبل الخوض في إشكالية الفيلم الوثائقي العربي بين التصور والصناعة، علينا تحديد مفهوم الفيلم الوثائقي وما ينضوي تحت هذه “الهوية” من مسميات تختزل معنى ودلالة “المعالجة الخلاقة للواقع”.
1- الفيلم الوثائقي: محددات وأبعاد المفهوم
يرتبط الفيلم الوثائقي (Documentary film) في المخيال العام بالسينما التسجيلية، وهو من المصطلحات الوافدة على اللغة العربية تشكل في سياقات معرفية وثقافية وكذا مهنية مختلفة، وهو يشير إلى ذلك الشكل المخصوص من أشكال الإنتاج السينمائي الذي ينطلق من الواقع، لا يهدف إلى الربح المادي والتسلية، بل يهتم بالدرجة الأولى بتحقيق أهداف خاصة منها: “التثقيف، حفظ التراث والتاريخ”، وأهم من ذلك تقديم حقائق تستدعي الإدراك الواعي الذي يوفر متعة إنتاج المعنى والتعايش مع تفاصيله([1]).
وجدير بالذكر أن تعريفات الفيلم الوثائقي تكاد تكون غير محدودة في الأدبيات، فهي كثيرة ومتنوعة، لكنها تلتقي كلها حول كون الفيلم الوثائقي فيلمًا مختلفًا عن الروائي، لأنه يسعى إلى توثيق جوانب من الواقع لإثبات سجل مصور عنه يتناول وقائع تاريخية.
وليس المقصود بكلمة “تاريخية” هنا التعامل مع التاريخ الماضي فقط، بل كمادة مثبتة تتناول الوقائع في زمن ما قد يكون قريبًا أو بعيدًا، وقد ينتمي إلى زمن الحاضر ساعة تسجيل المادة التوثيقية([2]).
إن الحديث عن تسجيل المادة التوثيقية والسعي إلى “تأبيد أو تخليد اللحظة والحدث” لا يعني بأي حال من الأحوال تغييب عامل جاذبية الصورة السينمائية، وهي مسألة محسوم فيها منذ تقريبًا أكثر من قرن، أي منذ تاريخ 28 ديسمبر عام 1895م تاريخ ظهور أول الأفلام الوثائقية مع اٌلإخوان لوميير (Lumière)، فيلم “ساعة الغذاء” الذي كان يصور العمال وهم يغادرون أحد المصانع في مدينة ليون (Lyon) الفرنسية، حيث لم يلتزم المخرج باستنساخ الواقع وإنما غذاه من مخيلته، من خلال ظهور العمال بزي غير زي العمل، وهذا الانزياح الجمالي يتقاطع مع مفهوم “إزنشتاين” (Eisenstein) الذي يرى بأن الفيلم يجب أن يعيد تشكيل الواقع([3]).
إن التعامل مع الواقع ومشاكله لا يجب أن يكون بمنأى عن متعة النظر الجمالي للصورة، لأنها تعطي للأشياء والمادة المصورة معان خارج نطاق مادتها([4])، وما يؤكد ذلك وجود مخرجين حققا روائع وثائقية عالجا فيها مواضيع إنسانية بأساليب تجديدية حررت النص البصري من بهتان التبسيط والتقليد وابتعدت كليًّا عن إطار التحقيق التلفزيوني، فإلى أي مدى تمكن صناع الفيلم العربي من حسم الجدل التاريخي بين الواقعي والتخيلي في بناء تصورهم لهذا النوع من الأفلام؟ وهل أسهم ذلك في دفع حركة التفكير في تطوير صناعة الأفلام الوثائقية في عالمنا العربي؟ أم أن التقليد يظل سيد الموقف؟
2- الفيلم الوثائقي العربي: التصور والأجندة الفنية
تشير المعاينة النقدية الأولية للأفلام الوثائقية العربية إلى وجود ما يشبه المنهج أو المدرسة الفنية الموحدة التي تؤثر الوصف على التحليل، وتفضل التثقيف والتعليم على الاستقصاء وسبر أغوار الحقائق، ما أنتج أفلامًا ينقصها القلق والشك والارتياب والسؤال والمساءلة، ويغيب عنها البحث والتنقيب والتقليب في الوثائق وتوظيف الشهادات والمقابلات ووضعها في مواجهة بعضها البعض أو في مواجهة الاستفسار والسؤال والتشكيك إلى درجة قل أن نجد فيها فيلمًا تسجيليًّا استطاع إماطة اللثام عن غموض بعض القضايا التي تهم المشاهد العربي([5]).
ومما يؤخذ على الفيلم الوثائقي العربي – أيضًا – حياده عن أفكار التيارات المعاصرة التي تقرن الأفلام التسجيلية بلمسات تشويقية مبدعة تحولها من مجرد أفلام وثائقية (Documentary films) تقوم على إعادة كتابة وتوثيق الواقع إلى أفلام تقوم على البناء الدرامي للواقع (Dramatization of factual material)، وهذا ما توفره جماليات اللغة السينمائية ممثلة في نوعية اللقطات، حركات الكاميرا، زوايا التصوير والمونتاج، وكذا استخدام الرموز الفنية مثل انبثاق ضوء فجأة من خلال نافذة سجن، وهو توظيف يعطي معنى مضافًا للصورة يخرجها من بعدها الواقعي اليومي المباشر إلى بعدها الجمالي، ومثل هذه الاستخدامات وغيرها هي التي تجعل نبض الفيلم متقنا وأخاذًا([6]).
وهنا يفرض علينا السؤال: لماذا يحتاج البشر إلى مصنع للأحلام لا يتحقق في الواقع؟ يخبرنا بيتر بشلين في مقدمة كتابه “الفيلم كسلعة” أنه كلما زاد حرمان الناس في الواقع، أصبح من الضروري التعويض عنه عن طريق إشباع رغبات الخيال عندهم، ويساعد الإيهام البليغ بالواقع الذي تنتجه الصور السينمائية على تصوير الواقع نفسه، لكنه يساعد – أيضًا – على إيجاد واقع بديل آخر، وهذا الأخير هو الذي يصنع الفارق لدى المتلقي([7]).
هذا يعني أن الأفلام الوثائقية هي معالجة سينمائية تدور حول “الحياة الواقعية” (about life)، لكنها ليست حياة واقعية، بل ليست حتى نوافذ على الحياة الواقعية، لأنها بالأحرى لوحات للحياة الواقعية تستخدم الواقع كمادة خام لها، ويعدها فنيون وتقنيون يتخذون قرارات لا حصر لها بشأن اختيار الممثلين، القصة، الموسيقى المصاحبة، مزج الصوت، وغيرها من المعالجات التي قال بشأنها الصحفي الإذاعي إدوارد أمورو ذات مرة: “أي شخص يعتقد أن كل فيلم يجب أن يقدم صورة متوازنة لا يعرف شيئًا عن التوازن ولا الصور”([8]).
إن إمتاع المشاهد جانب مهم في مجال صناعة الأفلام حتى في الأفلام الوثائقية، حيث يوظف الخيال كأداة لإثارة التفكير ضمن التصور الحديث الذي يعرف بـ(docudrama) من أجل التلذذ والاستمتاع بها وفق مفهوم الباحث والناقد الفرنسي رولان بارث (Roland Barthes)([9]).
وبين الإمساك بعالم الحقيقة بكل تنوعاتها وظلالها والاستئناس بشعريات الحس الفني شديد الإبهار والتأثير في المخيال المجتمعي والفردي، تتبدى تفاصيل الصورة على الشاشة وتتفجر طاقتها الإبداعية في التعبير عن الواقع، لذا كان من الأخطاء الشائعة إذا ما أراد المخرج التعبير عن البؤس أن يجعل العالم كله بائسًا، هناك فرق بين واقع البؤس وصورة البؤس… هناك مسافة بين أن تعيش البؤس واقعًا وأن تعيد بناء البؤس في رحاب الصورة والتصوير… وأي هدم لتلك المسافة يحولنا من صورة البؤس إلى بؤس الصورة، وبؤس الصورة هو بؤس للوعي ولمستقبل العالم الذي نراه([10]).
وكل التجارب العالمية والنظريات النقدية حول الفيلم الوثائقي لم تخرج من إشكالية المسافة بين الواقع والصورة، ونحن في العالم العربي لم نكن بمعزل عن هذا السجال الذي يضاف إليه – حسب النقاد – عدم دراية أغلب المخرجين العرب بتقنيات تصوير الفيلم الوثائقي التي تختلف كليًّا عن الفيلم الروائي، وجهل الكثيرين منهم بمدرسة الإخراج الوثائقي الذي هو بكل بساطة إجابة عن سؤال: متى؟ أين؟ ماذا نصور؟ وكيف نصور؟
3- الفيلم الوثائقي العربي: الهواجس والمعايير الفنية
الفيلم عمومًا نظام مرئي يقوم على حركة الكاميرا وحركة المشهد، ومثل هذه الحركة يجب أن تكون مضبوطة وفق خطة تنفيذية معدة مسبقًا من قبل المخرج والطاقم الفني.
هذه الخطة هي دون شك إجابة عن أسئلة ملحة من قبيل: ماذا نصور؟ ما مواقع التصوير التي تقتضيها “تيمات” الفيلم؟ وكيف نصور؟ هل نلتزم باحترام الترتيب الكرونولوجي للأحداث أم ننزع لمراعاة أماكن التصوير حتى وإن اختلف ترتيب المشاهد فيها؟
وربما مثل هذه الأسئلة تكون أكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالفيلم الوثائقي الذي يسعى لأن يكون تجسيدًا منصفًا لتجربة شخص ما مع الواقع أو لحدث معين، وذاك هو العقد المبرم مع المشاهد، ففي مثل هذا النوع الفني الناشئ لا توجد كما يقول أحد النقاد قواعد هناك فقط قرارات بشأن تحديد كيفيات وطرائق التصوير التي تكفل لهذا الجنس السينمائي حرمة الاختصاص([11]).
وعلى الرغم من أن فكرة الفيلم الوثائقي الأساسية هي التعبير عن واقع معاش وعن حقيقة معاشة مصورة آنيًا أو ممثلة – إعادة تمثيل الواقع – إلا أن ذلك لا يغني بأي شكل من الأشكال عن احترام معايير نجاح هذا النوع السينمائي.
في هذه النقطة يجمع أغلب النقاد على أنه ومنذ بدء انتشار الفضائيات الإخبارية العربية واهتمامها بالفيلم الوثائقي تردد سؤال مستمر: هل يمكن إدراج ما يقدم من أفلام على هذه القنوات ضمن مفهوم الفيلم الوثائقي؟ أم مجرد تقارير إخبارية مطولة؟
بمنطق تحليلي، يمكن القول: “إن التقرير الإخباري هو فن ومنجز بصري يندرج في إطار العمل الإعلامي ينصب تركيز المعلومة فيه على الحدث نفسه، فنتابعه لمعرفة تفاصيله العامة دون الخوض في جزئياته أو ملاحقة ما وراء الحدث من تفاصيله، بينما لا يكتفي الفيلم الوثائقي بتقديم المعلومة، و إنما ينبش في كافة تفاصيلها سعيًا لتقديم فهم أوسع وأشمل للحدث، وبهذا يكون الفيلم الوثائقي شكلاً من أشكال التفكير([12]).
إن الاقتراب من فنون الإعلام وفصلها عن ضروب الإنتاج السينمائي الأخرى يساعد – دون شك – في ترسيم الحدود بين ظلالها المتداخلة، وهو التعالق الذي دفع بالكثير من الباحثين والنقاد في مجال الأفلام إلى القول: “إن تسابق القنوات التلفزيونية العربية إلى إنتاج أفلام وثائقية قد أدى إلى تمييعها، فلم تعد أفلامًا وثائقية حقيقية بقدر ما هي مجرد أفلام ذات قوالب فنية ضعيفة لا تختلف عن التقارير الإخبارية إلا في طول المدة، وقد عزز من ذلك اهتمام القنوات بالأفلام ذات الطابع الإخباري أي التي تلاحق أحداثًا معينة لتتناولها بشكل أوسع ضمن تغطيتها لهذه الأحداث وفي نفس الوقت كجزء من إكمال دوراتها البرامجية والتنويع وكسر الجمود الذي يلف طبيعتها الإخبارية”.
وحتى لا يكون الفيلم الوثائقي محض بنية سردية مصورة، وتسيير للحكي بالكاميرا كان لا بد أن يلتزم صناعه كما يقول الناقد ورائد السينما الوثائقية “جون غريسون” بجملة من المعايير لعل أبرزها:
– أن يكون موثقاً بشكل جيد، وأن يتضمن أفكارًا فريدة ومتميزة ويطرح قضايا فكرية وحضارية مثيرة للنقاش.
– أن يتحرى البحث والدراسة المعمقة للحصول على المعلومات الدقيقة التي لا يمكن أن يطعن فيها لاحقًا مثلما اتهمت به الكثير من الأفلام الوثائقية حين أعيب عليها توظيف معلومات مغلوطة.
– أن يتبنى التصوير إضافة لمسات فنية على المادة العلمية والمعلومات التاريخية لتحريك انفعالات المشاهدين حول القضية وترك انطباع إنساني لديهم.
– أن يعمل المخرج على إثارة الانتباه للبرنامج عن طريق عقد مقارنات بين القديم والحديث.
– تدعيم رؤية المخرج للواقع الذي يعالجه الفيلم الوثائقي برؤى ووجهات نظر أخرى وهو ما يتعزز من خلال توظيف المقابلات واستطلاع الرأي، وكذا الحقائق المدعمة بالأرقام والإحصائيات المضبوطة بالإضافة إلى الشهادات الحية والوثائق الرسمية التي تزيد من صدقية وتشويق الفيلم.
عطفًا على ما سبق، يمكن الجزم بأن أحد أهم أسباب تأخر السينما الوثائقية في الوطن العربي إنما يكمن في إهمال العمل بمبادئ وأسس نجاح الفيلم الوثائقي، مما جعلنا ولفترة طويلة نعول على الآخر، ونقصد هنا الدبلجة من القنوات الأجنبية التي كان لها الجرأة والخبرة في تمرير وجهة نظرها التي لا تتوافق في كثير من الأحيان مع الواقع والسياق العربي.
خاتمة:
نخلص مما سبق أنه على الرغم من التطور والانتشار الذي عرفه الفيلم الوثائقي العربي داخل الوطن العربي وخارجه، إلا أنه ما زال يصارع من أجل إيجاد مكانة له بموازاة الفيلم الروائي، وعلى الرغم من جهود بعض المخرجين العرب التي أثرت إنتاج السينما الوثائقية بأفلام متميزة من قبيل “بنات ألفة” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، و”كذب أبيض” للمخرجة المغربية أسماء المدير، و”بقايا زمن شارع محمد علي” للمخرجة المصرية نبيهة لطفي… وغيرها، لا يزال الفيلم الوثائقي العربي يخوض التحدي من أجل الوصول إلى مكانته التي يستحقها لدى الفاعلين السينمائيين ولدى الجمهور على حد سواء.
الهوامش:
([1]) جورج خليفي، الفيلم الوثائقي، مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2014م، ص5.
([3]) Brain Winston, The Documentary Film, Bloomsbury publishing, London, 2019, P16.
([5]) مؤمن السميحي، الفيلم الوثائقي: من الفكرة إلى الشاشة، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2017م، ص61.
([6]) Guy Gauthier & Daniel Sauvaget, Le Documentaire, Un Autre Cinema, Edition Armand Colin, Paris, 2015, P32.
([8]) باتريشيا أوفرهايدي، الفيلم الوثائقي مقدمة قصيرة جدًا، ترجمة: شيماء طه الريدي، الطبعة الأولى، 2013م، ص10.
([9]) Guy Gauthier & Daniel Sauvaget, Op, cit, P42.
([10]) عدنان مدانات، السينما التسجيلية: الدراما والشعر، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان، 2011م، ص52.
([11]) Barry Hampe, Making documentary films and reality videos, Henry Holt and company, New York 2007, P66.