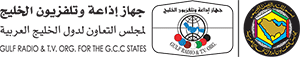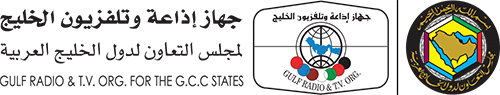يصدر هذا العدد ورمضان لم يفارقنا أو فارقنا منذ قليل، وفي كل الأحوال فإن جرعة المسلسلات الدرامية الخليجية والعربية بشكل عام لا بد أنها تصيب بالتخمة في هذا الشهر الفضيل، ويظل التساؤل مفتوحًا، هل هناك جديد فيما يقدم؟ أم أننا مازلنا ندور في ذات الفلك كما هو الحال منذ سنوات عديدة؟
المنصات تدخل حلبة الصراع
من باب واسع دخلت المنصات الفضائية حلبة الصراع مع القنوات الفضائية على كعكة المسلسلات، وأكاد أجزم بأن المنصات قد اقتربت من أن تكسب الجولة، على سبيل المثال فإن منصة “شاهد” قد أصبح لها مريدوها ومتابعوها من كل حدب وصوب، يعود ذلك بالطبع إلى حسن اختيار الموضوعات والتباري في تقديم أفضل الطاقات الإبداعية من حيث الكتابة والتمثيل والإخراج والعناصر الأخرى المؤثرة في العمل الدرامي، كما أن قصر عدد الحلقات أصبح سمة تتناسب مع روح العصر، وتعمل على التكثيف الإيجابي، والاختزال غير المخل، فالإسهاب في غالب الأحيان يجعل إيقاع العملية الإبداعية فاترًا غير محرض على المتابعة المستمرة، أو جذب المشاهد بالقدر الكافي.
ومن الجدير بالذكر أن إسناد الإشراف على المحتوى إلى ذوي الخبرات والتجارب الإبداعية المشهود لها بالتميز، يجعل الاختيار صائبًا في غالب الأحيان، كما أنه يوجه بوصلة إدارة المنصة إلى المقدرة على المزاوجة بين القيمة الفنية والمقدرة على تحقيق أرباح وعوائد مالية.
القنوات الرسمية والخروج من السباق
بينما تتهافت الفضائيات الخاصة والمنصات على اقتناص الجيد ومضمون النجاح من الأعمال، تقف القنوات الرسمية منتظرة ما يخرج من هذا السباق الشرس، فهي إما تخرج خالية الوفاض، أو تكتفي بعرض أعمال غير حصرية، تزيد مسافة الاغتراب بينها وبين المشاهد، وهي حقيقة لا بد من مواجهتها، ليس من باب جلد الذات، وإنما من أجل البحث عن حلول للخروج من هذا المأزق، خاصة وأن هذه الحلول والاقتراحات متاحة، شريطة التخلص من بيروقراطية الأداء الحكومي ولوائحه التي تكبل يد القائمين على العمل بهذه القنوات وتمنعهم من الدخول في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص، ينتج عنها الفوز بعرض أعمال فنية بصفة حصرية، والقدرة على تكثيف الدعاية والإعلان عن هذه الأعمال بأساليب غير نمطية تتناسب مع الوقت المعاصر وما يميزه من تقنيات حديثة دخلت لعبة الدعاية وجعلتها الأقرب إلى عين المشاهد، بل هي تتمكن من أن تذهب إليه عبر هاتفه ومواقع التواصل الاجتماعي التي يرتادها.
الأمر الآخر أن القنوات الرسمية لا تتمكن في الوقت الحالي من دفع أجور نجوم الصف الأول، مما يجعلها تلجأ إلى فنانين من الصعب أن يتحملوا عبء القيام ببطولة أعمال درامية ترضي تعطش المشاهد إلى أن يرى نجمه المفضل ويستمتع بأدائه التمثيلي.
الحاجة إلى مسلسلات تعزز روح الوطنية والانتماء
لا بد أن نعترف أن الأجيال الشابة ليست على قدر الشعور بقيمة الأوطان وعمق الانتماء إليها مثل الأجيال السابقة، خاصة في ظل ما يحاك لها من دسائس عبر لجان إلكترونية تملأ فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، لذا تبرز الحاجة لمسلسلات تستلهم روح الوطنية، وقيم الاعتزاز والفخر النبيلة بتراب الأوطان ومقدراته.
وحسنا فعلت الدولة المصرية بتصديها لتقديم أعمال درامية خلال المواسم الرمضانية الماضية استعرضت ما قدمته الشرطة والجيش المصريين من تضحيات من أجل مواجهة أعداء الداخل والخارج، خاصة إبان السنوات العصيبة التي مرت بها مصر.
ولم يكن بمقدور القطاع الخاص أن يفكر في إنتاج هذه الأعمال، ذات التكلفة الإنتاجية الضخمة، خاصةً وأنها لم تكن مضمونة النجاح، إلا أن هذه المسلسلات حققت نجاحًا مبهرًا ونتجت عنها عوائد مالية ضخمة.
لذا فإن الدخول في إنتاج مشترك بين بعض الدول الخليجية والعربية لاستعراض التاريخ الحافل بين هذه الدول، ينمي لدى المشاهد اعتزازه بدينه وعروبته، ويسهم في تقريب المسافات بين الشعوب، كما أنه يتيح الفرصة للتعرف على محطات تاريخية هامة.
ناهيك عن أن هذه الأعمال ترتفع بذائقة المشاهد وتخرجه من روتين المسلسلات التي لا زالت تدور في فلك الحب والكراهية والصراع الذي صار مبتذلاً ومستهلكًا بين الخير والشر.
افتقاد المسلسلات الدينية وطقوسها الروحية
لا أظن أن وقتًا أكثر مناسبة من شهر رمضان الفضيل لعرض أعمال دينية، تستكمل الطقس الديني والروحاني الذي يحلق بنا جميعًا في آفاق الدين الرحبة، ويسهم في تخليصنا من أدران الحياة وما يشغلنا فيها من دوافع دنيوية؛ ولكن هذه النوعية من الأعمال صارت منقرضة ودخلت متحف التاريخ، لأسباب عديدة، منها اللهاث خلف تحقيق الربح، وعدم قدرة مؤلفي وقتنا المعاصر على التصدي لهذه النوعية من الأعمال التي تحتاج إلى البحث والتدقيق والتنقيب عن كنوز سير أعلام الدين عبر العصور، إلى جانب أن هذه الأعمال في أغلبها تحتاج إلى ممثل محترف دارس للغة العربية قادر على التحدث بها بطلاقة دون أن يقع في فخ الرسوب في مخارج الألفاظ أو القواعد النحوية، وأكاد أجزم أن نسبة لا بأس بها من الممثلين الشباب يفتقدون إلى هذه المقدرة.
لكن لا بد – أيضًا – أن تتحمل القنوات الرسمية هذا العبء بالتعاون مع جهات حكومية أخرى تشملها بالرعاية والدعم المادي، حتى يتم تقديم أعمال تليق بعظمة وبهاء ديننا.
وما يجمع بين الأعمال الدينية والوطنية والتاريخية – أيضًا – أننا نفتقد إلى وجود لغة فنية قادرة على مخاطبة الآخر، ليستبين حقائق الأمور، ويتم تصحيح المعلومات المغلوطة التي تصل عنا إليه، فلو أن مثل هذه الأعمال تمت “دبلجتها” أو صاحبتها ترجمة إلى لغات اخرى وعرضت بفضائيات عالمية لكان الأمر أكثر تأثيرًا واختصر مئات المقالات والمحاضرات.
الصنعة والبحث عن الحلقة المفقودة
تعكف الأجيال الشابة على متابعة الأفلام والمسلسلات الأجنبية، خاصة بعد أن صارت قريبة منهم عبر منصات عالمية مثل “نيتفليكس” وغيرها، ولهم الكثير من الحق في ذلك، خاصة وأنهم يشاهدون قدرًا كبيرًا من الإبهار البصري، الذي يحفزهم على المتابعة ويزيد من قدر الإثارة والتشويق لديهم.
إنها الحرفة والصنعة التي لا تخلو من الاجتهاد والبحث عن الجديد والمبتكر في الصورة وما يصاحبها من تقنيات مبهرة في “الجرافيك” الذي صار رفيقًا ناجحًا لما يعجز الديكور عن تحقيقه، إضافة إلى الموسيقى والمؤثرات الصوتية وغيرها، وهو ما لا بد من مواجهته بنفس الأسلحة التي لا بديل عنها الآن، حتى وإن كانت ذات تكلفة عالية لأنها ستستعيد فئة مهمة من المجتمع إلى “ريموت” الفضائيات العربية.
الكتابة والتغريد خارج السرب
أحد أهم أسرار العمل الدرامي هو المؤلف الذي ينطلق من عنده موكب العمل، ويبحر في بحر الإبداع الذي قد يصل به إلى بر الأمان أو تغرقه الأمواج المتلاطمة.
ومن الظواهر الملفتة حاليًّا وجود ما يسمى “ورش الكتّاب” التي لا تخضع لمؤلف واحد، ولكنها تحظى بشراكة بين عدد من الكتّاب من خلال عصف ذهني مشترك يفضي إلى كتابة العمل المنشود.
ونحن هنا أمام خيارين، فإما أن تنتج عن هذه الورشة كتابة مغايرة عن المألوف، تسير في اتجاه النجاح بخطى ثابتة.
وإما نجد أنفسنا أمام عمل مرتبك تتشابك خيوطه ولا تتفق، أو تسير في اتجاه منتظم، ويبقى المؤلف الأوحد أو على الأقل الذي يدير هذه العملية هو القادر وحده على أن يصنع بحرفية ومهارة عملاً فنيًّا قيمًا، وأن ينسج أحداثًا تتصاعد دراميًّا لتقدم وجبة فنية ترضي عقل ووجدان المشاهد.
النهاية الناجحة
في اعتقادي أن نهاية المسلسل الناجح، ليست حلقة الختام، ولكن قدرة العمل في أن تفتح قوسًا في وجدان المشاهد، تغلقه الحلقة الأخيرة؛ ولكن يظل ساكنًا في هذا الوجدان يتذكره المتلقي ويشتاق إلى مشاهدته مرة أخرى.
نعم إنها الأعمال الخالدة وما أكثرها، وخاصة تلك التي تعتقت مع مرور الزمن، واحتلت مكانة لائقة بين الأعمال الغزيرة الكثيرة التي على الرغم من عددها الكبير إلا أنها لم تترك أثرًا أو تضع بصمة.
نريد أعمالاً تزيد من المتعة وتحفز العقل على التفكير، نريد أعمالاً تضيف إلى المشاهد ولا تنتقص من ذائقته، نريد أعمالاً ليست للاستهلاك الآني، لكنها راسخة واثقة الخطى، نريد أعمالاً توقد الروح وتنمي العقل.
لذا فإن الخاتمة لا تعني النهاية أبدًا، إذ ربما تكون بداية لفصل جديد.