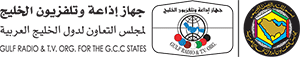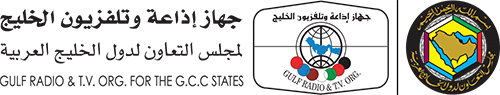بينما تسترسل الصورة التلفزيونية في محاكاة الرواية الأدبية، باحثة عن تفاصيل كامنة في ثنايا الرواية، أو قد تكون أوحت بها، تنقض الصورة السينمائية على المشهد الروائي، لتأتي مكثفة، موحية، ومعبرة باختزال عن الأحداث والمواقف التي تعج بها الرواية.
فطنت السينما إلى الرواية الأدبية مبكرًا، واقتبست عنها أو حولت حروفها إلى أفلام سينمائية منذ عقود طويلة، وعلى مدار تلك العقود شاهدنا أفلامـًا للروائيين المصريين المهمين على وجه التحديد الذين احتفت بهم السينما المصرية، أمثال طه حسين، وإحسان عبد القدوس، ونجيب محفوظ، ويوسف السباعي وغيرهم.
لعل النصيب الأكبر كان لأعمال محفوظ التي يبدو أن السينما وجدت فيها ضالتها، لأنها الأقرب إلى محاكاة قصص الأحياء الشعبية في مصر، والتي كانت تتمتع بجماهيرية كبيرة.
وهناك كثير من الأفلام السينمائية التي تشعر أن الروايات المأخوذة عنها يصعب تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، منها على سبيل المثال أعمال الراحل إحسان عبد القدوس ذات الطابع الرومانسي أمثال: “لا أنام” و”أنا حرة”، وهي قصص رومانسية تكمن نهايتها في ثنايا البداية، وتسير خلف خط درامي واحد في الغالب، على العكس من أعمال أخرى لنفس الكاتب، يتيح نسيجها الدرامي، توسيع خطوطه ومدّها في اتجاهات عدة.
الأمر نفسه يتكرر مع أعمال يوسف السباعي “بين الأطلال” و”غرام الأسياد”، وغيرها من الروايات العاطفية.
سبحت الرواية في السينما المصرية، وتعددت موضوعاتها التاريخية والسياسية والعاطفية والشعبية، وأصبحت ملهمة للمخرجين الذين تناولوها من وجهات نظر متعددة، وربما أسهم في حالة التألق التي شهدها منتصف القرن الماضي تقريبـًا، هو دخول كتـّاب الرواية عالم السيناريو والحوار، فيكفي أن نعرف أن أساطين الرواية المصرية، شاركوا في كتابة العديد من سيناريوهات الأفلام وحواراتها، وهو ما منحها زخمًـا ومذاقـًا مختلفـًا، بلغت حد اللغة الشعرية في الحوار المكتوب، والذي أسهم في صناعة العديد من الأفلام التي اختارها النقاد في عام 1996م ضمن قائمة أفضل مائة فيلم في السينما المصرية.
على الجانب الآخر لم يخض كتـّاب الرواية مجال كتـّاب السيناريو والحوار للمسلسلات التلفزيونية، وهو ما يعني أن الفيلم هو الأقرب روحـًا إلى جنس الرواية، من حيث الرسم المكثف للشخصيات، والسرد الموجز، وإيقاع الأحداث وتلاحقها.
ظلـّت الرواية ملهمة للسينمائيين على مدى عقود طويلة وإن كان هذا الحسُّ قد بدأ في الخفوت منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد يعود ذلك إلى طغيان الأفلام الكوميدية الخفيفة، التي حصرت الأنواع الأخرى من “تيمات” الأفلام في قفص ضيق، بخاصة في ظل دخول صناعة السينما مرحلة جديدة من تحقيق الأرباح، باستغلال أسماء نجوم الكوميديا وموضوعات الأفلام التي لا تنتمي للحسِّ الروائي في شيء.
ومع ظهور موجات للكتابة الجديدة، ظهر على استحياء تناول سينمائي جديد للرواية الأدبية في عام 2006م مع فيلم “عمارة يعقوبيان” المأخوذ عن رواية علاء الأسواني التي تحمل نفس الاسم .. شخصيات عديدة في الرواية، وراء كل منها حكاية، أتاحت نسج سيناريو سينمائي قام عليه الفيلم، والملفت أن مروان حامد مخرج الفيلم، هو أيضـًا من أخرج بعد ذلك أفلام “الفيل الأزرق” و”تراب الماس” و”الأصليين” للروائي أحمد مراد، وجميعها روايات ينحو مؤلفها في اتجاه الغموض والتشويق والإثارة.
ويمكن القول إن سينما جديدة صاحبت ظهور هذه النوعية من الروايات المعاصرة، والتي يصعب تحويلها إلى مسلسلات في اعتقادنا، فأعمال أحمد مراد على سبيل المثال، ليست موجهة للأسرة، وبالتالي تبتعد عن أهداف منتجي المسلسلات التلفزيونية.
هناك ‒ أيضـًا ‒ روايات عالمية تناولتها السينما والتلفزيون، مثل رائعة الأديب الروسي “ديستوفسكي” (الإخوة كرامازوف) التي عرضت سينمائيـًّا وتلفزيونيـًّا باسم “الإخوة الأعداء”، وربما أتاحت “تيمة” الخلاف بين الإخوة في العادات والسلوك فرصة السيناريو الممصر سواء على مستوى التناول السينمائي أو التلفزيوني.
وكذلك مسلسل “دهشة” المأخوذ عن مسرحية “الملك لير” لوليم شكسبير والذي كتبه عبد الرحيم كمال، صاحب النغم الخاص في الكتابة التلفزيونية.
وبالعودة إلى شاشة السينما الأقدم زمنـًا في الإطلال على المشاهدين، والأكثر جسارة في التعامل مع الكتابة الأدبية الروائية، والأقدر على صياغة معادل بصري يتناص أو ينتج عن العمل الأدبي، فإن السينما المصرية تمكنت باقتدار من خوض غمار السباحة في أمواج الرواية بكافة أشكالها وتعددية أصواتها، ومنحت الكاتب لقب بطل العمل في بعض الأحيان، بخاصة في زمن القراءة الذي كان سائدًا في منتصف القرن الماضي، فكان المتابع يقرأ الرواية ثم سرعان ما يتابعها على شاشة السينما.
ازدادت مساحة الكاتب الروائي – كما ذكرنا – عندما تحول إلى كاتب للسيناريو والحوار، فأصبح الحوار السينمائي ابنـًا شرعيـًّا للغة الرواية، وتعبيراتها، وشاعريتها.
يكفي
أن نذكر أن كتـّابًا كبارًا أمثال عبد الحميد جودة السحار
وعبد الرحمن الشرقاوي وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف السباعي قد كتبوا حوارات
وسيناريوهات بعض الأفلام التي حفرت في وجدان المشاهد العربي.
وما أن انحسر الاهتمام بتحويل الأعمال الروائية إلى أفلام سينمائية، حتى حلّ الابتذال اللفظي والشكلي محلها، وأصبحت السينما متهمة بتدني الذوق في بعض الأحيان، ولكن هل يكفي أن نتهم صناع السينما بالتقصير في حق الرواية؟ّ!
أظن أن الأمر لا يخلو من اتهام الرواية ‒ أيضًا ‒ بالمشاركة في هذا التقصير، سواء بتعاليها أحيانـًا عن بصر وبصيرة القاريء العادي، أو بتقولب موضوعاتها وجفاء لغتها التي صارت عصية على التحول إلى صورة جذابة.
إن السينما والرواية تحكمهما علاقات متشابكة تحتاج إلى كتاب مستقل بذاته لتحليل هذه العلاقة وتبيان الصالح والطالح منها.
لكن تبقى الحكاية “الحدوتة” إحدى مفردات المتعة الإبداعية، أيًا كان قالبها المكتوب أو المرئي.