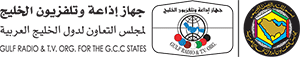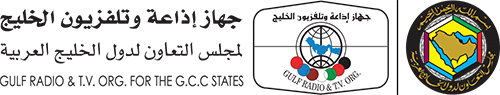ربما يكون تخصص الإعلام هو أكثر التخصصات معاناةً، ولسنوات طوال، من أعراض الانفصام العميق في العلاقة بين حقله المعرفي، وميدانه المهني، وهو الاعتلال الذي تسبب كثيرًا في عرقلة هذا النشاط المحوري في العديد من مجالاته، كما أدى إلى اختلاط وتداخل مساراته التطويرية على نحوٍ أربك أوضاعه على الرغم من الحاجة الماسة لتلاحمها، كما هو الحال مع التخصصات الأخرى.
أما كيف نشأت هذه الفجوة فمردها إلى أمور عدة أبرزها، أن رسالة الإعلام التي تخاطب الجميع دونما استثناء، أو أية توقف، صيّرت الرأي العام بأكمله شريكًا فاعلاً في الحكم على مادته ووسائله، بل إن القائمين على تلك الوسائل أنفسهم رسخوا هذه الشراكة، من خلال مناشدتهم للجمهور (الزبائن) في إبداء آرائهم عند تقييم مدى قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، والاعتقاد بوجود الشراكة، على الرغم من تحققها في جزءٍ منها، ينبغي ألا تؤخذ على إطلاقها؛ فاستطلاع آراء المتلقين لا تعدو أن تكون محاولة التعرف على مدى الرضا عن الأداء، وتلمس لبعض المؤشرات التي قد يستفيد منها أصحاب الصنعة في تجويد صنعتهم، بوصفهم الأقدر على اختيار الأنسب منها بما يتوافق مع الأسس والقواعد التي تفرضها طبيعة الممارسة المهنية.
ونحن إذا سلمنا بأن أصحاب الميدان أكثر دراية بواقعهم، لا بد أن نتذكر أن هناك متغيرات معرفية تحتاج إلى ما هو أعمق من قدرتهم على الحكم الآني، الذي لا يتسق مع مبدأ اتخاذ القرار الأسلم، وهنا يأتي دور بيوت الخبرة المعرفية، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية المتخصصة في الإعلام، وتحديدًا كلياته وأقسامه؛ إذ أن لديها من الإمكانات المنهجية ما يجعلها الأكثر تمكنًا في تشخيص المشكلات، وتحليل أسبابها، والوصول إلى نتائج موثوقة تتسم بالموضوعية والدقة التي ينشدها من يطلب التطوير.
هذا يعني بأن العلاقة بين الطرفين لا بد أن تكون مفتوحة للجميع ليس فقط لخدمة مصالح مؤسساتية، ولكن لأن نجاح صناعة الإعلام تعتمد على نضج هذه العلاقة وخلوها من المنغصات، غير أن مراجعة الواقع أظهرت في بعض مراحلها أنه عوضًا عن أن تكون هناك مظلة قوية ومحكمة تجمعهما؛ للبحث في أوجه التعاون بينهما، ومواجهة التحديات المشتركة في التخصص، كان هناك شبه استغناء غير منطقي عما يحتاجه كل طرف من الآخر، وذلك على الرغم من العجز عن قدرة كل منهما عن توفيره، وكان البديل الأقرب إلى التعسف في ذلك، أن استعاض كل منهما بمحاولات بائسة هي أشبه بحالات العلاج بالترقيع الهش، لتخسر الصنعة بأكملها في هذه المناكفة جزءً مهمًا من مقوماتها.
وكان اللافت أن كل طرف لم يكن مستعدًا لقبول وجود جمعية تضم أحدًا من كل طرف، ويؤكد هذا أن الجمعيات المتخصصة في المجال التي أنشأتها الجامعات بخست المهنيين حقهم في التمثيل، وأن الهيئات المهنية المتخصصة فعلت الشيء نفسه تجاه الأكاديميين باستثناء من سار في نفس تيار أهدافها. ومع تفهمنا لمبدأ التخصص الحصري لتلك الجمعيات أو الهيئات، إلا أنه كان عليها أن تبادر في تمكين كل طرف بالإسهام فيما يمكنه القيام به لخدمة التخصص.
هذه الظاهرة تجعلنا، قبل الخوض في الحديث عن الأخطاء التي وقع فيها الطرفان على حده، مما وسع الهوة بينهما وأثر سلبًا على التخصص، نشير إلى خطأ مشترك لديهما يتلخص في عقدة الـ”أنا” التي أوصدت الأبواب في وجه القيم المضافة، نتيجة اعتداد بالنفس هو أقرب في كثير من مظاهره إلى الغرور والتعالي الذي جاء في غير موطنه، وربما مرده في هذا هو أن أصحاب المهنة كانت لديهم القدرة على الوصول المتكرر للعامة بصورة صنعت لهم الشهرة، ومكنتهم من صناعة الصورة الإيجابية عن ذواتهم، وأن أرباب الحقل الأكاديمي رأوا في تحصلهم على الشهادات والوثائق، حصانة تحميمهم من النقد، وتضمن لهم بقائهم في محيط التخصص.
جفوة وفجوة:
إذًا كانت حالة التباعد هي السمة الغالبة بين الميدان المهني، وبين الخبرات الأكاديمية، والمتأمل في العوامل التي قادت إلى ذلك يتبين له أن كليهما يتحمل نصيبًا من اللوم في حدوث الجفوة التي أحدثت فجوة عميقة بينهما، وأسهما بشكل غير مقصود في نموها واتساعها؛ أما حجة المهنيين في موقفهم، فتكمن في استنادهم الدائم على حقيقة مفادها أن نشاط الإعلام يرتكز بالدرجة الأولى على مهارات الاتصال وموهبة الأداء، ويعنيهم على وجه الخصوص القدرة على التعبير وإيصال الرسائل للمتلقين، ولأن هاتين المهارتين تشكلان رأس مال قيم لصاحبها اعتقد من وُفِّق بنيلهما، أنه يمكن الاكتفاء بهما عند ممارسة مهنة الإعلام، وعزز من ثقته في هذا تمكين المؤسسات الإعلامية للماهرين من العمل لديها، مانحة إياه بهذه الخطوة تزكيةً ثمينة تفوق، في نظره، الحاجة إلى الحصول على شهادة في التخصص، وهي المنحة التي جعلت البعض منهم لا يكتفي بإضفاء لقب “إعلامي” عليه؛ وإنما قد يتجاوز ذلك إلى ممارسة دور تعليم المبتدئين في الممارسة وتدريبهم ليلتحقوا بمن هم في ميدانه.
ونحن إذا استثنينا أحقية وجدارة الممارسين من أصحاب الخبرة، في أن يقدموا ما لديهم من تجربة عريقة في مجالهم للآخرين، فإن الموضوعية تقتضي أن ينحصر إسهامهم في حدود معرفتهم الجزئية التي اختصوا بها، لا أن يُنظر لهم على أنهم خبراء في صناعة الإعلام بمحيطها الواسع وتشعباتها الدقيقة، أو أنهم مؤهلون لقيادة ميادين إعلامية تختلف في نشاطها عن النشاط الذي برزوا فيه، كما توجب القول بأن الإلمام بالجانب المعرفي بقواعد العمل الإعلامي وأسسه، تظل قيمة تكاملية مهمة يحتاج إلى أن ينشدها المهنيون أنفسهم، على نحوٍ يمكنهم من إدراك العلاقات التفصيلية والاختلافات الدقيقة بين وسائلها، مع الإحاطة بكيفية التعامل معها، مما يعني أن من شروط من يُعتد برأيه في اتخاذ قرارات التطوير في دائرة التخصص، أن يكون مدركًا لأبعاد العمل الإعلامي ومتابعًا لمستجداته، علاوة على امتلاكه للحس الإبداعي الذي يتسق مع الإعلام كفن؛ فدعم القدرات الفطرية بالمعلومات المكتسبة يُعد عاملاً مهمًا لتعزيز الثقة ولفهم صناعة الإعلام كما يجب.
إن إلقاء اللائمة فيما سبق ذكره على المؤسسات المهنية لا يعني بحال من الأحول تبرئة نظيراتها الأكاديمية من دورها في حدوث الانفصام بين الحقلين العلمي والعملي، فهي ممثلةً في أعضاء التدريس بها، ولأسباب متعددة، لم تكلف نفسها كثيرًا، وخاصة في بدايات نشأة أقسام وكليات الإعلام بالتواصل مع الجهات المهنية، وكان تواجد القلة من أفرادها في ميدانها لا تخرج عن دائرة المبادرة الفردية، أو أنها تمت عبر استقطاب محدود قامت به بعض المؤسسات الإعلامية نفسها، وقد تكون للصدف أو للعلاقات الشخصية دور في ذلك.
ومما يؤكد سلبية المؤسسات الأكاديمية في هذا الجانب، أنها لم تبادر ابتداءً – كما كان مفترضًا – في بناء أية جسور لتحقيق التعاون بين الطرفين، ولم تؤسس لشراكات مطلوبة بينهما، وفي حين يمكن تفسير عزوف بعض الأكاديميين عن الوسط المهني الإعلامي إلى عدم تمكين أصحابه من التماهي مع ميدان العمل بأكمله، فاقتصرت قنوات التواصل معه في مجالات محدودة، مثل: نشر مقالاتهم في الوسائل المطبوعة، أو استضافتهم في البرامج المرئية أو المسموعة، شأنهم في ذلك شأن أصحاب التخصصات الأخرى.
المعرفة قبل الممارسة
ومهما يكن من أمر، فإن من بدهيات نجاح الأداء وتحقيق الإنجازات بالصورة التي تقود إلى أهدافها الإستراتيجية في أي مجال أو نشاط، أن تسبق المعرفة الممارسة، فالطبيب أو المهندس أو الطيار، وكذلك المعلم لا بد أن يكون مسلحًا بسلاح العلم أولاً حتى ينجز عمله بالشكل المطلوب؛ بل إن عليه أن لا يقصر ذلك على مجرد حصوله على الشهادة العلمية وتخرجه من المؤسسة التعليمية، فلابد أن يواصل البحث والاطلاع بما يمكنه من مواكبة المستجدات، وأن يرتقي بأدائه إلى معرفة ما توصل إليه الباحثون من نتائج علمية، أو اقترحه المفكرون في التخصص من آراء تطويرية، وفي حال انقلبت المعادلة، فإن هناك خللاً وقصورًا يجب التنبه له.
ومع تفهمنا لطبيعة التخصصات، وكون البعض منها يصنف في فئة الفنون التي قد يبرع فيها الأفراد نتيجة لملكاتهم ومهاراتهم الفطرية، ومن بينها تخصص الإعلام، إلا أن امتلاك المهارة يبقى قاصرًا عن استيفاء مقومات النجاح في حال لم يتم صقلها بالجوانب المعرفية اللازمة لتحقيق التميز، وهذا يعني أهمية أن تكون المؤسسات التعليمية ذات إمكانات عالية على نحوٍ يتواءم مع تطلعات نظيراتها المهنية، التي ستبحث عن مبتغاها بطرق مختلفة في حال قصرت عن ذلك، وهناك بعض الشواهد التي تظهر شيئًا من عدم التناغم في بعض جوانب العلاقة التي لا يمكن أن تتحقق دون تنسيق مستمر بين الطرفين.
من تلك الشواهد على سبيل المثال أن المؤسسات الصحفية أو التلفزيونية كانت السباقة إلى استخدام بعض البرامج الحاسوبية في الإنتاج، قبل أن يتعرف عليها طلبة التخصص، لتصبح تلك المؤسسات – بصورة عكسية – هي مصدر التعلم للمؤسسات التعليمية، في حين أن الأصل – كما ذكرنا آنفًا – أن تسبق الثانية الأولى في ابتكار وتوفير المعلومات ابتداءً عن كل جديد، ليس لخريجيها الذين يجب أن يؤهلوا تأهيلاً كاملاً باحتياجات سوق العمل فحسب، بل وللممارسين، وأن تكون مصدر اقتراح للحلول المناسبة لمؤسسات السوق في كل ما يعترضها من أجل الارتقاء بمستوياتها، شأنها في ذلك شأن تعريفها بالبيئة الاتصالية ومتغيراتها المتجددة التي قد يجهلها الوسط المهني، كأن تكشف بعض الدراسات الأكاديمية عن نتائج قيِّمة تشخص طبيعة تعرض الجماهير لوسائل إعلام بعينها، وتنوه عن أبرز تحدياتها، والحلول الملائمة لتلك الوسائل.
القطيعة الملحوظة
خلاصة القول هو أن القطيعة بين المؤسسات الإعلامية، وبين كليات وأقسام الإعلام كانت ملحوظةً بدرجة محرجة، وملموسةً في عدد من الصور التي تبعث على الاستغراب، واستمر الأمر على تلك الحال حتى قرب نهاية القرن الماضي؛ إذ خلت تلك الفترة من أية تواصل مباشر فاعل، على الرغم من وجود القواسم المشتركة الجوهرية، التي لا يجهلها الطرفان؛ على الرغم من حاجة كل طرف للآخر بالنظر إلى الإمكانات الحصرية والإضافية لدى كل طرف، التي كانت ستعد عونًا لمواجهة تحديات كثيرة، من بينها التغيرات الهائلة اللاحقة، فكان من نتيجة تفريطهما أن ارتكبت كثير من وسائل الإعلام التقليدية أخطاءً مصيرية، وارتبكت في كيفية التعامل مع الفضاء الإعلام الرقمي، وظهر عيانًا أن من أبرز أسباب ترجع الكثير منها أنها اعتمدت في خطواتها التطويرية على اجتهادات فردية، في هيئة ردود أفعال متذبذبة لم تمكنها من الصمود في وجه التغيير ولم تنفعها في مقاومة طوفانه، وأثبتت المآلات التي انتهت إليها، شهادة داحضة على حاجتها إلى جهات محايدة تعتمد على رؤى استشرافية علمية، تتنبأ بطبيعة القادم الجديد، ومخاطره، والطريقة المثلى لمواكبة المستجدات بشكل مختلف في ضوء تغيرات عناصر الاتصال التي تشكل المحور الرئيس في اهتمامات ودراسات الباحثين.
ومع ذلك فإن هذا القول الذي بات أقرب إلى أمنيات فات أوانها، لا يعني بشكل مطلق التسليم بجودة مخرجات المؤسسات التعليمية، أو أنها الأقدر لوحدها على مواجهة تحديات الساحة الإعلامية، ولكن كان بالإمكان – من خلال جهة مرجعية تضم ذوي العلاقة – تحري مواطن احتياجات الميدان الإعلامي، وترشيح الكفاءات الأجدر القادرة على التشخيص، وتقديم التوصيات التي يرتضيها الجميع، ذلك أن المؤسسات التعليمية نفسها، لم تكن تخلو هي الأخرى من معوقات إيجاد الحلول الناجعة، في مقدمتها مشكلة “الأنا” التي كانت مستشرية لدى البعض داخل المحيط الأكاديمي نفسه، ولم تكن عدوى التنافر منحصرة في علاقة ذلك المحيط بنظيره المهني فحسب؛ بل ممتدة إلى داخل دائرة كليات وأقسام الإعلام أنفسها، وكان تواصلها مع بعضها البعض منحصرًا لسنوات طويلة في قنوات وقتية، وشكلية قد لا تتجاوز ترشيح بعض أعضاء هيئة التدريس من الكليات والأقسام الأخرى، لمناقشة الرسائل العلمية، كما أن الصلة داخل دائرة المؤسسات الإعلامية المهنية هي الأخرى لم يكن أحسن حالاً، فقد كانت مزيجًا من التنافس البنَّاء، وغير البناء الذي كانت أبرز مظاهره التراشق الساخن بين بعضها البعض في أكثر من موقف.
بزوغ المبادرات
على الرغم من أن العلاقة بين المنتسبين للميدان المهني، ونظرائهم الأكاديميين، ظلت ذات صبغة فردية في معظم أحولها، إلى أن بزغت بعض المبادرات الرسمية التي حاولت أن تقرب بين الطرفين أملاً في خدمة المصلحة العامة، كان من أبرز تلك المناسبات، مما يتذكره كاتب هذه السطور، ورشة عمل “تدريس الإعلام في الجامعات السعودية”، التي نظمتها وزارتي الثقافة والإعلام والتعليم العالي، في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، في الفترة من 27 – 29 صفر 1428هـ الموافق 17 – 19 مارس 2007م، بحضور مسؤولين من الوزارتين، وعدد كبير من منسوبي كليات وأقسام الإعلام، والمنتمين إلى الوسط الإعلامي من الممارسين في المؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، وعلى الرغم من أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها آنذاك، وأن معظمها ركز على التعريف بما توفره الجهات الأكاديمية لسوق العمل، وحاجاته التي ينشدها منه، إلا أن شرارة الجدل اندلعت حينما اتهم أحد الصحفيين أساتذة الكليات والأقسام بأنهم “أكاديميين” في تعبير قُصِد أو فُهِم منه وصفهم بعدم معرفتهم بحقل الممارسة، واعتمادهم بالدرجة على التنظير، وهي تهمة سرعان ما تصدى لها رئيس قسم الإعلام في إحدى الجامعات لمحاولة تفنيد ذلك الرأي؛ حيث أصر على أن حضور الأساتذة في الميدان الإعلامي قوي وربما يفوق بعض الممارسين المتواجدين، مستشهدًا في ذلك بأن ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في القسم الذي ينتمي إليه، يتولون رئاسة تحرير صحف بارزة في المملكة، ليس هذا فحسب – يتابع رئيس القسم المذكور – فإسهامات الأساتذة ذهبت إلى أبعد من ذلك إلى المشاركة مع أبرز وسائل الإعلام العالمية، إذ استعانت محطة (CNN) الإخبارية بأحد الأساتذة لديه، ليتولى مهمة التعليق المباشر على موسم الحج، ونال استحسان الكثيرين على الدور الذي قام به.
ضوء في آخر النفق
أملى نمو حاجات مؤسسات تعليم الإعلام ومؤسسات ممارسته، لبعضهما البعض، إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بعد أن كانت مقتصرة في البداية على مبادرات فردية لأعضاء هيئة تدريس بعض المقررات العملية، تمثل جزء منها في ترتيب زيارات ميدانية قصيرة لمقرات الصحف أو محطات الإذاعة والتلفزيون، بصحبة الطلبة للاطلاع على بيئة العمل الإعلامي وآليات ممارسته، وفتحت هذه الخطوة لدى الوسائل المستضيفة، الباب لاستقطاب الموهوبين من أجل تعزيز مواردها البشرية بكفاءات وجدت فيها تلك الوسائل ضالتها، ولم يقتصر الأمر على هذه الخطوة، بل أنها فتحت أبوابها لاحتضان طلبة مقرر التدريب التعاوني، الذي شكل فيما بعد ركنًا رئيسًا في بناء جسور التواصل مع الكليات والأقسام المتخصصة.
من جانب آخر أدركت بعض مؤسسات تعليم الإعلام مدى الحاجة إلى تمكين أصحاب الخبرة من تقديم تجاربهم في قاعات الدراسة، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تحسب للقائمين على تلك المؤسسات، وتنم عن إدراكٍ واعٍ للقيمة الحقيقة التي يملكها الناجحون منهم، وأنها أسهمت في التغلب على العجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة في فنون العمل الإعلامي، إلا أن هناك من عاب عليها أنه اكتنفها في بعض الأحيان مبالغة غير مدروسة في أعداد المستعان بهم، وأنها تخلت عن بعض شروط العمل الأكاديمي، وخاصة فيما يتعلق بالدرجات العلمية، ودرجة التمكن من إعداد البحوث والنشر العلمي.
وعلى الرغم من أن استعانة بعض كليات وأقسام الإعلام بالمهنيين تُعد ظاهرة صحية، غير أن أثرها كان محصورًا في تأهيل طلبتها، دون أن ينعكس ذلك على أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، إذ أن حاجتهم لتلك الخبرة لا تقل عن حاجة تلاميذهم، وهي إشكالية وقعت فيها الكليات والأقسام لوجود خلل في آليات اختيارها لأعضاء هيئة التدريس، خاصة المعني منهم بالمقررات المهارية، فقد كانت إلى وقت قريب، وربما لا يزال بعضها يسير على نفس النهج، يستقطب وبشكل مباشر أكفأ خريجيه من حيث التحصيل العلمي، لينضم إلى قائمة أعضاء هيئة التدريس لديه، دون أن يخوض أيًّا من المرشحين تجربة عملية في ميدان العمل المهني، وعلى الرغم من أهمية هذا المعيار المعرفي في الاختيار، إلا أنه كان الأولى بتلك الجهات التعليمية أن لا تستقطب من لم يمض على تخرجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو سنتين من أجل التعرف على قدراته العملية في مجال التخصص، وتقييم أدائه ومدى نجاح تجربته في ميدان العمل للحكم على مستوى ملائمته في الحقل الأكاديمي.