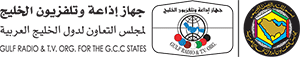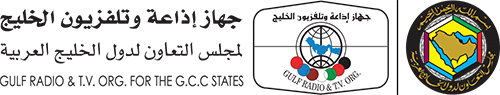الإعلام ضرورة.. هذه حقيقة؛ بل مسلمة لا جدال فيها، فحاجة الأفراد والمجتمعات له منذ القدم، بغض النظر عن أدواته وأشكال عرضه التي كان عليها وكيفية تطوره، هي خير دليل على ذلك، إذ إن الإعلام في صورته البدائية، بوصفه نوعـًا من أنواع الاتصال، متواجد بقوة في تشكيل حياة البشر الذين جبلت نفوسهم على تتبع مصادر المعلومة نتيجة سيكولوجية غريزة الفضول، وحبّ الاستطلاع المزروعة فيهم، وإن كان حجم استهلاكهم لمضامينه ليس على درجة واحدة، وإنما يتفاوت فيما بينهم بشكل ملحوظ، وفقـًا لعوامل عدة من بينها طبيعة الحاجات والاهتمامات.
من هذا المنطلق، فإن شقّ استهلاك المادة الإعلامية مثَّل – ولا يزال – جزءًا من السلوك الإنساني منذ القدم، وهو أمر نشأ في سائر الثقافات، وبمختلف اللغات من خلال سؤال يومي مستمر، أوجده حرص الأفراد الدائم على تعرّف كل ما هو جديد من أحداث في شتى الدوائر المحيطة بهم؛ قريبة كانت أم بعيدة، هذا السؤال الدارج يتلخص في: ما الجديد؟ أو ما الأخبار؟
لم تكن أدوات ووسائل الإعلام في البدايات كما هي اليوم، ولن تبقى وسائل اليوم شكلاً ثابتـًا لوسائل الغد، وبين كل حقبة وأخرى، يتجاذب القائمون بالاتصال والمستخدمون الساحة الإعلامية بين متمسك بالقديم، ومتحمس للجديد، وهي بكل تأكيد لن تحابي أيًا منهم طالما أن التغير والتطور هو سمتها؛ وبالتالي فإن المحك في الحكم مرتبط بالهدف الرئيس للنشاط، وهو إيصال “الرسالة” بأسرع وسيلة، وأقدرها على الانتشار الأوسع، مع ضرورة الالتزام بقيم الإعلام وآلية صناعة الرسائل، والأساليب المهنية الفاعلة التي تتلاءم مع طبيعة الوسائل، وكيفية تعزيز القدرة على استقطاب الجمهور.

وعلى الرغم من قِدَم الإعلام كنشاط، إلا أن ظهوره بمفهومه العصري كتخصص وكمهنة مستقلة، بما في ذلك تسميته بـ “الإعلام” (Mass Communication)، لم يبدأ إلا مع بزوغ نجم الطباعة التي أذنت بنشأة الصحافة بمفهومها العصري، كوسيلة قادرة على تحقيق انتشار ووصول متزامن إلى المجتمعات والجماهير على نطاق واسع.
ومع اختراع المذياع والتلفزيون، انضمت وسيلتان ذات شكل جديد في خاصية النشر الأوسع إلى الوسيلة الأم بعد أن كان يُظنّ أن الكتاب والسينما، وقبلهما الشعر والرواية هي أقصى أساليب النشر العريض.
هذا التطور وما تبعه من تحولات في أشكال التحرير وأساليب العرض وطرق البثّ المرئي والمسموع، قاد تدريجيـًّا، وفي تنافس بناء، إلى تشكل كيانات إعلامية صحفية وإذاعية وتلفزيونية، وإلى نشأة شركات إنتاج يشار لها بالبنان، كما أن الجهود العلمية التي صاحبته وتمثلت في دراسات تتطلبها المرحلة، وبخاصة البحوث التي ركزت على الانعكاسات والتأثيرات السلبية أو الإيجابية المتوقعة من الوسائل الجديدة، قادت هي الأخرى إلى تأسيس أقسام وكليات متخصصة في هذا الشكل الجديد للاتصال الجماهيري (الإعلام)، ويأتي في مقدمة تلك الدراسات وأشهرها على الإطلاق ملف دراسات متنوعة شارك فيها علماء متخصصون في علم الاجتماع، والنفس، والتربية، والجريمة، وغيرها ذات الصلة، وبتمويل حكومي وإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة الأمريكية Surgeon General.
الدراسات التي امتدت على مدى سنوات الستينيات الميلادية، كانت المعين الخصب لظهور حزمة كبيرة من النظريات التي لا تزال إلى اليوم مرجعـًا في بابها، والسبب الأعمق لنمو وتأسيس العديد من الأقسام والكليات المتخصصة.
كان حريـًا بهذه التغيرات أن تكون مؤشرًا كافيـًا للمعرفيين والمهنيين كي يدركوا أنهم حيال تخصص متغير ومتجدد، غير أن دور النشر الإعلامي وإمبراطورياتها ومعاهد وأقسام الإعلام وكلياته الأكاديمية الذين كانوا في خضم نشوتهم ببلوغ حقلهم مرحلة النضج، فوجئوا باقتحام عالمهم الأثير، ابتكارٌ مختلفٌ تمامـًا عمـّا اعتادوا عليه سابقـًا، الذي كان يقتصر على التعريف بوسيلة تضاف إلى الوسائل الأصل، وعلى تطوير يسهل تبنيه بصورة ترفع من إمكاناتهم فيضيف لها.
كان الابتكار هذه المرة مزلزلاً؛ فقد حلـّت الإنترنت كوسيلة هائلة الإمكانات ومتعددة المشارب، لتبتلع الوسائل التي لا تقبلها أو لا تتفاعل مع ما تفرضه من تغييرات في المبنى والمعنى، باختصار شكّل القادم الرقمي فضاءً جديدًا يقوض الفضاء القديم، ويغير من أشكال صناعة الإعلام التقليدية، ففرض مسارات اتصالية متنوعة لتقديم الرسالة التي هي الأساس بطرق أخرى، ولتقديم خدمات اتصالية غير مسبوقة ليس لكافة التخصصات الأخرى فحسب؛ بل وللجمهور بأكمله الذي أصبح شريكـًا في ممارسة الاتصال والنشر.
لم يكن لبعض المؤسسات الإعلامية أن تستوعب حجم التغيير الذي طال الصناعة، وظن القائمون عليها أن التعامل معه ممكن في ضوء محيط محدود كما كان عليه الأمر مع الابتكارات الأخرى؛ وتراوحت أسباب التجاهل بين فئة بالغت في الثقة بإمكاناتها، مستمدة أنفتها من حجم القوة التي اكتسبتها كسلطة رابعة يهابها حتى صناع القرار، وفئة أخرى عزّ عليها التخلي عن مصدر سخي لدخل إعلاني لا يمكن تعويضه بسهوله عبر أية خيارات أخرى.
لعل من المفارقات أن يشكل بعض من أصحاب تلك المواقف الذين برعوا لفترة غير قصيرة في صناعة الإعلام في مرحلة التحول عبئـًا على تطور التخصص وأن يتسببوا –من غير قصد – في انهيار مقوماته، وكان مكمن الخلل في حساباتهم أنهم لم يتوقعوا النتائج الكارثية التي ستحل ببعض المؤسسات القائمة لاحقـًا، فغادر كثير من تلك المؤسسات بصورة تراجيدية الساحة الإعلامية بعد أن كانت ملء السمع والبصر، ولو أنهم عززوا من علاقتهم البينية مع الشركاء الجدد في حقل الاتصال الذي بات مشاعـًا لكثيرين منهم، وتقبلوا حقيقة التقاطعات التي شكلها نسيج مختلف لقنوات اتصالية غير متناهية، محتفظين بخبرتهم وإرثهم العريق في كيفية صناعة المحتوى المهني، وليس في إدارة وسائله، من دون التشبث بالأدوات التقليدية، لحافظوا على مكانتهم في ثوب جديد قشيب.
وعلى الرغم من ذلك كله، لازال من بقايا الأمس من ظلّ يقاوم التجديد طوعـًا أو كرهـًا ويتمسك بأطر قديمة لا تجاري لغة العصر، من دون محاولة جادة للتطوير الشمولي الذي يستوعب المتغيرات ويتماهى معها، حيث استمروا في إسقاط قواعد عمل الزمن المتواري على واقع الحالة الاتصالية الجديدة، بما في ذلك مسميات المهنة وتصنيفاتها، في صورة تشبه تمامـًا إصرار مَنْ كان قبلهم على بقاء الوسائل، التي انهارت وسقطت معها الرسائل على الرغم من أهميتها، فخسر الجمهور مصادر معلومات ذات إرث تاريخي عريق اتسم بالموثوقية والمصداقية، وللإبقاء على وميض الوهج الذي يوشك على التلاشي، نشأت مجموعات وكذا جمعيات لا تكتفي بتأمل الزمن الجميل أو تتغنى به وتذكر الآخرين بما تحقق فحسب؛ بل إن بعضها يمنح عضويات غير واضحة المعايير أو الأسس، التي تذكّر في بعض ممارساتها بثقافة “صكوك الغفران” التي حتمـًا لن تُدخل أصحابها الجنة، كما أن هذه العضويات لن تعيد المجد القديم.
ومهما كانت قيمة الخسائر المادية والمعنوية التي منيت بها صناعة الإعلام خاصة في الدول النامية، أو حجم الفوضى التي حلـّت بساحته، وكذا درجة تشاؤم المتخصصين والممارسين حول مستقبله، فإن ذلك لا يعني نهاية الإعلام الذي سيظلُّ ضرورة وواقعـًا يفرض ذاته؛ غير أنه بحاجة ماسة إلى أن يخرج أصحابه من الصندوق العتيق بروح أكثر انفتاحـًا، وتطلعـًا للآفاق الأرحب، والتفاعل معها وفق ما يمليه الواقع، لا ما تختزنه العواطف، وذلك على نحوٍ يسهم بجدية في إعادة هيكلته، وترتيب عناصره بما يفضي إلى إعلام عصري مطور ينتظر العالم بدوله ومؤسساته وأفراده ولادته بطريقة موضوعية، وبفكر مختلف ومرن يضع الأمور في نصابها، ويقبل الحقائق، فيحترم كل ممارس للنشاط الاتصالي؛ ويُمنح المساحة التي تتلاءم مع دوره وفقـًا لدرجة تأثيره في الجمهور، في إطار تنظيم مهني شامل منضبط ودقيق.