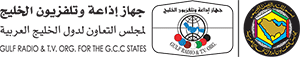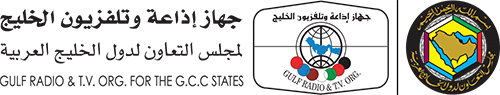مقدمة:
تقع الدراما التاريخية كنوع فني بين تجربتين إبداعيتين متلازمتين، وهما التجربة التاريخية الواقعية والتجربة التخيلية الفنية، وكلاهما يستوجب استحضار الذكرى التي تنهض على فاصل ميقاتي مخصوص تشكله تفاصيل زمن الحدث وجماليات زمن الحديث.
وبين الحدث والحديث تتأسس إكراهات استدعاء الماضي لحظة الحاضر، وتتأسس معها صعوبات ترحيل ما وقع في الأمس فعلاً إلى اليوم، ليبرز السؤال والجدل الفني المترامي بين الواقعي امتداديًّا والتخيلي ارتداديًّا.
ولعل المراوحة بين هذين العالمين المتناقضين: عالم التاريخ وعالم الفن، عالم الحقيقة وعالم الاستعراض، هو ما يؤجج السجال بين النقاد وعلماء الجمال والفنانين والأدباء حول إشكالية توظيف الصدق التاريخي في العمل الفني، وهذا السجال هو الذي يثير تساؤلات ذات بُعد فني عميق خاصة عندما يتعلق الأمر بإشكالات بناء الفيلم (التاريخي – أي القصة) وتوظيف الحقائق كمصدر أساسي لها، خاصة في ظل وجود أعمال جنحت إلى مخالفة التاريخ إلى درجة التشويه من أجل تحقيق المتعة والإثارة أو من أجل متطلبات الحبكة الدرامية.
وإذا كان بعض النقاد يرون في عينة من الأفلام التاريخية الغربية نموذجًا للنجاح كأفلام (سبارتاكوس Spartacus ) و(غلادياتور Gladiator) و(المومياء The mummy )، فإنهم يجمعون على أن الدراما التاريخية العربية ما تزال – على استثناءات قليلة – تفتقد للنص الجيد الصادق الذي يعكس فعلاً عبارة “دراما مستوحاة عن قصة حقيقية” على تتر المسلسل، علاوة على معضلة الإنتاج التي يفرضها الاستثمار في صناعة هذا النوع من الدراما.
وحتى نستوضح فحوى هذا الجدل لا بد أن ننطلق من مسألة القضايا الفنية الآتية: ما الدراما التاريخية؟ ما مقوماتها؟ كيف نقيم طبيعة التعالق التصويري بين الفني والتاريخي؟ ولماذا تحول “النص” إلى بؤرة نقاش معرفي وفني في وضع الدراما التاريخية العربية؟ وما الذي يجعل صناع الدراما في الوطن العربي يتباهون طورًا ويتحفظون طورًا آخر حيال مقولة “إنتاج درامي ضخم”؟.
1-الدراما التاريخية.. توليد إبداعي للمعنى الفيلمي:
تعد الدراما التاريخية بكل ما تحمله من إثارة ومفارقة خطابية “صنعة” تلفزيونية مخصوصة تقوم على فكرة توليد المعنى الفيلمي، من خلال الإفادة من التفاصيل التي بصمتها الذاكرة من المخزون المتوافر بالتراث الإنساني، وتلوينها بجماليات السرد السينمائي من أجل التأثير في المتلقي().
بهذا، تعبر الدراما التاريخية عن ذلك السجل الذي يشمل الأعمال الفنية التي تستحضر أحداث التاريخ وشخصياته برؤية فنية فيها جانب من التخيل، وهو ما يتجسد في بناء السيناريو والحبكة والقدرة التمثيلية للممثلين بما فيها من تعبيرات لغة الجسد والحوارات والموسيقى التصويرية… وغيرها من المؤثرات التي تختزل حدود التجربة الإنسانية المفعمة بالمتعة والتشويق().
وإذا ما وقفنا عند معنى التخيل ها هنا، فإننا نجده يفيد لغة التشبه والتوهم، فنقول خال يخال ومخالة الشيء بمعنى ظنه وعكسه اليقين والحقيقة(). وفي هذا السياق تذهب الباحثة الألمانية (كايت هانبرغر Kate Hamburger) إلى أن لفظة (Fiction) مشتقة من اللفظة اللاتينية (Fingere) ومعناه الابتكار الذي يتوازى والتخيل في نظرية الفن كما هو الشأن في المسرح والرسم والسينما().
وأيا كان مجال التخيل، فهو دون شك شرط أساسي لتحقيق الوقع الجمالي لدى المتلقي، وهو مطلب كل تواصل فني، الأمر الذي ينفي حصر الدراما التاريخية وتأطيرها في حدود الوظيفة التوثيقية للأحداث، فليس من مهمة الأفلام التاريخية أن تعمل عمل المؤرخين والمتاحف، ولكنها تنقب في التاريخ عما يشكل ملامح الفعل الدرامي وينسج خيوط التماهي مع أحداثه().
ولا شك أن معيار نجاح أي فيلم تاريخي لا يقترن بتقديم الماضي بدقة مطلقة، ولكنه يتحدد بما يتوافر له من إمكانات لإعادة إحياء السرد التاريخي وتحويله إلى تجربة سينمائية ممتعة قادرة على جذب الجمهور وتحقيق عائدات مادية للمنتجين.
إن إدراك هذه المحددات يقودنا لفهم أوضح لمقومات الدراما التاريخية، والتي تتبلور في:
أ-خضوع النص الدرامي التاريخي لمركبين أساسيين يصوغان جوهر السرد الفيلمي، هما: الزمان، ممثلاً في الأحداث والوقائع، والمكان الذي تحدده الشخصيات، الملابس، الديكور وكل المدركات البصرية التي تحيل إلى زمن القصة.
ومن هنا يمكن القول أن الدراما التاريخية، هي كما عبر عنها (جيرار جينيت Gerard Genette ) “فن كائن في المكان ممتد في الزمان”().
ب-“إستعراضيتها”، فهذه الدراما على الرغم من كونها محتوى حافل بالوقائع التاريخية، فهي نسج فني مليء بتوظيف الخيال والغرابة أحيانًا، ولنا في مثال “هند بنت عتبة” وهي تأكل كبد “حمزة” صورة دالة على وجود العجائب وتجلي الغرائب في فيلم “الرسالة”، ومع ذلك تظل هذه اللقطة لفتة سينمائية استطاعت أن تصعد بالواقع التاريخي في الفيلم، وأن تقدم للمشاهد مزيجًا من المشهد والموقف ومن التاريخ والتمثيل.
على هذا النحو، يغدو الفن بالنسبة للتاريخ عاملاً من عوامل قبول المتلقي للمادة التاريخية، فهو ضرب من الأساليب الجمالية التي يقتضيها العمل الدرامي الذي يبحث في كيفيات تحرير السرد الفيلمي التاريخي من عقدة التوثيق التاريخي الجامد للوقائع والأحداث، ولعل هذا ما يعطي الانطباع بأن التاريخ المروي هو – أيضًا – من صميم الواقع().
وهذه “المجازية” التي توصف بها الكتابة الدرامية للفيلم التاريخي هي التي تجعل منه إبداعًا مؤثرًا في بناء الذاكرة الجمعية للشعوب والأمم، فهو الذي يصور انتصاراتها وانكساراتها، وهو الذي يرصد أمجاد أبطالها وكفاحهم في الحياة، كما ينقل مظاهر تراثها ومنظومة قيمها، الأمر الذي ينسجم والفكر الذي يرى في الدراما التاريخية اتصالاً عابرًا للثقافات().
وما دامت الدراما التاريخية وعاءً إبداعيًّا طافحًا بالأحداث والمعلومات التاريخية، فهي تشكل دون شك مصدرًا للكثير من الناس ممن يفضلون الحصول على الحقائق والمعلومات من الأفلام التي يشاهدونها عوضًا عن اللجوء إلى الكتب والمصادر التاريخية، بل وحتى الروايات المكتوبة كما هو الحال بالنسبة للأجيال السابقة.
هذا يعني، أن الدراما التاريخية ليست إنتاجًا يستهدف التسلية وتحقيق المتعة للمشاهدين، ولكنه عمل إبداعي أسمى يتوخى بلوغ الكثير من الأهداف، منها تنشيط الذاكرة الجمعية والمحافظة عليها وتحفيزها، ونقل التراث الثقافي عبر الأجيال بكل ما يحمله هذا التراث من مبادئ وقيم وعادات وأفكار قادرة على بناء صورة ذهنية واضحة عما يزخر به الماضي من أحداث وعبر().
ونظرًا للمعلومات والحقائق التي تقدمها هذه الدراما اعتبرها النقاد مصدرًا مهمًا من مصادر كتابة التاريخ، فهي لا تعوض ولا تكمل التاريخ المكتوب، ولكنها تُسهم في إغنائه ومده بمعطيات مهمة، ولهذا فهي غالبًا ما تكون البوابة الأولى التي يمر من خلالها الناس لفهم الماضي.
وإذا كان التاريخ هو فعل تصوير الوقائع والأحداث، فإن الدراما فعل يختزلها في لقطات، ولهذا كان لا بد:
ج-أن تتفوق بقدرتها على التعبير عن التاريخ بصدق، وذلك من خلال ترتيب اللقطات التي تنسق الأحداث وتضعها في زمنها الفعلي، وليس في زمن التصوير، ومن ثم تجعلها تظهر في زمن التقديم وكأنها أحداث ماضية تجسد التاريخ على نحو أمين.
ولعل مسألة الصدق الفني، هي التي كانت محل خلاف وسجال بين جمهور النقاد والفنانين، ذلك أن الصدق بمعناه التقليدي الحرفي يعني أن ينطبق الفيلم على الواقع التاريخي انطباقًا تامًا، في حين أن السينما أو الدراما التلفزيونية هي منوال فني يمكن أن نوصفه بمقام البعث الإبداعي الذي تتوالد وتتناسل منه مجموع الاستيهامات المتخيلة والمتوقعة عن الأحداث المصورة().
ولأن الدراما التلفزيونية – على غرار باقي الفنون – ترفض المماثلة والمطابقة الآلية للحقيقة التاريخية دون أي تحوير أو تغيير نشأ نقاش معرفي وأكاديمي جاد حول:
2-طبيعة التعالق التصويري بين الفني والتاريخي:
من النقاشات المحتدمة التي سجلها تاريخ الفن المعاصر تلك التي تناولت إشكالات التعالق التصويري بين الفن والتاريخ، وما نتج عنها من تضارب في الرؤى بين مدافع عن فكرة التخيل الذي يمتلك قدرة على صناعة واقع يمكن إحساسه وحتى تلمسه مجازيًّا، ومتحيز لدور التوثيق المهم في إرساء بنية السرد الفيلمي التاريخي، ولكل منهما حججه ومنطق إقناعه.
يسترشد الفريق المدافع عن حرية مخرج العمل الدرامي في التعامل مع التاريخ بالهواجس الفنية التي يفيض بها سؤال: هل يجب على صانعي الأفلام التاريخية أن يثقفوا جمهورهم أم أن يسلوه؟ بمعنى آخر هل يفترض في العمل التاريخي أن يولي أهمية للحقائق أم للقصة؟.
علمًا أن هناك العديد من الأفلام التي حرفت من مجريات التاريخ، ومع ذلك حصدت العديد من الجوائز العالمية، وحققت أرباحًا طائلة مثل أفلام “مملكة السماء”، و”القلب الشجاع”، التي تجاوزت إيراداته (210) مليون دولار في شباك التذاكر، وفيلم “هنري الخامس”…. وغيرها كثير.
فحسب هؤلاء، فإن ما يشد الجمهور للأفلام التاريخية ليست الوقائع كما حدثت في أوانها، وإنما حقائق الإنتاج السينمائي التي توحي بأن ثمة اندماج تاريخي ممنهج يقود إلى الإحساس بفقدان الارتباط بالواقع الفعلي مقابل الانتشاء بواقع الشاشة أي الصور().
وهذه العلاقة شديدة التداخل بين الواقعي والتخيلي، هي التي مكنت العديد من الأدباء الذين برعوا في كتابة هذا النوع من الدراما من تخليد أسمائهم بأعمال كبيرة نذكر منهم الأديب (شكسبير)، الذي مزج التاريخ بروح الفكاهة في رسم العديد من الشخصيات الدرامية، وهو ما تجسد في الكثير من مسرحياته مثل: “الملك هنري السادس” عام (1592)، و”الملك ريتشارد الثاني” عام (1593)، وكذا الأديب المصري العالمي (نجيب محفوظ) الذي اتخذ من التاريخ نقطة انطلاق له في العديد من رواياته مثل: “عبث الأقدار” و”كفاح طيبة”، وكذا أمير الشعراء (أحمد شوقي) الذي أفاد من التاريخ في تأليف مسرحيات كثيرة، مثل: “كليوباترا” و”مجنون ليلى”، و(صلاح عبد الصبور) في “مأساة الحلاج”، وأيضًا (فاروق جويدة) في مسرحياته: ” الوزير العاشق” و”دماء على أستار الكعبة” و”الخديوي”… وغيرها.
إن الإيهام باستحضار التاريخ هو الذي يمثل جوهر الرؤية الفنية، وهو الذي يجعل الفيلم قابلاً للتسويق، وليست الأحداث التاريخية بحد ذاتها، فوحدها المعالجة هي التي تحدد الفارق بين المؤرخ الذي ينقل حدثًا وقع في زمن ومكان ما، والفنان الذي يستثمر فيما يجعل هذا الحدث سلسلة مشاهد تتوالى أمام المشاهد توالي إيقاع الحياة ذاتها، ولهذا حرص أرسطو على وضع الفن في مرتبة أسمى من التاريخ، فالفن يروي الكلي بينما يروي التاريخ الجزئي().
فحتى وإن كان المشاهد يعرف أن الحدث لم يحدث بالطريقة التي رواها الفيلم، فإن التصوير السينمائي يعطيه الوهم بأنه حدث بتلك الطريقة بالفعل، وهذا من عبقرية وسحر السينما().
ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهل هذا يعني إطلاق العنان لصناع الأفلام لكي يعبثوا بالحقيقة التاريخية لصالح نمو الخيال، بحيث يصبح التاريخ مجرد تابع للحبكة الدرامية؟ الواقع أن الذي يحمل الإجابة على هذا الانشغال هي أفكار دعاة التوثيق في الدراما التاريخية التي تؤكد على ضرورة البحث والتقصي وقراءة التاريخ قراءة جيدة للوصول إلى المعلومات التي تثري هذا التناول التاريخي وتجعله أقرب ما يكون إلى الحقيقة التاريخية.
إن الحديث عن الحقيقة التاريخية وفقًا لهذا الاتجاه يعني التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقائق التاريخ وحمايتها من العبث والتشويه، والابتعاد عما يروج له البعض من أفكار مغلوطة عبر أطروحاتهم الزائفة عن “التاريخ الافتراضي”، فالتاريخ هو التاريخ، وعلى صانع العمل الدرامي أن يتقيد بالمادة التاريخية، وأن يلتزم بعرضها عرضًا حقيقيًّا صادقًا، خاصة وأن هذا النوع من الدراما يُسهم في تشكيل “الصورة الذهنية”، وصياغة “الوعي الجمعي” للشعوب، وإذا تم تزييف الأحداث التاريخية بما يخل بما يعرفه المشاهد، فإن ذلك سيصنع جدلاً ونقاشًا واسعًا حول التعارض الصارخ بين الثابت من التاريخ والمروي في ثنايا الفيلم، وإذا كان صانع الدراما غير مطالب بالخضوع كليًّا لحقائق التاريخ، فهو مطالب بعدم مناقضتها أو تجاهلها أو تزييفها().
3-النص والإنتاج في الدراما التاريخية العربية:
دأبت القنوات التلفزيونية العربية منذ أكثر من عقدين من الزمن على بث مسلسلات تاريخية ودينية، خاصة في شهر رمضان المبارك، فكانت بحضورها على الشاشة الصغيرة تفيض بالروحانية والسجايا الأخلاقية، الأمر الذي جعلها في المخيال الجمعي العربي جزءًا لا يتجزأ من طقوس وتقاليد هذا الشهر الفضيل.
وبقدر تعلق المشاهد العربي بهذا اللون الدرامي الخلاق، وبقدر ما أمتعه وأضاف إليه من روافد معرفية جمة ولغة عربية جميلة وراقية، بقدر ما تتأسف في الآونة الأخيرة جموع عربية غفيرة لغياب هذا النوع من الإبداع عن شاشاتنا الصغيرة، الأمر الذي يعزيه الكثير من النقاد إلى ندرة كتَّاب الدراما التاريخية ممن يجيدون الانطلاق من الماضي لنسج قصة محبوكة الأطراف، تقوم على شخصيات تجسدها من خلال الحوار والصراع والأحداث.
فالنص في الدراما التاريخية – تحديدًا – هو اللبنة الأساسية التي يقوم عليها العمل الدرامي، ولهذا فهو يتطلب كاتبًا مبدعًا متفردًا في التنقيب في عصور الماضي عما يوحي له بفكرة تاريخية – حدثًا أو سيرة – ذات قيمة إنسانية تهم أكبر عدد ممكن من الناس، لهذه الاعتبارات وجب على كتَّاب الدراما التاريخية البحث عن القصص التي تُسهم في إيقاظ وعي وحكمة الأجيال الجديدة من خلال تحفيزهم على تقدير الذات، والاعتزاز بالهوية وتقوية انتماءهم للأمة من خلال التشبع برموزها ومآثر أبطالها وتجاربهم في الحياة.
وتُمتحن براعة كاتب الدراما التاريخية في بناء النص من تفكيره في العنوان بدءًا، فهو مفتاح البنية السردية والمختزل لأفكار وأحداث العمل، ذلك أنه بمثابة معادلة رئيسية تتصدر العمل، ترسم خطوطه الكبرى وتضيء عتمات مضمونه، ولهذا وضعه “جيرار جينيت” ضمن المتعاليات الفنية التي تستوجب الحذر والدقة في الصياغة()، فكثيرة هي الأعمال التي ارتبطت بعناوين لشخصيات تاريخية عربية، حيث بدت للوهلة الأولى وكأنها مسلسل سيرة ذاتية تقليدي، ولكنها في الأصل هيكل بنائي شامل لأحداث مثيرة ومشوقة، مثل: مسلسل “الطارق” الذي تمحور حول شخصية القائد الإسلامي طارق بن زياد، ورصد مختلف المراحل والتحولات التي مر بها منذ مولده في إحدى قبائل البربر في شمال إفريقيا وحتى توليه قيادة الجيش، وإسهاماته في فتح الأندلس، إلا أن ما كان يأسر المشاهد – حسب النقاد – ليس هو تتبع السيرة الشخصية لبطل المسلسل بقدر ما هي الأحداث والصراعات التي عكست حالة التشتت والضعف التي عانت منه تلك المنطقة بسبب استبداد حكامها.
وعليه، فإن الحبكة الدرامية هنا لا تتعلق بسيرة البطل بقدر ما تتصل بسير الأحداث وتصاعد الأزمات وتشكل الصراع الذي تجسد في فيلم “الطارق” من خلال رصد الواقع السياسي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية المسكوت عنها.
هنا تغدو صياغة العنوان عملية إبداعية ملزمة تقود الكاتب إلى الاهتمام والإلمام بأبرز الأحداث الدرامية التي يمكن أن تعكس مسمى العمل عوض تقويضها في اسم البطل، وهو المنحى الدلالي الذي أفاد منه بعض كتَّاب الدراما التاريخية، كما هو الشأن بالنسبة لمسلسلات: “قمر بني هاشم” الذي يُعد أحد أشهر المسلسلات التاريخية العربية القليلة التي استعرضت السيرة النبوية كاملة على مدار حلقات كانت حافلة بعوامل التشويق والمفارقة الدرامية، ونفس الشيء يقال على مسلسل “صدق وعده”، الذي تدور أحداثه حول قصة حب جمعت بين أعربي شاب وفتاة تدعى “عناق”، وهي أحداث تزامنت مع بداية الدعوة الإسلامية وسلطت الضوء على طبيعة الحياة الجاهلية، وكيف تغيرت تدريجيًّا من خلال الشخصيتين الرئيسيتين بعد انتشار الدين الحنيف.
ومثلما يتعين على كاتب الدراما التاريخية إيلاء العنوان الأهمية القصوى في جمع شتات المادة الروائية()، فإنه يتعين عليه – أيضًا – تحري الصدق في صياغة عالم الحكاية بما فيه من أحداث وشخصيات وجغرافيات متباينة من حيث العمارة، الطبيعة، الأسواق، المعابد، القصور …. إنتهاءًا بتوظيف جمالية الأزياء أو الملابس والإكسسوارات.
لهذه الاعتبارات كان على كاتب هذا النوع من الدراما توخي الحيطة والحذر والعمل باحترافية على تحري الدقة في تجسيد الحياة التي تناولها العمل بكل موضوعية().
وحتى يتأتى له ذلك، عليه الاستعانة بمستشار تاريخي متخصص، وعدم الاكتفاء بالمُراجع التاريخي الذي ينتهي دوره عند مراجعة النصوص فقط، فمهمة المستشار التاريخي لا تقف عند حدود التمحيص والتدقيق للأحداث، ولكنها تشمل المشاركة في مختلف مراحل الإنتاج: كترشيح أبطال العمل الدرامي، وتصميم الديكور، وتحديد أماكن التصوير واختيار الملابس مثلما هو متبع في الغرب().
من خلال المعطيات السابقة، يتأكد أن مفهوم الصدق في تحويل التاريخ لا يتوقف على المعرفة التاريخية وحدها – أي معرفة الثابت من الحقائق التاريخية – ولكنه يستدعي – أيضًا – أن يتوفر للسيناريست الحس الزمني والثقافي واللغوي الذي يكفل له ترجمة أسلوب حياة الناس في ذلك الزمن، وينأى بالعمل عن الوقوع في الأخطاء، كتلك التي طالت مسلسل “أحمس” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2021م، وأدت إلى وقف إنتاجه؛ لما تضمنه من أخطاء في الملابس والأزياء والإكسسوارات، وشكل الممثلين كلحية بطل الفيلم التي ظهرت على نحو مخالف لما هو معروف عند المصريين القدماء الذين كانوا حلقى اللحى والرؤوس لأنهم كانوا يعتبرون أن الشعر نوع من الدنس والنجاسة، وكانت تلك هي السمة الأساسية التي يفرق بها المصري عن العدو الأجنبي هكسوس أو عبراني… أو غيره.
وقد أثارت هذه الأخطاء التي ظهرت في الإعلان الترويجي للمسلسل غضب الجمهور والنقاد على تشويه التاريخ، مما أدى إلى تأجيل عرضه.
إن تقديم الرؤية الاجتهادية لكاتب الدراما التاريخية أمر محمود شريطة عدم تحريف أو تزييف الوقائع لجهة مكانها وزمانها وأبطالها وأحداثها الحقيقية، مثلما وقع في فيلم “وإسلاماه” وهو فيلم تدور أحداثه في فلك التاريخ وليس فيلم تاريخي، وذلك لأن شخصياته شخصيات تاريخية وحقيقية، وقصته لها أصل في التاريخ، وهي قصة “سيف الدين قطز” واسمه الأصلي محمود، وهو ابن أخت السلطان “جمال الدين خوارزم شاه” الذي قضى على التتار في مملكته.
أُسر “قطز” وهو صغير وصار من المماليك العاملين لدى السلطان “عز الدين أيبك”، وبعد قتل السلطان على يد زوجته “شجر الدر” صار “قطز” سلطانًا على مصر وتولى قيادة الجيش المصري في معركة “عين جالوت”، حيث كرس حياته كلها لهدف واحد هو القضاء على التتار والانتقام منهم بسبب ما فعلوه بأسرته، وهو ما حققه بالفعل في هذه المعركة التي قادها بنفسه، والتي اهتز فيها ميزان القوى مرات عديدة وانتهت إلى نصرة المسلمين بقيادة السلطان “قطز” وهزيمة التتار.
ومن الأخطاء الفادحة التي سجلها المختصون في التاريخ على هذا العمل إضافة الكاتب لشخصية “جلنار” أو “جهاد”، والتي تحول معها الفيلم من ملحمة تاريخية إلى قصة أو حالة من الحب والعشق بين “جهاد” و”محمود”.
أما من ناحية الأحداث، فالأخطاء كانت ذات دلالة، ومنها هروب “قطز” وقيام الخادم المسؤول عنه ببيعه كمملوك حتى لا يعثر عليه المغول، بينما الحقيقة التاريخية تفيد أنه تم أسره بين الأطفال الذين حملهم التتار إلى دمشق وباعوه كمملوك.
إصرار الكاتب على أن المغول كانوا دائمي البحث عن “جهاد” و”محمود” لكي يتمكنوا من الاستيلاء على الحكم، وهذا عبث لأنهم بالفعل استولوا على الحكم.
ومن المغالطات الكبرى التي خالفت الرؤية التاريخية في الفيلم وجود “جلنار” في معركة “عين جالوت” وترديدها عبارة “وإسلاماه”، والحقيقة أنها قُتلت قبل المعركة وأن “قطز” نفسه هو من ردد هذه العبارة حين ألقى خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوته “وإسلاماه”، وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقة، فأيده الله بنصره ولم تنقض ساعات حتى تفوق المسلمون وسحقوا المغول().
وقد ورد في الفيلم – أيضًا – أن “سيف الدين قطز” قد أخلى سبيل رسل التتار، ولكن الحقيقة تفيد أنه قتلهم وعلق رؤوسهم على أبواب القاهرة من باب “زويلة” إلى باب “النصر”، وذلك لأنهم أساءوا الأدب وتكبروا عليه، وكان الهدف من تعليق رؤوسهم على أبواب القاهرة الرئيسية رفع معنويات الناس وإعلان الحرب على التتار، الأمر الذي من شأنه أن يلقي في قلوبهم شيء من الرعب والتردد().
وهو ما اعتبره القائمون على الفيلم بأنه مخالف لأصل الدين الإسلامي، فالرسل لا تُقتل حتى ولو كانوا كفارًا أو مرتدين عن الإسلام، ولهذا حرصوا على تصحيح ما حدث من “سيف الدين قطز” مع الرسل بأن صوروه وهو يطلق صراحهم، وبذلك وقعوا في الخطأ لأنهم شوهوا وغيروا في الحقائق.
وكثيرة هي الأعمال التي انطوت على تناقضات صارخة مع الأحداث الحقيقية، كما وقعت في التاريخ، ويكفي أن نذكر هنا أفلام: “الناصر صلاح الدين”، “ألمظ وعبده الحامولي”، ومسلسلات كثيرة تم التراجع عن بثها، مثل: مسلسل “الملك محفوظ” جراء الانتقادات الكثيرة التي وجهها له المختصون إبان الإعلان الترويجي للمسلسل.
وهذا يعني أن ثمة تهاون بالأخلاقيات والضوابط التي تحكم صناعة هذا النوع من الدراما في المجتمعات التي تحرص على صون تراثها وقيمها الحضارية من مزالق التزوير، الأمر الذي دفع عددًا من النقاد والمختصين في علم التاريخ والحضارات والآثار إلى المناداة بحتمية التناغم بين التاريخ والإبداع الدرامي، مشددين على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للدولة خصوصًا مع جنوح قطاع عريض من متلقي المعرفة التاريخية لاستقاء معلوماتهم من السينما والدراما.
كل ذلك مهد للأفكار التي توحي بأن التسرع في الإنتاج الذي يقره السباق الرمضاني، وغياب الأطر القانونية التي تنظم صناعة هذا الفن، يؤدي إلى إهمال التوثيق التاريخي بما يفرضه من وقفات جادة لكل من علماء التاريخ والآثار والترجمة للإحاطة بلغات تلك العصور، ما يدفع صناع الدراما للاستسهال الذي ينأى بهم عن ملامسة جوهر التاريخ وعمق الحضارات.
ومما يلهب جدوة الجدل المزمن حول الدراما التاريخية العربية ما تواجهه من مشاكل عويصة في الإنتاج ومن تكلفة باهظة بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للديكورات، والملابس، والمجاميع البشرية، والخيول والعتاد الحربي… ومناطق تصوير غير تقليدية.
هذا، علاوة على المخصصات المالية الكبيرة التي يفرضها طاقم التمثيل ممن يتم اختيارهم من كل أقطار الوطن العربي من ذوي الخبرة والمؤهلين لأداء أدوار تستوجب الإلمام بالمتطلبات المعرفية والنفسية للشخصيات فضلاً على إجادة اللغة العربية، وهو ما يستعصي توفره في ظل تراجع المستوى الثقافي للكثير من الممثلين الذين أصبحت تعج بهم الساحة الفنية مؤخرًا.
أمام هذه الصعوبات تجد شركات الإنتاج نفسها مكرهة على الاتجاه نحو الأعمال الدرامية ذات الربح السريع والمضمون عوض المجازفة بإنتاجات تاريخية ضخمة، خصوصًا مع إعراض القنوات الفضائية عن شرائها، وعزوف المعلنين والرعاة عن المغامرة بالاستثمار فيها.
مع هذا تبقى الدراما التاريخية واحدة من أهم أدوات ومرتكزات الإبداع الهادف الذي يتوخى سبر أغوار ثقافة وحضارة الأمة العربية التي وإن فقدت تاريخها فقدت بريقها.
خاتمة:
إن الإقرار بأهمية الدراما التاريخية في حياة الشعوب إنما يتأتى من كونها تجربة فنية فريدة تتشارك فيها الكاميرا لتقدم لنا متعة مع السرد التاريخي الموضوعي الذي يجعل الأفراد أكثر حكمة، وليس التشويه الذي يجعلهم كما يقول – فرانسيس بيكون – أكثر حماقة وأقل كياسة.
وحتى يعود مجد هذه الدراما النابضة بالحنين والعبر والمعرفة، فإن ذلك يستدعي تضافر الجهود، وتعبئة الإمكانات لإنتاج أعمال درامية ترقى إلى عظمة تاريخ الأمة العربية ومجدها.