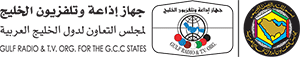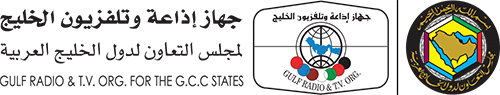أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العقدين الأخيرين تحولًا جذريًّا في أنماط التفاعل الإنساني، ليس فقط على مستوى التواصل والعلاقات، وإنما امتد تأثيرها العميق ليشمل التوجهات الاقتصادية، والسلوكيات الاستهلاكية للأفراد والأسر.
لم تعد هذه المنصات مجرد فضاء افتراضي لتبادل الصور والأفكار، بل تحوّلت إلى سوق مفتوح دائم لا يعرف الحدود الزمانية أو الجغرافية.
في هذا السوق، تُعرض المنتجات وتُروّج الخدمات من خلال تقنيات متقدمة تستغل البيانات الشخصية، وتستثمر في علم النفس السلوكي لإحداث التأثير المطلوب على المستهلك.
وفي خضم هذا المشهد، يتشكل السلوك الاستهلاكي الحديث بطريقة متسارعة، يطغى عليها الطابع العاطفي، والاندفاع غير المدروس، والبحث المستمر عن التماهي مع الصور النمطية التي يصنعها المؤثرون والمشاهير.
تُظهر الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين تصفح وسائل التواصل وازدياد السلوكيات الاستهلاكية غير المخططة، فقد كشف تقرير صادر عن شركة “نيلسن” أن أكثر من (70%) من المستخدمين قد قاموا بشراء منتجات أو خدمات بعد مشاهدتهم إعلانًا أو توصية من أحد المؤثرين.
هذه الظاهرة تتزايد خصوصًا بين فئة الشباب والمراهقين، الذين يتأثرون بسهولة بالصور والمحتوى البصري المكثف الذي يعرض حياة فاخرة أو نمطًا استهلاكيًّا يُربط ضمنيًّا بالنجاح والسعادة، وهذا النمط يولّد لدى الأفراد شعورًا بالنقص وعدم الكفاية، ما يدفعهم لتعويض هذا الشعور من خلال الشراء العاطفي، والذي غالبًا لا يستند إلى الحاجة بقدر ما هو محاولة لبناء صورة ذاتية مقبولة اجتماعيًّا.
لا يقتصر التأثير على الفرد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسرة ككل، فقد أصبحت الكثير من الأسر تُواجه ضغوطًا متزايدة من الأبناء نتيجة تعرّضهم المتواصل للمحتوى الإعلاني والمقارنات الاجتماعية المستمرة.
هذا التعرّض يعيد تشكيل أولويات الأسرة المالية، ويؤثر على نمط توزيع الموارد داخلها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتحوّل النفقات نحو منتجات ذات طابع استعراضي كالأزياء، والأدوات التقنية، ومستحضرات التجميل، على حساب احتياجات أساسية تتعلق بالتعليم أو الصحة أو الادخار، وهذه التغييرات تُضعف البنية المالية للأسرة، وتُعرّضها لما يُعرف بالإرهاق المادي، وهو الإنفاق المتكرر وغير المستدام الذي يتجاوز حدود الدخل المتاح.
تؤكد الأدبيات الاقتصادية أن مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الخوارزميات الذكية، تُعيد برمجة أنماط الاستهلاك بطريقة دقيقة، إذ تُقدّم للمستخدمين إعلانات مصممة خصيصًا بناءً على تفضيلاتهم وسلوكياتهم السابقة، وهذا ما يفسّر القدرة العالية لهذه الإعلانات على التأثير ودفع المستهلكين نحو قرارات غير مدروسة.
المؤثرون، بدورهم، يمارسون تأثيرًا مضاعفًا، إذ يجمعون بين الألفة والثقة التي يُكنّها المتابعون لهم، وبين القدرة على إيجاد ارتباط عاطفي مع المنتج، وهذا الأسلوب يُضعف من قدرة المستهلك على التقييم النقدي، ويجعله أكثر استعدادًا للانقياد وراء التوصيات دون فحص أو تحليل منطقي.
ولمعالجة هذا الانجراف الاستهلاكي المتسارع، تظهر الحاجة المُلحّة إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد والأسر.
وهناك جانب مهم آخر في التصدي لهذه الظاهرة يتمثل في نشر ثقافة استهلاكية واعية، تُعلّم الأفراد التمييز بين الحاجات والرغبات، وتُرسّخ لديهم مفهوم القيمة طويلة الأجل على حساب الإشباع الفوري.
فالكثير من المنتجات والخدمات التي يُروّج لها عبر الإنترنت تُقدَّم على أنها مفتاح للسعادة أو وسيلة لبلوغ مكانة اجتماعية معينة، ما يدفع المستهلكين نحو الشراء العاطفي.
إعادة تشكيل هذا السلوك يتطلب تثقيفًا منهجيًّا يُعزّز قدرة الفرد على التأني، والتفكر، وتحليل الخيارات الشرائية قبل اتخاذ القرار، وهذا النوع من الثقافة يُمكّن المستهلك من التفاعل النقدي مع الرسائل التسويقية، ويجعله أكثر إدراكًا لتأثير الدعاية على قراراته.
في السياق نفسه، لا بد من تحميل المؤثرين والعلامات التجارية جزءًا من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، خصوصًا أن نجاحهم الاقتصادي يرتبط بشكل مباشر بثقة الجمهور.
ينبغي على المؤثرين أن يلتزموا بمعايير أخلاقية في الترويج، تشمل الشفافية، وعدم المبالغة، وتقديم نصائح استهلاكية تُراعي تنوع الجمهور وظروفه الاقتصادية.
ولا يمكن في هذا الصدد إغفال أهمية التكاتف المؤسسي والتعاون بين الجهات التعليمية، والتنظيمية، والإعلامية، والاقتصادية من أجل إيجاد بيئة رقمية أكثر وعيًّا وتوازنًا.
فالحلول لا تكمن فقط في لوم المستخدم أو المستهلك، بل في بناء منظومة متكاملة تُعزز التفكير النقدي، وتحد من الإفراط الاستهلاكي، وتعيد الاعتبار للقيمة الاقتصادية الحقيقية للمال والمنتج.
في الختام، يُمكن القول إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الاستهلاكي بات ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تتشابك فيها العوامل النفسية والاجتماعية والتقنية، لذا فإن التعامل مع هذه الظاهرة يجب ألا يقتصر على حملات توعوية موسمية، بل يجب أن يكون جزءًا من رؤية تنموية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي مستقر ومتين من الناحية الاقتصادية والقيمية.