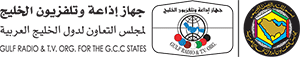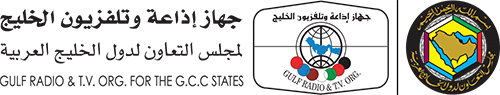تحول النقاش حول العنف في التلفزيون إلى موضوع جدالي بامتياز، فلم يستقطب السلطات العمومية وملاك القنوات التلفزيونية ومنتجي المادة (السمعية/ البصرية)، والجمهور العريض فحسب، بل حتّى الباحثين، الذين من المفترض أن يتفقوا على قاسم مشترك يجمعهم، وهذا أضعف الإيمان، انقسموا إلى فسطاطين: فسطاط يُحمّل وسائل الإعلام والتلفزيون مسؤولية استشراء العنف في المجتمع، وفسطاط آخر، يبرئ ساحتها.
فعن الفسطاط الثاني، يؤكد عالم الاجتماع الفرنسي، أريك ميغري، عدم وجود أي علاقة إحصائية دالة بين وسائل الإعلام والعنف الذي يستشري في المجتمع، وحجته في ذلك أن اليابان، بلد ألعاب الفيديو القتالية وأفلام الكارتون المعروفة باسم مانغانس (Mangas) التي تنتقد بشدّة لطابعها العنيف، تسجل أقل عدد من حالات الاغتصاب والقتل في العالم، بينما تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الجرائم على الرغم من الرقابة المشدّدة على برامج قنواتها التلفزيونية، ففي الغالب لا يبثّ أي برنامج تلفزيوني عنيف موجه للأطفال.
الطريق المسدود
يرد وليام جيمس بوتر، رئيس تحرير جريدة البث الإذاعي والباحث الأساسي في مشروع دراسة العنف في التلفزيون الوطني، على هذه الحجة التي يتداولها الكثيرون بالقول: “هل من المصادفة أن يبلغ المجتمع الأمريكي الدرجة العالية من العنف التي نعرفها في الوقت الذي تعرض فيه وسائل إعلامه – خاصة التلفزيون – شخصيات جذابة تستخدم القوة البدنية لحل مشاكلها؟!
على الرغم من تزايد المؤمنين بالوجود الفعلي لهذه الصدفة، التي لا تخضع لأي تحليل عقلاني، إلا أنها لم تثن الجهود الرامية إلى البحث عن العلاقة الكامنة بين المضامين التي يبثها التلفزيون والعنف السائد في الحياة اليومية”.
بالفعل، منذ خمسينيات القرن الماضي، واستطلاعات الرأي العام توجه أصابع الاتهام إلى وسائل الإعلام وتحمّلها مسؤولية تزايد الجرائم والاعتداءات في المجتمع، وتطالب بالتقليل من مشاهد العنف في القنوات التلفزيونية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتردّد الدراسات المختلفة عن عنف وسائل الإعلام عن “لوك” الحجج المتعارضة، وتقديم النتائج المتباينة، بل حتّى المتناقضة، الأمر الذي دعا عالم الاجتماع الفرنسي المذكور أعلاه إلى التعليق عليها بالقول: “لقد أضحت دراسة أثر عنف وسائل الإعلام على سلوك الجمهور استثمارًا ذا عائد مرتفع بالنسبة إلى العديد من الباحثين، فحيت بإنتاج متواصل من المقالات والكتب ومتزايد، ممّا يفسر الطلب الاجتماعيّ والمؤسساتي الكبير عليها من لدن الهيئات المختلفة: الأسر، والدولة، والعدالة، والسلطات المكلفة بمراقبة وسائل الإعلام، وغيرها، لكن هذا الكم من المقالات والكتب لم يفض إلى أي نتيجة علمية كبرى، هذا إذا استثنينا تلك التي تعترف بعدم وجود نتيجة، وهذا شرط لديمومة البحث حول الموضوع”.
يمكن للقارئ الكريم أن يتساءل: لماذا وصلت الدراسات عن العنف ووسائل الإعلام إلى هذا الوضع، الذي يمكن وصفه بالطريق المسدود؛ وأين الخلل؟
السبب فيما يبدو أن الكثير من نتائج الدراسات استندت إلى أحكام مكتسبة تعبر عن نظرة أصحابها إلى الموضوع، وغني عن القول إن هذه الأحكام بنيت على معلومات خاطئة أو مبتورة، لذا يدعو “وليام جيمس بوتر” إلى ضرورة التشكيك في الاقتناعات الراسخة عن الموضوع، والابتعاد عن الطرائق المألوفة والمعتادة التي أطرت التفكير في “عنف التلفزيون”، في كتابه المعنون بــ”إحدى عشرة أسطورة عن العنف والميديا”، الصادر في 2003م.
يمكن استبدال الوهم أو المسلمة بالأسطورة من باب تيسير الفهم، وتقريبه إلى الذهن، خاصة في ظل الخلط بين معطيين مختلفين في فهم موضوع العنف التلفزيوني.
المعطى الأول، يتمثل في مظاهر العنف التي تتخذ أشكالًا متجلية في الشاشة الصغيرة، حتى وإن حدث اختلاف في تحديدها.
والمعطى الثاني يكمن في تأثير هذا العنف على الجمهور؛ أي كيف يفهم الجمهور هذا العنف، ويؤوله؟.
إن الفرز بين المعطيين لا يحسم الخلاف في موضوع العنف التلفزيوني، وإن كان يوجه النقاش، والسبب في ذلك يعود إلى اعتقاد الباحث المذكور إلى وجود أربع ثقافات تنظر، بشكل مختلف، إلى هذا الموضوع، وهي: ثقافة المنتجين “كتاب السيناريو، مخرجين، مديري التصوير، معدي شبكة البرامج التلفزيونية، وغيرهم”، الذين ينتجون أو يشاركون في إنتاج المواد الدرامية، وحتّى البرامج الرياضيّة والإخبار التلفزيونية التي أصبحت بدورها تتسم بدرجة من العنف أحيانًا، وثقافة الجمهور الذي يشكو من عنف البرامج التلفزيونية وبالمقابل يخصص المال والوقت لمتابعتها! وثقافة الباحثين الذين ينتجون معارف عن أشكال العنف في وسائل الإعلام، ويكشفون عن الطرائق التي تعرض على الجمهور، وثقافة أصحاب القرار الذين يسعون إلى إحداث التوازن بين نقد الجمهور وحق المنتجين والمخرجين في ممارسة الفن.
ويسجل الباحث وليام ليام جيمس انغلاق كل مجموعة من هذه المجموعات الأربع على ثقافتها، واكتفاءها بما تعتقد أنه صائب عن العنف في التلفزيون، فتشحذ خطابها بأدلة تخدم وجهة نظرها دون أن تلتفت إلى حجج أصحاب الثقافات الأخرى، وبهذا تجانب هذه الأدلة الصواب في الغالب لاستنادها إلى بيانات ومعلومات تفندها الملاحظة العلمية قبل المحص والتحري الميداني.
سنكتفي بعرض الأوهام التي تكتسي الطابع العام، أي تلك السائدة في العديد من المجتمعات، ونتجنب تلك التي ولدت في بيئة مخصوصة، مثل بيئة الولايات المتحدة الأمريكية، وترتبط بجانبها التشريعي، ونوجزها فيما يلي:
1- الطرف الثالث:
يقول البعض إن عنف وسائل الإعلام، والتلفزيون تحديدًا لا يؤثر عليّ، بل على الآخرين الذين يعتبرونهم أكثر عرضة لمخاطرها، هذا ما يؤكده أكبر عدد من المشاهدين الذين شملتهم استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية في فترات مختلفة، إذ بلغت نسبتهم (88%)، ويعود هذا الاعتقاد إلى نظرية في علوم الإعلام والاتصال تسمى نظرية “التأثير على الطرف الثالث”، والتي تعبر عن الإفراط في تقدير الذات والوثوق في مناعتها ضد التأثر بمضامين وسائل الإعلام، وبالمقابل المبالغة في تأثيرها القوي على الغير مع عدم تشخيص هذا الغير اجتماعيًّا وثقافيًّا.
ومعنى هذا الاعتقاد عمليَّا أن العنف الذي تتضمنه برامج التلفزيون لا يشمل الجميع، بل يمس الطرف الثالث، أي عدد قليل فقط.
إذًا كل حديث عن تأثير العنف في التلفزيون يتسم بالنسبية، ويتطلب الحذر من تعميمه على الجميع؛ أي على كل أفراد المجتمع، لكن هل يستطيع الشخص الذي يبالغ في قدراته الدفاعية ضد الـتأثير الإعلامي أن يميّز بين التأثير الفوري والتراكمي الذي لا يظهر إلا على المدى الطويل؟ هذا علاوة عما أشار إليه بعض علماء النفس في حديثهم عن ظاهرة العنف، فمن أدمن على مشاهدة أفلام العنف، يفقد تدريجيًّا إحساسه بالعنف لاعتياده عليه، والأدهى أنه يعتبره سلوكًا طبيعيًّا مع مرور الوقت.
2- من المسؤول؟
وسائل الإعلام ليست مسؤولة عن التأثير السلبي لمضامين برامجها العنيفة، فهناك فرق بين المسؤولية والتأثير، حيث توجد العديد من العوامل المتفاعلة في مسار التأثير على السلوك على المدى الطويل وليس الآني، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، في سياق لا يمكن تجاهل ثقله في عملية تلقي المواد الدرامية، هذا ما يتضح أكثر من خلال المثال التالي: يقول أحد الصحافيين اللبنانيين إنه دخل قاعة السينما بلندن لمشاهدة فيلم “البرتقالة الميكانيكية” للمخرج “ستانلي كوبريك”، ولاحظ أن المشاهدين لم يتحملوا مشاهد العنف فغادروا القاعة تباعًا متأثرين جدًّا دون أن يكملوا مشاهدته، وشاهد الفيلم ذاته في بيروت في عز الحرب الأهلية، واندهش من تصرف المشاهدين، فلم يظهر عليهم أي تأثر، بل رآهم منسجمين مع أجواء الفيلم، لأن عنف الحرب الأهلية كان أقوى من عنف الفيلم المذكور، لذا لا بد من فهم تعقد عملية التأثير حتى يمكن التصدي للعنف في وسائل وتبعاته على مستوى الأفراد والمجتمع.
3- الأطفال أكبر الضحايا:
الأطفال أكثر عرضة للآثار السلبية لعنف وسائل الإعلام لهشاشتهم: بالفعل، إنهم كذلك، لكن المراهقين وبالغي سن الرشد يتعرضون لها أيضًا. إن استثناء الأطفال في هذه الحالة يستند إلى بعض الحجج مثل حجم الوقت الذي يخصصه الأطفال لمشاهدة التلفزيون، وصعوبة تمييزهم للواقع والخيال، وغيرها من الحجج التي تحتاج إلى مزيد من التجارب، وبالمقابل فإن بعض هذه الحجج ينطبق على البالغين – أيضًا – لأنهم ليسوا صلبين في تعاملهم مع برامج التلفزيون، مثلما يعتقد البعض، فكل الشرائح العمرية هشة، بهذا القدر أو ذاك، أمام مظاهر العنف في التلفزيون.
4- فائض العنف:
يوجد الكثير من العنف في وسائل الإعلام: توحي هذه المقولة أنها تحظى بإجماع مطلق، لكنه في حقيقة الأمر إجماع شكلي، يتبدد بمجرد تفكيكها. إن العنف في التلفزيون ليس واحد في نظر الجميع، إنّه متباين، فتعريف مشاهدي التلفزيون له يختلف عن تعريف الباحثين، فهؤلاء يستعينون، في الغالب بتحليل المضمون لتشخيص عنف البرامج التلفزيونية، لقد قاموا بجرد (17500) فعلًا عنيفًا في السنة في القنوات التلفزيونية الأمريكية، بينما لم يحص مشاهدوها سوى (300) فعلًا فقط، وهذا يعني أن معايير الجرد تختلف، فمشاهدو التلفزيون يعتمدون على الجانب الجغرافي، وعلى السياق في تحديد العنف فيستخلصوا بأن العنف أقل حضورًا في التلفزيون مقارنة بالنتائج التي يتوصل إليها الباحثون الذين قاموا بتوثيق أفعال العنف المتلفز.
5- العنف في كل مكان
العنف في وسائل الإعلام يعكس العنف السائد في المجتمع: يبدو أن هذا الاقتناع أصبح بمثابة مسلمة، خاصة في أوساط الذين يؤمنون بأن هذه الوسائل عبارة عن مرآة تعكس المجتمع، لكنها مسلمة في ثقافة واحدة: ثقافة منتجي البرامج التلفزيونية والمواد الدرامية التي تزعم ضمنيًّا بأن هناك علاقة طردية بين عدد أفعال العنف في التلفزيون ومظاهره في الحياة اليومية، بينما لا توجد أي إحصائيات تثبت هذا الزعم، فالعنف أشكال وأنواع: “السطو، القتل، الاغتصاب، السرقة، تخريب الممتلكات، الاعتداء، الضرب والتعذيب”، والإحصائيات تؤكد عدم استقرار أن أي شكل من العنف على وضع معين سواء نحو التصاعد أو التراجع، حسب السنوات والمجتمعات، وهذا لجملة من المتغيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والتنظيمية، والأمنية.
تؤكد بحوث علم الاجتماع أن الجريمة وليدة جملة من الظروف، منها: “الفقر، والبطالة، والتشرد، وغياب التربية، وسوء معاملة الأطفال، والإقصاء الاجتماعي، وسهولة الحصول على الأسلحة النارية بطريقة قانونية”، بينما تشير البحوث الإعلامية إلى عوامل مختلفة، فوسائل الإعلام تهيئ الجمهور ليعيش حالة شرطية؛ أي تقنعه بأن حلّ خلافاته مع الغير، ونيل حقوقه يشترط استعمال العضلات، وأن الرجولة وفرض الهيبة على الغير يقتضي استعمال العنف والبطش كأسلوب في الحياة، وأن الحياة المثيرة مقرونة باستعمال القوة البدنية.
6- لا سرد دون عنف:
العنف عنصر أساسي في كل مادة درامية أو مضمون تخيلي، هذه المقولة من بنات أفكار المخرجين ومنتجي الأفلام الذين يزعمون بأن العنف ضروري وإلزامي لأي سرد درامي، وتندرج ضمن حرية كاتب السيناريو والمخرج التلفزيوني أو السينمائي. تبدو هذه المقولة حقًا يريد به باطلًا، لأنها تبرر ما يعرض على الجمهور أكثر مما تفسر ما آلت إليه بعض المنتجات التلفزيونية من عنف وتفسرها، إنّها تتضمن مغالطة، فما هو أساسي في المادة الدرامية ليس العنف، بل النزاع في البناء السردي، والذي يأخذ عدة أشكال وليس الشكل العنيف فقط.
7- إنّها رغبة الجمهور:
وسائل الإعلام لا تقوم سوى بتلبية رغبات السوق، يقول الباحث وليام جيمس: “إن هذه المقولة تتضمن نصف الحقيقة، وليست الحقيقة كلّها”، بالفعل إن هذه الوسائل تابعة لمؤسسات تجارية تروم الربح، وليست جمعيات خيرية، لذا تسعى دائمًا إلى مسايرة السوق وتلبية طلب زبائنها وذوقهم، وهذا هو نصف الحقيقة، أما النصف الآخر المسكوت عنه، فيحجم عن ذكر دور وسائل الاعلام ومكانتها في صياغة طلبات الجمهور ورغباته، وبالتالي صقل ذوقه، فعلى سبيل المثال على مشاهدة الأفلام الأمريكية – “أفلام أكشن” (Action) من تعود منذ عقود لا يستسيغ، في الغالب، غيرها، ولا يرضى بالأفلام الوطنية على سبيل المثال، وإن شاهدها فيقارنها بشكل صريح أو ضمني بالأفلام الأمريكية المذكورة، فهذه الأخيرة لا تصبح مرجعه الفني والجمالي فقط، بل تتحول إلى ذائقته الفنية، وينتظر أن تنتج المواد الدرامية على منوالها.
أخيرًا، هذه بعض المسلمات فقط التي يسميها الباحث “وليام جيمس بوتر” أساطير في الكتاب المذكور أعلاه التي تتطلب المراجعة النقدية التي يقول عنها أنها تشبه عملية قشر البصل، فكل أسطورة تتكون من عدة شرائح، وبتفكيك كل شريحة للكشف عن أخطائها والخلل في منطقها تظهر شريحة أخرى.