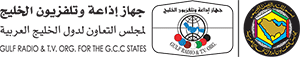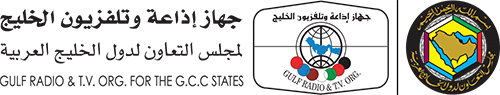يشكل موسم رمضان الكريم فترة استثنائية في حياة المسلمين، للمزايا الجليلة التي خصه بها الدين الحنيف، مما جعله يختلف عن بقية الشهور من حيث كونه موسماً عظيماً تكثر فيه العبادات وتتضاعف فيه الحسنات، ولأن طبيعة الصوم تملي تغيراً في برنامج الصائمين، وتؤدي إلى تقارب كبير بين أفراد المجتمع، وبخاصة الأسرة التي يصبح الاجتماع بين أفرادها في معظم أوقاته، وبخاصة على مائدة السحور أو الإفطار، عرفاً شبه متفق عليه يحرص الجميع على الالتزام به والامتثال له، وحيث أن السواد الأعظم من الأسر تلتم – بخاصة بعد المغرب – حول جهاز التلفزيون، فقد أصبحت هذه الفترة – على مدى شهر كامل – واحدة من أعلى ساعات المشاهدة التلفزيونية، ليس على مستوى العالم الإسلامي فحسب؛ بل ربما على مستوى العالم أجمع.
هذه العادة دفعت محطات التلفزيون والمؤسسات المتخصصة في صناعة برامجه، لأن تبذل قصارى جهدها وتتنافس فيما بينها لإنتاج العديد من المسلسلات بشكل عام والكوميدية على وجه الخصوص، أو برامج متعددة المشاهد، تتألف في غالبها من مقاطع منوعة تحكي مواقف تقدم في أشكال مختلفة، من أجل التخلص من الرتابة في العرض والتكرار، والعمل على بث الحيوية، وتعزيز حاسة الانتظار المتجددة لمواد أكثر إثارة وتشويقاً، قد لا تتحقق وفقاً لما هو مأمول، مما يندرج ضمن النظرية الشهيرة في علم الاتصال والإعلام تحت مسمى نظرية الاستخدامات والإشباعات، والتي تتشعب في جوهرها إلى إشباعات متوقعة، وأخرى متحققة.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه العلاقة بين الجمهور والتلفزيون في الشهر الكريم، لم تنشأ مع الشاشة الصغيرة ابتداءً، وإنما تمتد إلى ما قبل حلول التلفزيون وانتشاره، إذ شكلت البرامج الإذاعية نواة رئيسة في هذا الشأن، ولعلنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر قيام بعض الإذاعات الخليجية بإنتاج برامج إذاعية خاصة في الشهر الفضيل للبث في الفترة الذهبية التي تتواجد فيها النسبة الأعلى من المستمعين، ونعني بها المدة الممتدة بين صلاة المغرب وحتى أذان العشاء، ولعل من أشهر تلك المسلسلات الإذاعية في المملكة العربية السعودية، المسلسل الرمضاني الشهير “يوميات أم حديجان” الذي نال شعبية جارفة في نهاية الستينات، وبداية السبعينيات الميلادية من القرن الماضي، للممثل الشعبي الراحل عبد العزيز الهزاع، ومثله مسلسل “سعيد في شهر الصوم” للمثل الراحل “سعد التمامي”، ويعد هذان الفنانان رحمهما الله من رواد الإنتاج الإذاعي في الخليج العربي، ليس لأنهما كانا يعدان نصوص مسلسليهما فقط، بل قاما وبإتقان مذهل في التقمص بأداء جميع أدوار الشخصيات، بأسلوب ريادي استحوذ بصورة غير مسبوقة على ذائقة المستمعين وعلى حديث أفراد المجتمع آنذاك، ليصبح البرنامجان – بشهادة كاتب هذه السطور- جزءً فريداً من برنامجهم الاجتماعي.
محطات بارزة في الإنتاج الخليجي:
اعتمدت انطلاقة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الخليجي في معظمها على جهود ذاتية محدودة لأفراد دفعتهم هواية التمثيل إلى تقديم أنفسهم عبر الإمكانات المتاحة، وبخاصة من خلال المسرح الذي يعد أول منصة جماهيرية، للتعريف بقدراتهم في الأداء وتقمص الشخصيات إلى الجمهور، وكان مما شجع أولئك الهواة على تطوير ذواتهم، تقدير بعض الشخصيات الرسمية – بخلاف العرف الاجتماعي -، لجهودهم، وإعجابهم بما يقدمونه من عطاء ذا رسالة سامية وأهداف توعوية قيمة ومؤثرة.
ومع نمو جماهيرية هذا النوع من الفنون، أدركت الجهات المسؤولة عن الإعلام أهمية تقديم الدعم اللازم لأفراده والاهتمام بهم بوصفهم أدوات محركة لعناصر ثقافة الدول ووسائل إبرازها، فكانت دولة الكويت ممن اهتم بهذا الجانب منذ وقت مبكر، وعنيت به، وتجلى ذلك من خلال رعاية الفنانين المسرحيين المحليين الذين سجلوا حضوراً لافتاً، وشكل التفاعل المجتمعي معه قيمة مضافة، أكدت على ضرورة الوقوف بجانبهم، خاصة مع حاجة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لمواد محلية قادرة على منافسة ما يتم استيراده من الخارج.

هذا الإدراك قاد فيما بعد، إلى اتخاذ خطوتين مهمتين أثبتتا عمقهما الاستراتيجي في تعزيز وتطوير الحركة الفنية في الكويت، وامتد أثرهما إلى بقية دول الخليج، أولاهما: استقطاب بعض أصحاب الخبرة الفنية العريقة للإشراف على النشاط الفني في الأداء، وفي مقدمتهم مؤسس معهد الفنون المسرحية في مصر، المؤلف والمخرج المسرحي الكبير زكي طليمات، الذي تمركزت مهمته الرئيسة في إنشاء فرقة للتمثيل العربي في عام 1961.
كان مما يسر مهمة طليمات أن تكوين تلك الفرقة لم يكن البداية الفعلية للمسرح في الكويت، وإنما سبقتها بسنوات غير قليلة جهود ملموسة عبر النشاط المسرحي المدرسي الذي عرفته البلاد منذ عام 1924، وحققت فيه نجاحات لافتة، حتى أنه كان يحظى بحضور العديد من الشخصيات القيادية لفعاليته.
ليس هذا فحسب؛ بل إن الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر رحمه الله كان أحد الطلبة الذين شاركوا في إحدى مسرحيات مدرسة المباركية التاريخية.
وامتداداً لهذا الاهتمام بالمسرح، تم تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية بمرسوم أميري في عام 1973 كمؤسسة تعليمية متخصصة تحتوي على قسم خاص بالتلفزيون، وتُعنَى بتدريس التمثيل والإخراج المسرحي، وكذا النقد والأدب المسرحي، بالإضافة إلى تعليم أساليب تصميم الديكور وفنونه.
كان من نتائج هذه الخطوات التطورية المهمة، أن انعكست بشكل كبير على الإنتاج التلفزيوني الكويتي وجودته، وانعكس ذلك جلياً على انتاج مجموعة من المسلسلات الكويتية الرائدة التي استطاعت أن تسجل لها مكانة رفيعة في خارطة بث المحطات الخليجية، وتمكنت الكويت من الحصول على مصدر ثري يمدها بالعديد من المواد المتنوعة والمتميزة؛ سواء في الدراما أو الكوميديا، فحققت شعبية جارفة في منطقة الخليج، بل وتجاوزت ذلك إلى سائر البلدان العربيةـ ساعد على ذلك وجود نجوم كبار أبدعوا على خشبة المسرح.

إن الحديث عن انتاج التلفزيون الكويتي لا يمكن أن يكتمل دون الإشارة إلى المسلسل الخالد “درب الزلق” من بطولة الفنانان عبد الحسين عبد الرضا رحمه الله وسعد الفرج ونخبة من الفنانين، إذ حافظ هذا المسلسل على بريقه منذ انتاجه في عام 1977، وشكل ظاهرة غير مسبوقة في الإنتاج التلفزيوني الخليجي، فنال إعجاب الجمهور وشهادة المتخصصين، بما في ذلك كبار الفنانين العرب، ولم يكن استحواذه في نظر الكثيرين على المرتبة الأولى في قائمة المسلسلات الكوميدية الخليجية، هو السمة الوحيدة التي تميز بها، بل أن جودته برهنت بما لا يدع للشك على قدرة الإنتاج الخليجي على المنافسة، كما عززت ثقة ممثلي دول الخليج العربية في أنفسهم على نحوٍ زاد من قناعة الجمهور بهم.
وكما كان درب الزلق أيقونة بارزة في سجل الإنتاج التلفزيوني الكويتي، قدمت عدد من الدول الخليجية مسلسلات ناجحة حصدت وبتفوق إعجاب الجمهور بكافة فئاتهم، وحققت حضوراً كبيراً في خارطة البرامج التلفزيونية، ولعل أبرزها المسلسل السعودي الرمضاني الشهير “طاش ما طاش”، الذي بدأ بثه في عام 1992، ونتيجة للصدى الكبير الذي حققه في سنته الأولى، فقد استمر انتاجه لمواسم عديدة لاحقة قاربت عشرين عاماً، وظل نموذجاً تحاكيه بعض المسلسلات اللاحقة، وأهم ثمار هذا العمل أنه شكل مدرسة لا يمكن تجاهلها في تخريج العديد من النجوم، الذين انخرطوا في ميدان التمثيل، سواء عبر هذا المسلسل أو غيره من المسلسلات التي استقل بها بعض خريجيها.
ولعل مما يلاحظه المتأمل كنتيجة لهذا النجاح الذي حققته تلك التجارب وما شابهها في محطات الدول الخليجية، أن أصبح هناك اهتمام بالبعد المحلي بشكل أعمق، بل إن بعض مواد الإنتاج نفسه، اتجهت نحو تركيز محتويات المسلسلات، وبخاصة السعودية، إلى قصص يفترض أنها تصور الحياة المعيشية للمجتمع في الثمانينات الميلادية وما قبلها، على نحو مسلسل العاصوف، الذي عرض في عام 2018، وتبعه مؤخراً إنتاج مسلسلات تتحدث عن واقع الحياة في بعض أحياء المدن وخاصة العاصمة الرياض، مثل “ليالي الشميسي”، و “شارع الأعشى”.
ورغم الجهود المبذولة لتسويق هذه المسلسلات، إلا أن ردود الأفعال تجاهها لم تخلو من نقد حاد لها واعتراض العديد من أفراد المجتمع على عدم تناغم مضامينها مع حقيقة الحياة التي تحاول تصويرها، وخصوصاً في الحالات التي تتناقض فيها المشاهد مع حقيقة القيم والتقاليد المجتمعية السائدة حينها، وساعد على ذلك أن معظم المعترضين هم ممن ترعرعوا في البيئة التي تصورها المسلسلات، ورغم أحقية منتجي الأعمال الفنية في صياغة النصوص مهنياً بما يجعلها أكثر إثارة وتشويقاً، إلا أن ذلك لا يمكن قبوله في المواد التي توثق حياة الأفراد في حقب زمنية معينة، بل إن هذا التشويه للحقائق إن وجد يوجب تدخل الجهات المعنية بإبراز ثقافة المجتمع والحفاظ على صورته الذهنية كما يجب.
عوامل انتشار وانحسار:
إن المتتبع لرحلة الإنتاج التلفزيوني في الخليج، لابد أن يلفت انتباهه عدد من العوامل التي أسهمت في تحقيق انتشاره، وأخرى قد تهدد ذلك، وبخاصة فيما يتصل بجودتها وقدرتها التنافسية.
ولعل من أبرز المحفز منها، هو ما تم اتخاذه بشكل رسمي بصورة مبكرة لتشجيع الانتاج البرامجي وتبادله بين دول الخليج ومحطاتها المسموعة والمرئية، أما أبرزها فهو إنشاء جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الذي تأسس في عام 1977 وشكل في مهامه ونشاطاته المتخصصة، إحدى قنوات العمل الإعلامي المشترك في مجالات التنسيق والتدريب والاستشارات والدراسات، مع تنظيم الفعاليات والمنتديات التي يتم تتوجيها دورياً بمهرجان ضخم يتم فيه تقييم الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الخليجي، وترشيح الفائز منها، مع تكريم المتفوقين فيه، في أجواء تنافسية عالية، ولا تقل في مستوى تنظيمها عن أبرز المهرجانات العالمية.

تحديات الأفكار والنصوص
يكاد يجمع المنتجون والجمهور على حد سواء بأن العامل الرئيس والمؤثر سلباً أو إيجاباً في الإنتاج التلفزيوني عموماً والخليجي على وجه الخصوص، هو مدى قدرة كاتب النص على صناعة محتوى متقن تتوافر فيه الحبكة الفنية والتسلسل المنطقي في الأفكار وجودة ترابطها بما يشكل الإيقاع المثير والجاذب، وبما يضمن شد اهتمام المشاهد وتفاعل أحاسيسه مع كافة تفاصيله، ذلك أن جودة المضمون هو مؤشر بالدرجة الأولى على احترام ذائقة المتلقي أولاً، وكسب ثقته ليس فيمن يقوم بأداء الأدوار فحسب؛ بل وحتى في القناة التي تعرضه، وقبل ذلك في مخرج العمل الفني وفريقه.
ولعل من المفارقات التي ينبغي التنبه لها أن جزئية الإعداد التي تمثل العمود الفقري للإنتاج نفسه، قلما تحظى بالعناية المطلوبة لدى جهات الإنتاج بما في ذلك بعض المشاركين في العمل الفني، الذين يفترض أن يكون حرصهم على جودته هو أهم أولوياتهم، لكونه ينعكس بقوة على تعزيز نجوميتهم أو انحسارها، ولعل مما يفسر ذلك أن منهم من قد يقع ضحية للشهرة وردود أفعال العامة تجاههم في بدايات مشوارهم، مما يرسخ خطاً الاعتقاد أن المردود المادي الأعلى يجب أن يكون من نصيبهم، بل أن هذا الأمر أدى إلى أن البعض منهم، حتى ممن لا يملك المهارة اللازمة، إلى تولي مهمة كتابة النص بنفسه، ولعل حداثة التجربة النسبية في صناعة الأفلام والمسلسلات لديهم، هي التي أوجدت هذه القناعة، وبقدر ما تمثل هذه الحالة نموذجاً للخلل الوظيفي في موازين تقييم مهام الإنتاج الفني، إلا أن تجاهل أصحابه يعد أحد أسباب الضعف الذي يعتري عدداً غير قليل من أشكال الإنتاج التلفزيوني في الخليج.
وقبل الخوض في الحديث عن الدور المحوري لكتاب النصوص، وضرورة النظر إلى إنتاجهم خليجياً على أنه القاعدة الأساسية في الحكم على ما يتم انتاجه، لابد من تسليط الضوء ابتداءً على أبرز التجارب الناجحة في ميدان صناعة البرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها الرائدة في نشأة هذا النوع من الإنتاج التلفزيوني، وذلك بغرض الإفادة في عملية تشخيص أسباب نجاح البرامج فيها، والعوامل المؤثرة في ذلك.
أما أبرز تلك التجارب المشابهة لأبرز الأشكال التي انتشرت في التلفزيونات الخليجية، فهما نوعان، الأول: المسلسلات القصيرة التي تعرف باسم “الكوميديا الموقفية” (ٍSitcoms)، أما الثاني، وإن كان أقل حضوراً من المسلسلات، فهو برامج المقاطع المنوعة التي يغلب عليها طابع العروض الكوميدية والمحاكاة الساخرة لبعض مظاهر الحياة والشخصيات المشهورة بمختلف فئاتهم، ولا يقتصر السبب في خصها بالذكر لكونها تعد البدايات الحقيقية لهذا النوع من الانتاج؛ بل إن كثيراً من البرامج التي جاءت بعدها، محلياً أو عالمياً، تعد إلى حد كبير استنساخاً لفكرتها، كما هو الشأن مع بقية أشهر البرامج الحوارية والاستقصائية وغيرها.
المسلسلات:
كانت نشأة المسلسلات الكوميدية، التي تعد إحدى أبرز أنماط البرامج الفكاهة، من خلال الإذاعة عبر شخصيات ساخرة تقمصت أدوراً متنوعة من أجل تجسيد الحالات المجتمعية عبر تناول الموضوعات الاجتماعية على نحوٍ يعكس واقع الحياة اليومية وينتقد بعض مظاهرها، وكانت عملية التمثيل تتم في الغالب إما في مكان ثابت كالمنزل أو المكتب أو المتجر أو ما شابهها، ومن ثم انتقل الأسلوب ذاته إلى شاشة التلفزيون التي وجدت في هذا النوع من البرامج مادة جاذبة، وباتت المحطات تحرص على ترديد عرض هذه المقاطع ضمن سلسلة من المشاهد التي تسمح بتطوير المزيد من المضامين والأفكار تبعاً لردود الأفعال وانطباعات المشاهدين.
وبالتالي فإنه يمكننا القول بأن جذور أشكال المسلسلات الإذاعية تعود إلى ما قبل قرن من الزمن، وتحديداً في عام 1926 من خلال برنامج سام وهنري في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وكان للنجاح الباهر الذي حققه هذا البرنامج الأثر الكبير في أن تتبنى المحطات الأخرى هذا النموذج المبتكر، مع العمل على تقديمه في أشكال متنوعة، مع الحرص على تنمية المواهب التي وجدت فرصتها من خلال بوابته على نحوٍ يشابه إلى حد يعيد إلى الذهن الأثر الذي ذكرناه آنفاً عن المسلسلات الخليجية الرائدة.
أما المسلسلات التلفزيونية، فتعود بداية بث أولاها بصورة متواضعة إلى العام 1947، إلى أن حقق المسلسل الشهير “أحب لوسي” في بداية خمسينيات القرن الماضي أعلى نسب المشاهدة مقارنة بغيره من البرامج، وهو ما أدى إلى انتعاش سوق المسلسلات المشابهة وتم تسجيل الكثير منها كعلامات تجارية خاصة، نذكر من بينها على سبيل المثال، تلك المسلسلات التي نالت أعلى تقييم سنوي في الولايات المتحدة لموسم واحد على الأقل مثل: “ذا بيفرلي هيلبيليز” و”ثري كمبانيز” و”أول إن ذا فاميلي” و”تشيرز” و”ذا كوزبي شو” و”ساينفيلد” و”فريندز”.

البرامج الكوميدية:
ويشمل هذا النوع، البرامج التي تحتوي على مشاهد ومقاطع متنوعة بصورة تعتمد على الطرفة والمواقف المضحكة، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها إحدى الشخصيات الكوميدية ذات الحضور اللافت، القادرة على التمكن من اهتمام المشاهد وضمان متابعته المستمرة، وهي البرامج التي تعتمد على المحاورة والدردشة (Talk shows) مع الضيف بأسلوب مرح (في الغالب)، مما يتم استثماره في أحيان كثيرة للتسويق غير المباشر لبعض الأفكار، أو المنتجات الثقافية كالمؤلفات، والأفلام، أو المسرحيات وغيرها، ومن أشهر رموز هذا الفن في التلفزيونات الأمريكية جاني كارسون الذي قدم برنامج “ذا تونايت شو” على مدى 30 سنة، وتحديداً من عام 1962 وحتى عام 1992، وكذلك ديفيد ليترمان الذي كان يقدم برنامج “آخر الليل” لمدة 33 سنة ابتداءً من عام 1982 إلى عام 2015، وكان برنامجيهما وغيرها من البرامج المشابهة تحظى بتقدير واهتمام كبار الشخصيات، بما في ذلك المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية من أمثال الرئيس الحالي دونالد ترامب، والرئيسان باراك أوباما، وبيل كلينتون الذي ظهر في هذا النوع من البرامج مؤدياً العزف على آلة الساكسفون مع الممثل آرسينيو هول في برنامجه الحواري (Late night)، الذي نافس فيه لفترة غير قصيرة الفنان جاي لينو أحد أشهر مقدمي هذا النوع من البرامج على قناة الـ NBC.
أما النوع الآخر من هذه الفئة من البرامج، فيقف شامخاً ودون منازع برنامج “ليلة السبت” (Saturday Night Live)، الذي يبث مباشرة من محطة الـ NBC الأمريكية في نيويورك، بوصفه أحد أقدم وأشهر هذا النوع من البرامج، إذ يعود تاريخ انطلاقته إلى عام 1975؛ ولا يزال يتقدم الصفوف بوهجه وجاذبيته الطاغية، وتتلخص فكرته في تقديم الممثلين والمشاركين فيه أسبوعياً عروضاً كوميدية وساخرة متنوعة حول بعض المواقف السياسية أو الاجتماعية المتجددة، ورغم كونه أطول البرامج التلفزيونية استمراراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت شهرته الدولية، إلى تطوير نسخ محلية منه في العديد من دول العالم، إلا أنه حافظ على مكانته، ولم يكتف بذلك، بل استطاع بصورة ملحوظة من زيادة معدلات المتابعة، وتمكن من اقتطاعه المستمر لحجم كبير من شرائح المشاهدين، وهو ما يؤكد على دقة العناية بكافة عناصر نجاحه وتفوقه في ميدان التنافس التلفزيوني الضخم.
ورغم التحدي الكبير الذي يواجه البرنامج في عملية الإبقاء على وتيرة نجاح تصاعدية مستمرة، إلا أن فريق الإعداد استطاع بمهنتيه العالية أن ينأى به عبر خطواته التطويرية، عن الانزلاق في مأزق “التهريج” الذي يعد تفاديه مؤشراً قوياً على وجود نظرة فاحصة وتقييم دائم لمدى مطابقته لشروط جودة المادة تضمن من خلاله احترامه للمتلقين، وهو ما جعله مُدرجًا بصورة مستمرة في قائمة أفضل البرامج الأسبوعية المنافسة في الانتشار، على نحو أفضى إلى حصوله على العديد من أهم الجوائز العالمية والترشيحات القوية من الإعلام والنقاد، من بينها استحواذه على أكثر من 50 أيمي برايم تايم المرموقة، بل إنه كان أكثر برنامج رشح لنيل هذه الجائزة على الإطلاق، وتمكن كذلك من نيل تقدير نقابة الكتاب الأمريكية بحصوله على 3 من جوائزها القيمة، وصنف لأكثر من مرة باقتدار في قائمة أفضل البرامج في تاريخ التلفزيون.

معادلة الأداء والنص:
يميل البعض بصورة عامة إلى الحكم على جودة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني؛ وكذلك السينمائي، من خلال أسماء القائمين على أداء أدوار المنتج، متناسين قيمة مهمة لعناصر أخرى لا تقل أهمية عن المؤدين، ونعني بذلك الإخراج والإشراف الفني، وكذلك كتابة النص التي تشكل المحور الرئيس للإنتاج نفسه، وهي مهمة قد يتجاهلها البعض بما في ذلك المؤدون أنفسهم، وربما المخرجون على حد سواء، بل إن بعضهم لا يتوانى أحياناً عن القيام بمهمة كتابة النصوص بأنفسهم.
ونحن إذا قبلنا احتمالية أن يكون أولئك البعض ممن يملكون المهارات اللازمة في هذا الشأن، بدليل النجاح الذي حققه البعض في تجارب محدودة، إلا أن ذلك لا يعني التسليم دائماً بهذه النجاحات على أنها قواعد ثابتة، ويؤكد ذلك توقف أولئك الذين يدركون أهمية النص الجيد لفترة طويلة عن الظهور، وربما التوقف تماماً بحجة غياب النص الجيد.
السؤال الذي يستحق أن يطرح هنا، هو ما أسباب هذه المعضلة؟ ثم هل هناك بالفعل عجز في الأفكار؟ وهل يوجد إحجام من الكتاب عن العطاء الذي يرقى إلى مستوى الطموحات؟.
الواقع يقول إن هناك إشكالية جلية في هذا الجانب ملخصها غياب المتخصصين، وربما تغييب لهم بسبب قيام البعض خاصة المؤدين وربما المخرجين، اجتهاداً، في الاستئثار بمهمة الإعداد لأسباب عديدة يطول شرحها، في مقدمتها عدم تقدير دور كتاب النصوص معنوياً ومادياً على وجه الخصوص، بالرغم من أن التفوق فيها مرتبط بشكل وثيق بالأفكار والقدرة على تقديمها بالشكل المناسب للإنتاج، إذ إن المعاني – كما قال الجاحظ – “مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، البدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ “.
إن إلقاء نظرة سريعة على كيفية معاملة الكتاب في التجارب العالمية الناجحة التي عرضنا لبعضها آنفاً يبرهن على أن الكتاب في التجارب الأخرى بما في ذلك الخليجية لا يتم تحفيزهم بالدرجة التي يستحقونها.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، استطاع بعض كتاب السيناريوهات في مدينة صناعة السينما الأمريكية “هوليوود” تكوين ثروات طائلة لا تقل عما حققها أبرز نجومها على الشاشة الصغيرة والكبيرة، فقد كون السيناريست “تشاك لوري” ثروة مذهلة بلغت 600 مليون دولار نتيجة امتهانه لصنعة الكتابة في هذا المجال، كما تمكن أحد عمالقة كتابة السيناريو ويدعى “سيث مكافالرلين” من جمع صافي ثروة قدرها 300 مليون دولار.
أخيراً، إن كان من استنتاج يمكن قوله في ظل نماذج هذه الدخل العالي لبعض كتاب النصوص، فهو أن هذا المجال يجب أن يُنظر إليه على أنه صنعة مستقلة تحتاج إلى اهتمام بالغ، يبدأ من اكتشاف الموهوبين، وتقدير عطاءاتهم، وتحفيزهم ليقوموا بتحويل القصص الحياتية وصياغاتهم الفنية للنصوص وفقاً للرؤية المتبادلة بينهم وبين المخرجين والمؤدين، والقائمة على ضرورة فهم كل منهم لمتطلبات الآخر بالشكل الذي يقود إلى منتج إبداعي أصيل، متكامل في كافة جزئياته ومكوناته.