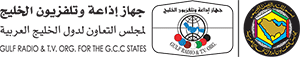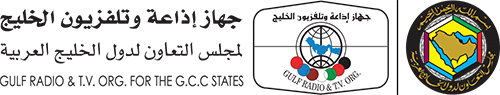لا يختلف أحد على أن الإعلام الجديد بكافة منصاته الاجتماعية، مثل: “الفيسبوك، وتويتر، والانستغرام” ووفرة الهواتف الذكية وتشعب تطبيقاتها، إلى جانب كسر التعامل الروتيني للإعلام التقليدي مع القضايا، أسهم بشكل كبير في سرعة نقل الخبر والحدث في وقته من دون تدخل مقص الرقيب، وأصبح إعلامـًا مؤثرًا لاعتماده في معظم الحالات على التوثيق بالصوت والصورة، مما ساعد على كشف الغطاء عن الممارسات السلبية المتفشية في المجتمع.
لكن علاقة نمو طردية تلازمت بين الإعلام الجديد وظاهرة “التهييج والنقد الاجتماعي”، وغدت تلك الظاهرة من أكثر ما يهدد السـّلم والأمن المجتمعي، لا سيما وأنها ترتبط بصعود تأثير “نجوم التواصل الاجتماعي” ممن يفتقد بعضهم لحسِّ المسؤولية ويسحق كل منابت الاستقرار في سبيل استمرار فيضان التكسّبات، سواء كانت شخصية أم جماعية.
ولا شك في أن ظاهرة “التهييج الاجتماعي” تقوم على الاستفزاز العاطفي والانفعالي لدى أبناء المجتمع، وإثارة القضايا المصيرية من أجل شيطنة المجتمع وإحداث الصدمة والهلع فيه، وتصدير صورة سيئة مبالغ فيها عنه، وقياسـًا على ذلك نلاحظ بين الفينة والأخرى إيجاد الشائعات وبثـّها من دون الاكتراث بالنتائج المترتبة على ذلك، وبروز قضايا من دون سابق إنذار تتحول فجأة وبسرعة لمثار جدل وشدِّ وجذب بين مكونات المجتمع، وتنادي فقط بمعاقبة المتورطين في تلك القضايا المثارة من دون التمهل في البحث عن جذورها وأسبابها وحيثياتها، مثل إثارة قضايا انتشار المخدرات داخل أسوار بعض المدارس، والمطالبة بتغليظ وتوقيع أقصى العقوبات على القائمين على المؤسسة التربوية والتعليمية الذين سمحوا بدخول تلك المواد المدمرة للمدرسة، متغافلين عمدًا عن دور أولياء الأمور والطلبة، وأساس انحراف المجرمين والمروجين للمخدرات.
إن مناقشة القضايا المجتمعية في المنابر الإعلامية ليست ممنوعة أو مرفوضة، لكن يجب أن يلازمها حسّ المسؤولية والحرص على عدم تضخيمها وإخراجها عن سياقها الطبيعي، فإثارة المشكلات والأزمات لأجل تأليب مكونات المجتمع، والتأثير في تماسكه وأمنه وسمعته في الداخل قبل الخارج، أمر مرفوض وتعاقب عليه التشريعات والقوانين الرادعة للقذف والتشهير.
هذا الردع لا يُفسر على أنه تكميم للأفواه أو تقليص لهوامش حرية الرأي والتعبير والانتقاد التي تنصُّ عليها الدساتير والتشريعات أيضـًا، بل يهدف إلى ضبط إيقاع التناول لأي مشكلة وقضية مختلقة عمدًا أو موجودة أساسـًا وتستدعي البحث والتحري عنها من قبل مؤسسات رسمية وجهات ذات علاقة واختصاص.
إن نجوم الإعلام الاجتماعي، وعلى الرغم من امتلاكهم لأعداد المتابعين الضخمة والحظوة الاجتماعية وسلطة المال والشهرة، لا يمنحهم ذلك الحق في أن يلبسوا قبعة القاضي والجلاد في آن واحد، فلكل ذي اختصاص اختصاصه، ولا يُقصد من ذلك تحجيم دورهم أو طمس حظوتهم، بل إن عدم استثنائهم من القانون يضعهم على سكة الصواب ويجنبهم الخوض في قضايا وأمور تبقى متابعتها ومعالجتها من صميم عمل واختصاص جهات أخرى.
فما هو مؤكد أن النقد يعمل كجرس إنذار ووقاية من مخاطر محدقة، وينبغي ألا يرن هذا الجرس إلا في وجود الحالات الضرورية؛ حتى لا يعتاد الناس سماعه، وبالتالي يُحدث أثرًا عكسيـًّا وتتفشى ظاهرة أخرى لا تقل سلبية هي “إدمان النقد”، والتي يتبلد فيها حسُّ المجتمع بكامله ولا يحرك ساكنــًا! وهذه نتيجة متوقعة للنقد المتطرف وغير الموضوعي، وذلك عندما يمارس النقد لمجرد النقد نفسه أو كنوع من التنفيس والتهكم والسخرية، وبالتالي لا يمكن تجاوزها بسهولة كونها ترتبط بالضمير أو الوعي الجمعي، لذا لا بد من إعلاء أهمية التفكير الناقد والنقد البناء في تنمية المجتمع وتطويره، وفي تقويم الانحرافات والممارسات الإدارية والسلوكية الخاطئة، فهو الطريق الأمثل لتجاوز إدمان النقد.
إن مجتمعاتنا التي بناها أجدادنا وقادتنا المؤسسين لهي أمانة في أعناقنا نتوارثها جيلاً بعد جيل، وواجبنا صونها وإعلاء سمعتها وكشف اللثام عن كل مـَن يترصد إليها بالإساءة خلف ستار منصات التواصل الاجتماعي، فكلنا مسؤولون عن استقرار مجتمعاتنا، ولكن كل في مجاله واختصاصه، على أن يبقى الإعلام أداة نستخدمها لإعلاء كلمة الحق والحكمة والإخاء من دون خلل أو تفريط بأي ركن من أركان المجتمع والنيل منه.