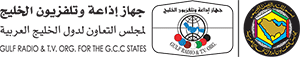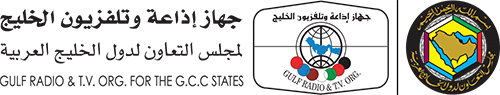ليس غريباً أن يشهد حقل الإعلام تطوراً متنامياً في وسائله وأشكاله؛ بل إن الأصل هو حدوث ذلك، لأهميته البالغة في تعزيز أداءه لمهامه وإيصال رسائله، وكذلك رسائل مستخدميه الذين وجدوا فيه خير وسيط للتواصل مع جماهيرهم المستهدفة، ومع الرأي العام عموماً. وهذا التطور سمة درج عليه منذ بداياته، فقد ظهر ذلك جلياً ابتداءً من السنين الأولى لاختراع المطبعة التي تلاها، بالإضافة إلى الصحافة الحديثة، ابتكار عدد من الوسائل شملت السينما ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون، وأجهزة التسجيل، والفيديو، وغيرها.
والمتأمل لطبيعة تلك الوسائل أنها كانت على مدى ثلاثة قرون تقريباً تحلق في فضاء ذا خصلة واحدة تشترك فيها من حيث كونها ذات اتجاه آحادي في النشر، بمعنى أنها لم تكن تتيح كما يجب للجمهور أحقية التفاعل مع ما توجهه لهم. أما التفاوت بين الوسائل فتلخص في مزايا خاصة تمثل قيماً مضافة على بعضها البعض، فالصحافة كانت نموذجاً للمطبوع المتفرد، والإذاعة للمسموع، والتلفاز للصورة المتحركة، فكان الاعتقاد بأن كل قادم سيقضي على سابقه غير دقيق، وأكدته الحقائق؛ بل إن تلك الوسائل كانت تكاملية في أدوارها، تستفيد من بعضها البعض لتعزيز مهامها، بما يمكنها جميعاً من تحقيق المزيد من النمو إلى مراتب أعلى لتسجل شعبية أكبر لدى مستخدميها.
برهن تفاعل الجمهور مع كافة الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية على قوة وتماسك كل واحدة منها، واستقلاليتها بصورة عامة في كيانات خاصة بها، واتضح للباحثين والمعنيين بتخصص الإعلام، حقيقة عدم تهديدها لبعضها البعض إلى أن جاءت بداية الألفية الثالثة التي قدمت شكلاً مختلفاً في أشكال وأساليب الاتصال، عبر فضاءٍ مبتكر فاق توقعات صناعة الإعلام نفسها وكافة وسائله، إذ جاء بمواصفات جديدة أحدثت تغيرات في جميع أركانه ومكوناته، في ظاهرة صدمت وحيرت الكثيرين، تغيرات تحمل سمات موجة هائلة لطوفان مدمر اكتسح الوسائل وهدد كياناتها، فقدمت بذلك معياراً جديداً للحكم على طبيعة التطوير، ومعرفة مدى تأثيره في الأدوات القائمة؛ وهو ما أوجب على المهتمين والدارسين التعامل مع هذه التغيرات في حقل الاتصال والإعلام التمييز بين المبتكرات في ضوء طبيعته كفضاء أو محيط يبتلع الوسائل السابقة؛ ليشكلها وفقاً لخصائصه، وليس كوسيلة مستقلة؛ بل ويعرف بوسائل جديدة تجمع في أشكال موادها العديد مما كان حكراً على وسيلة واحدة في السابق.
ونقصد بالفضاء الإطار العام الذي يمتلك خصائص مختلفة تميزه عن غيره من الأطر، ويوفر من خلالها سمات فريدة ومتميزة لوسائل جديدة، كما يمكنه تطوير القديم منها في حال تمكن القائمون عليها من استيعاب طبيعة التغيير ومواكبته. وبالتالي فإن الوسائل يقصد بها الأدوات التي تنشأ داخل الفضاء نفسه بناءً على ما وفره لها من خصائص ذات قيمة مضافة كبيرة على المجال الذي كانت تعمل فيه سابقتها.
الموجة الأولى: موجة الفضاء الرقمي
والمتأمل للتغيرات الرقمية التي شهدها العالم منذ ثلاثة عقود تقريباً، يدرك أن الحقل الاتصالي قد شهد في ضوء تحولاته موجة هي الأولى من نوعها في قدرتها غير المسبوقة على إعادة تشكيل وسائل الإعلام الحديثة التي نشأت كما أسلفنا مع ابتكار المطبعة، ولكونها كذلك، ولعدم إدراك أو اهتمام الكثيرين بقصدٍ أو غير قصد بأبرز مقوماتها المتمثلة في التفاعلية والفورية، تعرضت الوسائل التقليدية لزلزال عنيف أفقدها مكانتها، وكلفها الكثير.
وعند قراءة تفاصيل المشهد، نلحظ أن هذه الموجة الأولى قدمت مزايا جديدة في الشكل والنموذج بصورة شمولية طالت جميع تفاصيل العملية الاتصالية، ساعدها في ذلك ابتكار منصة ذكية محمولة يدلف منها الأفراد ليس كمتلقين فقط للمواد المرسلة، بل وحتى كصناع محتوى جدد، فبات كثيرون منهم ممارسين لدور القائم بالاتصال، الذي كان حكراً على أفراد بعينهم يعملون تحت مظلة مؤسساتية، ويتقيدون بمعايير وضوابط وتشريعات واضحة، المفارقة أن البعض، بما في ذلك المؤسسات التشريعية والتربوية، لم تدرك كما يجيب خطورة الفضاء الجديد، وربما كان السبب في ذلك أن السواد الأعظم منها تعامل مع هذا الفضاء كوسيلة، وليس كفضاء وفقاً للتعريف الذي ذكرناه سابقاً، استناداً على ما شهده تاريخ التطور الإعلامي بمراحله وأدواته المختلفة، التي كان فضاؤها التقليدي يسمح بذلك، وبالتالي فهي لم تنظر إليه على أنه ذا خصائص شمولية تستطيع تغيير الأوضاع ثقافياً واجتماعياً والتأثير في العديد من جوانبها، وأنها تستطيع استبدال الوسائل القائمة آنذاك بما هو أجود؛ بمعنى آخر كان القياس على ما كان يحدث بين الوسائل المتجددة في الفضاء الأول “عرف فيما بعد بالفضاء التقليدي، أو الإعلام الخطي”، ليتبين فيما بعد خطأ القياس، وخطورته.
الموجة الثانية: موجة فضاء الذكاء الاصطناعي
بالرغم من أن استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي بدأ منذ نهاية الخمسينات الميلادية في القرن الماضي، إلا أن الطفرة الحقيقة لتطبيقاته، ظهرت بقوة في حقل الاتصال مع التطوير الهائل الذي حققته تقنية (تشات جي بي تي)، التي قدمتها لأول مرة شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي “أوبن إي آي” (OpenAI) عام 2018، المدعومة من شركة مايكروسوفت، من خلال روبوت أو برنامج يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، على نحو يمكنه من التحاور مع المستخدم والإجابة عن أسئلته بالتفصيل.
وبلغت ذروة الإقبال على هذه التقنية ذروتها في فبراير 2022، عندما تم تطويرها؛ لتصبح قادرة على الإجابة عن الأسئلة الصعبة بدقة عالية، وعلى مساعدة مستخدميها في توفير احتياجاتهم المتنوعة بما في ذلك صياغة وإعداد المقالات وتقديم أفكار إبداعية في الرسم والتصميم والإنتاج الإعلامي، ولتميزه في هذا الجانب في خدمة التخصصات المختلفة، وقدرته الكبيرة في التعامل مع العديد من الاحتياجات والطلبات، يمكن القول بأن البشرية دخلت فضاءً جديداً يضاهي دخولها الفضاء الرقمي الذي بدأ مع ابتكار الإنترنت.
أما القاسم المشترك بين هذا الفضاء وسابقه أنهما محوريان في استهدافهما لجميع المجالات والتخصصات، فكما أن الاتصال الرقمي، لم يستهدف المؤسسات الأكثر استخداماً لمساحة الاتصال، ونعني بها تحديداً الإعلام، وشركات الاتصالات، أو الجهات الأمنية؛ ووسع دائرة المستفيدين منه ليشمل كافة القطاعات دون استثناء، وجميع أفراد المجتمعات، جاء فضاء الذكاء الاصطناعي ليراهن على القيام بوظائف البشر في جميع المجالات، بما في ذلك مهنة الطب وعلومه، وكذلك التعليم ومصادره، علاوة على الإعلام وفنونه.
ورغم الضجة الكبيرة الذي أثيرت حول هذا الابتكار، وتمحورت في معظمها حوله تهديده المتوقع لفرص العمل، واحتمال تهميشه التام لأدوار البشر في إدارة شؤونهم، على نحوٍ يفضي إلى القضاء على انتاجيتهم، وانتشار البطالة في العالم أجمع، إلا أن الواقع الحالي يشير في كثير من التخصصات إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمامه ليصبح المتحكم الأوحد فيها، حتى أن هناك من لا يزال يتحفظ على وصفه بالذكاء الاصطناعي، وينظر إليه وفقاً لما يقدمه من حلول أقرب إلى السذاجة منه إلى الذكاء، بل إن أحد الأطباء العاملين في مستشفى جون هوبكنز الشهير في الولايات المتحدة، شكك في قدرته على تشخيص المرضى بالشكل الدقيق، وبرر ذلك بأن هذا “الذكاء” في معظم الأحوال يعتمد في تشخيصه على بيانات غير دقيقة، ذلك أن كثيراً من المعلومات التي أدخلها في الانترنت تمت عبر أشخاص ليسوا متخصصين، وهو أمر قد يقود إلى تقديم نتائج ضارة، وربما قاتلة لمن يعتمد عليها.
أما ما يؤكد صحة الحكم على بعض مخرجات الذكاء الاصطناعي بالسذاجة، فيقرره من حاول اختباره في كتابة تقرير عن نفسه، أو أحد معارفه؛ حيث يفاجأ بتقرير يختلط فيه من حيث المعلومات الشخصية الحابل بالنابل، ومرد ذلك إلى عجز هذا الذكاء عن التمييز بين الأفراد الذين تتشابه أسماءهم، لينتهي إلى التعريف بشخصية هجينة تبعث أحياناً على السخرية والتندر لدى الباحث عنها.
ومهما يكن من أمر، فإن مرد ذلك يعود إلى حقيقة أن فضاء الذكاء الاصطناعي وأدواته لا يزال في بداياته، وبالتالي فإن أوجه القصور تلك ينبغي ألا تقلل من قدراته، ولا أن يتجاهل المتخصصون، بما في ذلك خبراء الإعلام والاتصال النتائج المتوقعة لمستقبله؛ بل يجب عليهم التعرف عن كثب وبصورة مبكرة جداً على واقعه وأدائه وإمكاناته في مجالهم، مع متابعة مستمرة لتطوراته، وكذا البحث في آليات الاستفادة منه وتوظيفه في صناعة الإعلام، وتحديد الجوانب التي لا يمكن أن يؤديها دون تدخل بشري، بحيث يكون التكامل هو السبيل إلى انتاج إعلامي فائق الجودة.
دروس وعبر:
في الوقت الذي اكتسبت فيه جميع التخصصات والمجالات فوائد جمة في موجة التغيير الأولى، التي بدأت مع حلول الفضاء الأول “الإنترنت”، كان تخصص الإعلام هو الأكثر خسارة لمقوماته وأدواته التي تفرد بها على مدى عقود طويلة قبل التحول الرقمي، وظهرت بوادر تلك الخسارة في التراجع الهائل في درجة الاعتماد عليه كوسيط أساسي للوصول إلى السواد الأعظم من الجمهور، وفي كونه أداة مقربة لصناع القرار وقطاع الأعمال، والأفراد من أجل تشكيل الرأي العام حول احتياجاته وقضاياه، ولم يكن للكارثة أن تحدث، لو لم تنهمك مؤسسات الإعلام في جني أرباح الإعلانات والوجاهة، دون أن يخصص جزءً من تلك الوفرة المادية حينها لدراسة كيفية التعامل مع إمكانات القادم الجديد آنذاك، وتحديد درجة ارتباطها الوثيق بطبيعة نشاطه ومستوى تأثراته، والبحث بجدية وموضوعية في كيفية استثماره في صناعتهم، على نحوٍ يثبت بأن الإعلام ركن رئيس ومرجعية في الاتصال، مما أدى إلى فقدان الدور الذي عرفوا به وتميزوا فيه.
لقد وضع الذكاء الاصطناعي هذه المرة، جميع التخصصات، وليس الإعلام فقط على مفترق الطرق، وأوقعهم في حالة الإرباك والتشتت التي عاشها الإعلام ووسائله طيلة الفترة التي بدأ وتطور فيها الفضاء الرقمي، وفي الوقت الذي يمكن استفادة الجميع من تجربة الاتصال السالفة مع ذلك الفضاء، فإن موقف أصحاب الشأن منها -ونعني بهم المنتسبون إلى الإعلام مهنياً وأكاديمياً- تملي مراجعة نقاط الضعف والقوة، لتحفزهم بدرجة أعمق، وأكثر تنظيماً، للوصول في التجربة القادمة إلى أقصى درجات النجاح، ولتجنب احتمالات حدوث خسارة جديدة، قد تؤدي بالتخصص إلى ما لا تحمد عقباه.
ربما السؤال الأكثر إلحاحاً، في هذه الحالة هو: ما الدروس المستفادة من تجربة الإعلام مع فضاء الإنترنت، مما يجب التنبه لها مع التجربة القادمة مع الذكاء الاصطناعي؟
الإجابة تكمن في رصد مهام رئيسة مستنبطة من التجربة السابقة مع الموجة الأولى، وتتلخص فيما يلي:
أولاً: تقييم الواقع الإعلامي في ضوء أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات العلاقة
وتقتضي هذه المهمة القيام بمسح شامل للأدوار الإعلامية الحالية التي يمكن أن تقوم بها التطبيقات العديدة، ليس فقط لمعرفة مدى توفرها، ولكن لتقييم مستوى الجودة بها، ومكامن القصور التي تعتريها، وتحديداً المواطن التي يفترض تواجد الممارس المهني المتفوق لمعالجتها، وتنقيح مخرجاتها؛ ليضمن تكامل المنتج أو المادة الفائقة التي ينشدها جمهور الإعلام.
إن مما يدعو إلى القيام بهذه الخطوة، حقيقة مفادها أن وسائل الإعلام، ومؤسساته التعليمية، تخسر؛ بل وتضيع الكثير من الجهد والمال والوقت في محاولة توفير منتجات باتت متاحةً بأقل ثمن ويتم إنجازها في أقصر وقت، ولعلنا نضرب مثالاً في هذا الصدد بتجربة عاشها كاتب هذه السطور عند حضوره لمنتدى متخصص في مجال موضوع هذا المقال.
ففي إحدى ورش العمل التي استعرضت العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الإعلام، وتحديداً في كيفية توظيفها في تصميم الأشكال والرسوم والشعارات، إذ طلب المشاركون فيها من مقدمها اطلاعهم على تجربة تصميم شعار لوكالة متخصصة في الإنتاج الإعلامي، وبعد أن قاموا بتعبئة البيانات التي ينشدها التطبيق لتحقيق ذلك من بينها: اسم الوكالة، أهدافها، طبيعة نشاطها، وغير ذلك من المعلومات التي يفترض أن تؤخذ في الاعتبار لتقديم الشكل الأنسب، ذهلوا أنه لم يكن يفصلهم عن الحصول على مبتغاهم وأكثر سوى ضغطة زر، أسفرت بعد مرور أقل من دقيقة عن قرابة (100) شعار ذات جاذبية لافتة ودلالات عميقة.
المفاجأة الأكبر كانت أن هذه الشعارات تعتبر – حسب قول المدرب – حصرية، ولن يتكرر إنتاجها لآخرين. أما الدرس المستفاد من هذا المثال، وينسحب على كل ماله علاقة بالتصميم والجرافيك، فهو أن الوقت بات ملحاً لمراجعة آليات العمل والتعليم في التخصص، سواء في وكالات التصميم أو في معاهد وكليات وأقسم الإعلام والاتصال، بحيث تختصر المسافة لمعرفة القدرات التقنية في إنتاجه بكافة أشكاله، وهو ما يوجب في الوقت ذاته تضافر جهود المتخصصين في صناعة المحتوى، لتحديد الأدوار التي يحتاج التفرغ لها والاهتمام بها دون غيرها، ففي مثالنا السابق يجب التعامل مع سائر مخرجات التطبيق الإعلامية كمنتج أولي للتطبيق، ومن ثم قراءة هذا المنتج (الشعارات التي صممها) برؤية نقدية عميقة، وفقاً لأحاسيس البشر، وتحديد مواطن التنقيح والتعديل ومبرراتها، ذلك أن الحقيقة تقرر أن أي شعار يقع عليه الاختيار ابتداءً لن يفي تماماً بكل ما يؤمله صاحبه.
من جانب آخر، لا بد من إعادة النظر في أساليب تعليم التصميم ومفردات مقرراته، وكذلك الحال مع كافة المقررات التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وذلك بما يضمن تحقيق التكامل المنشود، وتعريف الدارسين والممارسين بأحدث ما توفره تقنياته، مع العمل على غرس ثقافة التعامل معها وتوظيفها بدقة، بما يدعمهم هم في نيل فرص عمل مستقبلية ملحة في سوق العمل، وفي تعزيز قدراتهم في التعامل مع التقنية، وعلى نحوٍ يجنبهم الحرج الذي قد يواجهه أصحاب التخصص في الحكم عليهم بجهلهم بآخر ما تم ابتكاره في ميدانهم.
إن حجم الخسارة التي ستنعكس على التخصص في حال تم تجاهل ذلك، فادح وجسيم جداً، أقله ضياع وقت ثمين لمحاولة إنجاز ما هو متوفر، ولنضرب في مثال قدرة الذكار الاصطناعي على التصميم، ما قد يحدث في كليات وأقسام الإعلام والتربية الفنية والتسويق وغيرها من خلل يسيء لصورتها، ويقلل من قيمتها، فقد يكلف أستاذ مقرر التصميم أو الإخراج الفني طلابه بابتكار ورسم شعار لجهة ما، وربما طلب تسليمه في نهاية الفصل الدراسي ضمن المهام التي قد تسند لهم، ولئن كان هذا التكليف والمدة التي تم منحها للطلبة لتسليمه مقبولة في وقت مضى؛ لحاجتهم حينه له، إلا أنها لم تعد كذلك في زمن يمكن إنجازه في خمسين ثانية فقط.
هل يعني ذلك إلغاء مثل هذا المقرر؟ أو الاستغناء عن الوكالات المتخصصة في موضوعاته؟ الجواب حتماً لا؛ ولكن الحاجة الآن، ومن أجل المواكبة، هي إلى تمكين الدارسين من السير جنباً إلى جنب مع التطور التقني الذي يشهده الحقل، ومن الإمساك برسن قيادتها للأفضل، وفهم كيفية عمل التطبيقات، وآليات تحسين مخرجاتها، وإضفاء روح اللمسة البشرية عليها.
ثانياً: ضبط قواعد معلومات الإعلام والاتصال (المادة الخام)
لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتج مواده دون وجود معلومات متوفرة، يقوم على تحليلها، وإعادة تشكيلها، والربط بين عناصرها ليقدم المخرج المقترح لطالبي مواده، ومساعدتهم. وبالتالي، فإن ضمان صحة ودقة بياناته، مرهونة بطبيعة المواد التي تتغذى بها تطبيقات هذا النوع من التقنية، ومن هذا المنطلق فإن العمل على ضبط جودة المخرجات الإعلامية لهذه التطبيقات مسؤولية المتخصصين بالدرجة الأولى، ولعل هذه المهمة هي أقل ما يمكن أن يسهموا به في صناعة الإعلام بمفهومه الجديد. وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها ضرورية لتوظيف التقنية الجديدة كأداة مساعدة، لا يمكن تجوديها دون وجود الكفاءات البشرية، وامتداداً للدور المأمول من القائمين على التخصص في التطوير.
ثالثاً: ترسيخ أخلاقيات المهنة، وحفظ الحقوق الفكرية لأصحابها
إن من أسوأ مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال والإعلام، أنه لا يراعي فيما يقوم بتصنيعه حقوق الآخرين، بالرغم من أنه يعتمد في توصله إليها على إنجازات غيره من المفكرين والمبدعين، وهو إن نجح في معظم حالاته في صهر ومزج الكثير من البيانات واستخلاص منتجاته، إلا أنها كثيراً ما تُبقي في ملامحها، وبنسب متفاوتة، شيئاً من مصادرها دون الإشارة إلى ذلك.
ليس هذا فحسب؛ بل إن الذكاء الاصطناعي قد يسيء للرموز وبخاصة الراحلين باستخدام شخصياتهم وأصواتهم في مجالات ما كانوا أنفسهم ليقبلوا بالقيام بها، لو طلب منهم ما يتم وضعهم فيه، من ذلك استخدام أصوات الفنانين لغناء كلمات أو قصائد لم يقوموا بأدائها، وربما لا ترقى حتى في اللحن للمستوى الذي كانوا يراعونه، وبرعوا في اختياراتهم للأنسب لهم.
والمتتبع للمخالفات الأخلاقية في هذا الجانب يدرك مدى الحاجة الماسة لتدخل الجهات التشريعية؛ لضبط حجم الانعكاسات الكارثية على الأفراد والمجتمعات وعلى حصيلة الإنتاج المعرفي الثقافي على مر العصور، الأمر الذي جعل الحكومات وأسياد التقنية أنفسهم يطالبون ابتداءً بتنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي، وتخفيف أخطارها على الأمن والاقتصاد، مما دعا البيت الأبيض إلى الاجتماع بمسؤولين تنفيذيين في أبرز سبع شركات انتهى بتعهدهم بوضع نظام يحدد بعلامة مائية كافة المحتويات التي يتم توليدها من خلال هذه التقنية، بالإضافة إلى حماية الخصوصية وعدم التحيز، وهذه المهام تقدم نموذجاً لما يمكن لصناعة الإعلام وتعليمه أن يعتني به.
ومما يعقد أمر مخرجات الذكاء الاصطناعي في وسائل الاتصال والإعلام أن آثارها قد تكون مدمرة على الأجيال، ويكفي أن نضرب مثلاً في هذا الشأن باكتشاف فريق الحقائق في محطة BBC عن أن بعض قنوات شبكة اليوتيوب واسعة الانتشار، تعمد إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو علمية تستهوي الملايين من الأطفال، ذات معلومات زائفة ومضللة، بغرض الحصول على أرباح مادية جراء نسبة المشاهدات والإعلانات العالية.
رابعاً: الحاجة إلى الرصد المستمر لجديد الذكاء الاصطناعي
اعتادت المؤسسات المهنية والتعليمية المتخصصة في إعلام الفضاء التقليدي، في القرن الماضي على التعامل مع تقنية اتصالية ثابتة من حيث الأشكال والأجهزة في معظم أحوالها، وكثيراً ما يستمر استخدام تلك المبتكرات أو المطور منها لفترة زمنية طويلة، الأمر الذي لم تشكل معه التغيرات المتلاحقة هاجساً كبيراً لدى العاملين في الحقل الإعلامي، وذلك بخلاف ما عليه الوضع في فضاء الإنترنت، أو فضاء الذكاء الاصطناعي، ويعد الأخير حالة متجددة تتسابق فيه الشركات العملاقة لابتكار وتقديم تطبيقات أكثر محاكاة لما يقوم به البشر، في فترات زمنية قصيرة تحيل المستجدات إلى تراث وتقضي على الكثير منه بسرعة غبر مسبوقة.
من ذلك على سبيل المثال قيام شركة مايكروسوفت بالسماح لمستخدمي (شات جي بي تي) من الوصول إلى منشئ الصور (دال أي 3)، ليتمكنوا من استحداث الصور بشكل متزامن مع الدردشة؛ بحيث تجسد أفكارهم وتخيلاتهم مباشرة، وهي بهذه النسخة الجديدة تقضي وفي فترة قصيرة جداً على نسختها السابقة التي ربما لم يتح للكثيرين أن يعرف عنها بعد.
هذا يعني أن متابعة هذه التغيرات المتلاحقة بات في صلب التحديات التي تجب مواجهتها من قبل تلك المؤسسات أولاً بأول، ولا بد أن تكون هذه المهمة في أولويات المعنيين بصناعة الإعلام وتدريسه، حتى لا تكرر أحد أبرز أخطائها الجسيمة الذي وقعت فيه مع الفضاء الرقمي، والذي أفضى إلى نتائج كارثية خاصة لمؤسسات الصحافة الورقية.
السؤال الذي يمكن نختم به، هو: هل التفاعل الحالي مع القادم الجديد كافي لمواكبته، والإفادة منه، الإجابة تلخصها دراسة حديثة قام بها أحد الباحثين في برنامج الصحافة في كلية لندن للاقتصاد، شملت (105) مؤسسة إعلامية في (46) دولة حول العالم عن انطباعات وآراء إعلامييها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أظهرت أن نظرتهم حولها لم تتغير خلال السنوات الماضية، وعزت الدراسة السبب في هذا إلى أنهم “ما زالوا مبتدئين في هذا التخصص أو أن مؤسساتهم الإعلامية لا تشتغل بأي تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي”.